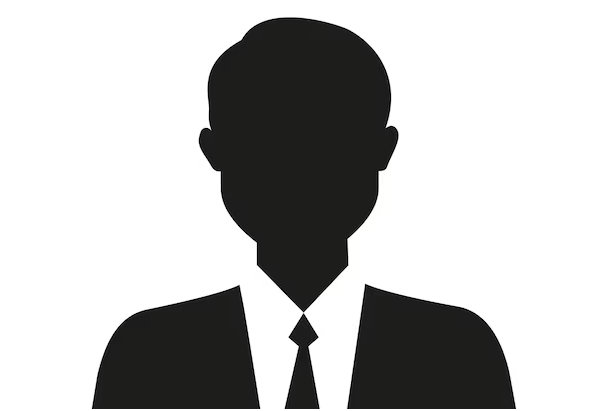قضايا
محمود الوردانيالفن والنضال.. هل لدينا أدب عمالي؟
2021.12.01
الفن والنضال.. هل لدينا أدب عمالي؟
كنتُ قد رحبّتُ باقتراح الصديق يحي وجدي بأن يدور إسهامي في هذا العدد عن الأدب العمالي. وعندما تأملتُ في العنوان قليلاً، وجدت أن العنوان نفسه ينطوي على خطأ أساسي، فليس هناك أصلاً أدب عمالي أو أدب فلاحي أو أدب برجوازي. هناك أولاً أدب. أدب أو لا أدب. وإذا كان المقصود هو الأدب الذي يكتبه العمال، فإن هناك على سبيل المثال من العمال الكاتب الراحل محمد صدقي الذي كتب في خمسينيات ومطلع ستينيات القرن الماضي عدة مجموعات قصصية تدور حول ما يسمى بالنضال العمالي: أي الإضرابات والاعتصامات ومقاومة الظلم والاضطهاد الذي تتعرض له الطبقة العاملة في مصر. هذا عامل ويكتب عن الطبقة العاملة، ويعتبره كثير من الكتاب (السوفييت في دراساتهم مثلاً) كاتب مناضل وما إلى ذلك، إلا أن قصصه رديئة للأسف، واندثرت تلك القصص التي تدافع عن قيم تختص بالعدل الاجتماعي والثورة، لا لأن القيم التي تدافع عنها خاطئة، بل لأنه ببساطة كاتب رديء. وهناك في الوقت نفسه كتاب لا ينتمون للطبقة العاملة، ولم يعملوا في مصانع وكتبوا أعمالاً باقية ولم تندثر، ومن بينهم على سبيل المثال الكاتب الراحل عباس أحمد الذي كتب في سبعينيات القرن الماضي روايته الجميلة المحكمة "البلد" عن مدينة المحلة الكبرى وأحوال ومعاناة عمال النسيج في المصانع وانتفاضتهم ضد مستغليهم. ربما كان هذ المثال فظًّا أو خشنًّا، لكنني قصدتُ أن أوضح أن الكتابة الأدبية لا تُعنى بالمنشأ أو الانتماء المباشر، وإن كان هذا لا يمنع من وجود أعمال مثل "الرحلة" لفكري الخولي، لكنها تظل عملاً استثنائيًّا نادرًا، كما سوف أوضح بعد قليل.
وفي الأدب العالمي على سبيل المثال كتب أندريه مالرو الذي لم يكن عاملاً عملين خالدين مثل "قدر الإنسان" عن نضالات عمال الصين، و"الأمل" عن نضالات اليساريين الجمهوريين في أثناء الحرب الأهلية الإسبانية ضد الفاشية، وحتى المثل الذي يحلو للكثيرين ذكره، وهو مكسيم جوركي، لأنه كتب "الأم" باعتبارها مثالاً للأدب العمالي، فإن جوركي نفسه لم يكن عاملاً، وقرأ له كاتب هذه السطور أعمالاً أخرى، روايات وقصصًا قصيرة اعتبرتها متجاوزة للأم التي تظل عملاً بسيطًا ومباشرًا ودعائيًّا.
وهكذا فإن الكُّتاب في مصر، مثل سائر الدنيا، لا يُعوَّل على نشأتهم أو انتمائهم الطبقي، ولا يُعولَّ أيضا - وهو الأهم- على طبيعة الواقع الذي يتناولونه في أعمالهم. وقد فًصّل ناقد كبير مثل إرنست فيشر هذا الأمر في كتابه "ضرورة الفن"، كما فصَّله روجيه جارودي في "واقعية بلا ضفاف"، ومن قبهم أرنولد هاوزر في سِفره الضخم" الفن والمجتمع عبر التاريخ" على سبيل المثال. وفي هذا السياق لا يمكن أن نغفل المقالات التي كتبها لينين عن تولستوي واعتبره كاتبًا عظيمًا وتناوله بتقدير واحترام بالغين، وبالطبع لم يكتب تولستوي عن العمال حرفًا واحدًا! وهكذا فإن كتابًا مثل كافكا وفنانين تشكيليين مثل بيكاسو وشعراء عديدين ينتمون للسوريالية ليسوا بعيدين عن الثورة والعدل والحرية، والكتاب الذين يعلنون انتماءاتهم المناوئة للحرية والعدل لا ينبغي أن يأخذهم الواحد مأخذ الجد، فربما فعلوا ذلك خوفًا أو للإفلات من النظم الحاكمة، وفي كل الأحوال ينبغي قراءة أعمالهم فهي الفيصل الوحيد.
والواقع أنني لا أتصور كاتبًا لا ينتصر للعدل والديموقراطية والمساواة بين البشر، أو يقف مع الظلم والظلام والقمع والتعذيب والمنع. الكاتب الذي ينفذ إلى القلب والعقل ويؤثر فيك، لا يمكن إلا أن يكون كاتبًا منتميًا لليسار بمعناه الواسع، حتى لو ادعّى غير ذلك من أجل المصالح المباشرة والإفلات من قبضة نظم الحكم المختلفة. وعلى أي حال، من البديهي أن الأفكار الماركسية التي تدافع عن مصالح الطبقة العاملة، لا تستبعد الأفكار التي تدعو للعدل والديموقراطية والمساواة، بل إن دفاعها عن مصالح الطبقة العاملة يتضمن وينطوي على انتصارها للأفكار المشار إليها، ومن ضيق الأفق الشديد والبلاهة أن يتم استبعاد أصحاب أفكار الديموقراطية والعدل بالمعاني الواسعة.
وفي بلادنا لنا الحق أن نزهو بموجات من الكتاب والفنانين الذين أثروا حياتنا بالانتصار لقيم أرى أنها في نهاية الأمر مع الحرية والعدل والثورة بأوسع المعاني. وإذا اعتبرنا أن ثورة 1919 في "إرهاصاتها وتجمعها وانطلاقها ثم همودها" على حد قول شكري عياد في كتابه "القصة القصيرة في مصر" هي نقطة البدء للنهضة الأدبية، كما يشير يحي حقي إلى أن رياح ثورة 1919 كان لها الدور الأساسي في تأسيس المدرسة الحديثة بفرسانها الكبار مثل حقي وتيمور وحسين فوزي وأحمد خيري سعيد وعيسى وشحاتة عبيد وغيرهم، وكان إنتاج هؤلاء الكتاب في القصة القصيرة على وجه الخصوص يشير إلى تيار وطني قوي ينشد الاستقلال والحرية ويعلن العصيان المدني والثورة ضد الإمبراطورية التي لا تغرب عن مستعمراتها الشمس، وبعد احتلال لمصر كان قد مضى عليه 37 عامًا، وفي الموسيقى نهض سيد درويش مبشرًا بموجة جديدة، مثلما فعل مختار في النحت، ومثلما فعل محمود سعيد في التصوير. لنا الحق إذن أن نزهو ونفخر بالبدايات التي استمرت ولم تفقد قط انتماءها للحرية والعقل والاستنارة. وفي هذا السياق يمكن النظر لإسهامات قامات كبيرة مثل طه حسين ومحمد حسين هيكل بل والعقاد في الفكر والتاريخ الإسلامي على سبيل المثال، فهم لم يعيدوا إنتاج الأسلاف، بل يمكن القول إنهم ساءلوا إنتاج السلف وشككوا فيه وأضافوا رؤى جديدة وأعادوا تفسير ذلك الإنتاج وعارضوه.
أدرك جيدًا أنني أطرح عناوين عريضة تستوجب النقاش والتمحيص، وهو ما لا مجال له في السطور التي بين يدي القارئ، لكنني أدرك جيدًا في الوقت نفسه أن تاريخ الأدب والفن والفكر في بلادنا كان على وجه الإجمال في صالح الحرية والعدل والاستنارة بأوسع المعاني، ولم يكن على سبيل المصادفة مثلاً أنه ليس لدينا أديب واحد يعتدّ به ينتمي للإخوان المسلمين، ولم يكن إنتاج سيد قطب ومن قبله محمد رشيد رضا سوى إعادة إنتاج للسلف، وأتردد كثيرًا قبل أن أسمح لنفسي أن أعتبرهما مفكرين أضافا للفكر العربي، وما أنتجاه لا ينتمي إلا للكتابات السياسية المباشرة والآنية، على الرغم من اعتماد كل منهما على القرآن. كما أنه ليس على سبيل المصادفة أيضًا ارتباط الأحداث الكبرى والانتفاضات العارمة بموجات التجديد، فقد رافقت تلك الموجات التجديدية انتفاضة 1946 ضد الاحتلال الإنجليزي والقصر وأحزاب الأقلية، وصعد نجم القصة القصيرة إلى أقصى حد على يد يوسف إدريس ومن معه. كذلك شهدت العقود التالية وحتى ستينيات القرن الماضي موجات من كتاب القصة والرواية والنقد والشعراء والمشتغلين بالثقافة ممن ينتمون إلى هذا الحد أو ذاك للأفكار اليسارية بأوسع معانيها. فعلى سبيل المثال فقط، لا يمكن اعتبار نجيب محفوظ إلا كاتبًا يساريًّا بانتمائه العريق لأفكار حزب الوفد وانتصاره للديموقراطية، وتوفيق الحكيم الذي كان تحقيق العدل أحد همومه الأساسية حتى لو كان العادل مستبدًا. هذا فضلاً عن أسماء وقامات شاهقة مثل عبد الرحمن الخميسى وعبد الرحمن الشرقاوي ولطيفة الزيات ونوال السعداوي وأحمد عبد المعطي حجازي وصلاح عبد الصبور وفؤاد حداد وصلاح جاهين وأحمد فؤاد نجم والأبنودي وسيد حجاب، ثم الموجات التالية مثل نجيب شهاب الدين ومحمد سيف وزين العابدين فؤاد.. القائمة تطول وتطول جدًا وتضم كتابًا مسرحيين وسينمائيين في موجات تلو موجات.
وفي أعقاب هزيمة 1967 التي كشفت عن حجم الأوهام والأكاذيب، وكانت صفعة على وجه الجميع، وبدأ الترنح وفقدان الوعي، تجّمع عدد محدود من الكتاب الشبان وقتها- وقرروا للمرة الأولى- منذ أمم نظام 23 يوليو الصراع الاجتماعي والسياسي، وصادر الصحف والمجلات- كسر هذا الحصار، وإصدار مجلة خاصة مستقلة عن الأجهزة المستقلة وجمعوا الدفعة الأولى من تكاليف طباعتها من تبرعاتهم الذاتية على مقهى ريش، وأصدروا مجلتهم "جاليري 68".
انتصر جيل الستينيات من الكتاب والفنانين، والموجات التي تلته للأفكار اليسارية بمعناها الأوسع، وبادر البعض منهم بالاشتراك في تأسيس الحلقات والمنظمات الماركسية السرية، فكانوا أكثر التزامًا واعتناقًا للماركسية. الأمثلة لا يمكن حصرها وكلها تندرج في طيف يساري واسع مثل يحي الطاهر عبد الله وعبد الحكيم قاسم وأصلان والبساطي وأمل دنقل ورضوى عاشور وعشرات غيرهم. واستمرت وتواصلت تلك الموجات خلال العقود التالية، ومن واجه السادات وكامب ديفيد والانفتاح الاقتصادي وقمع الأجهزة وكانوا في الصفوف الأولى هم الكتاب والفنانون المنتصرون للأفكار اليسارية والديموقراطية. الأمر نفسه استمر خلال حكم المخلوع حسني مبارك والذي امتد لثلاثين عامًا من التكلس وتصلب الشرايين والفساد والقمع. وغني عن البيان أن حجم مشاركتهم في الثورة، أعني بالطبع ثورة 25 يناير، كان ضخمًا، والكثرة الغالبة من شعاراته ومطالب الثورة جاءت على أرضيتهم. لست هنا في معرض تناول الغدر بالثورة واستيلاء الإخوان عليها، ثم ضياعها نهائيًّا في ظل النظام الجديد، لكنني في معرض الكلام عن وجود وتأثير هذا التيار من الكتاب والفنانين.
وفي النهاية أريد أن أؤكد على افتتاني برواية العامل فكري الخولي (1917 - 2000) "الرحلة"، وهو أحد أهم قادة الحركة العمالية والمناضلين النقابيين، وكتب "الرحلة" خلال وجوده في المعتقل في الواحات الخارجة عام 1962 على ورق البفرة وعلب الكبريت، وتم تهريبها من السجن، لكنها لم تنشر إلا عام 1987. ولا أظن أن الراحل الكبير صلاح حافظ كان مبالغًا عندما كتب في تقديمه لكتاب الخولي "لم يسبق في تاريخ الرواية العربية عمل من هذا الطراز"، ووصفها بأنها زلزال مرتين، مرة لأن الكاتب عامل، وليس من تقاليدنا أن يكتب العمال روايات، ومرة لأن هذا الكاتب العامل، وضع الذين كتبوا عن الفلاحين والعمال في موقف بالغ الحرج، فكل سطر في روايته الفذة حقيقة عايشها بنفسه، وكل هذه الحقائق أبلغ من كل ما صوروا من خيالاتهم. ويضيف صلاح حافظ أنه كان أحد الذين "قرأوا الرواية قبل أن تُكتب، لأن صاحبها كان سجينا معي في منفى الواحات الخارجة، وكان يرويها ببساطة، جزءا بعد جزء، ومشهدا بعد مشهد، على امتداد شهور وأعوام. وكان يمكن أن يعيد رواية أي مشهد فيها حين نرجوه أن يفعل، ودون أن يبذل أي جهد"، وينتهي حافظ إلى أن الرحلة هي "التسجيل الأدبي الوحيد لميلاد الصناعة المصرية الحديثة وللهزات التي أحدثها هذا الميلاد في قرى مصر ومدنها وقيمها". وتبدأ أحداث هذا العمل الفاتن في أحد أيام عام 1928 على لسان الصبي الفلاح فكري الذي لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره في إحدى القرى القريبة من المحلة، وفي تلك الأثناء كان شركة الغزل والنسيج قد تأسست لتوّها، وانتزعت مئات الفلاحين الفقراء من الحقول التي يعملون فيها أُجراء، وهو يتمنون ظروفًا معيشية أفضل، لكنهم يُلقى بهم إلى الطرقات حرفيًّا. يعملون اثنتي عشرة ساعة وينامون في الطرقات، ومن يسعده الحظ يسكن في حجرة يستأجرها خمسة وعشرون شخصًا ينام نصفهم بينما يكون النصف الآخر في عملهم. لا يصرخ ولا يجعجع الكاتب فما يجري أقوى من كل صياح، فيوميًّا تلتهم الماكينة صبيًّا أو عضوًا من أعضاء جسم أحدهم. لا يأكلون إلا العيش وإذا أسعدهم زمانهم يتناولون بصلة، وينفقون على أسرهم القابعة في القرى المحيطة. هذه رواية استثنائية نادرة. سجلها كاتبها مبتعدًا عن الميلودراما والصراخ، واستخدم أبسط المفردات ونقل القرية والمدينة. فأهدانا واحدة من أكثر قصص الحب عذوبة وفتنة، بين الصبية قدرية وابن قريتها الراوي فكري وكلاهما في مطلع مراهقتهما.. ملامساتهما واكتشافهما معا لجسد كل منهما. أهدانا أيضًا مشاهد المعارك الدموية بين "الشركاوية" ممن نزحوا من قراهم واجتاحوا المدينة وعاثوا فيها فسادًا، وأهدانا في الوقت نفسه مشاهد لتآزرهم معًا وممارستهم لإنسانيتهم. والأهم من كل هذا هو الروح الكامنة وراء الكتابة، والنأي عن الصراخ، واستخدام لغة بالغة البساطة والعذوبة.
ترشيحاتنا