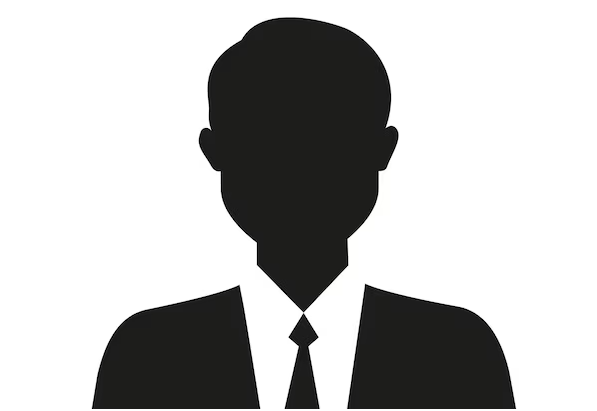رؤى
خالد يوسفكرة القدم بين «لحس الدماغ» و «فائض قيمة الحب»
2018.01.01
مصدر الصورة : ويكيبديا
كرة القدم بين «لحس الدماغ» و «فائض قيمة الحب»
"كل ما داخل هذا المستطيل هو الواقع. ما خارجه هو المسرحية".
كنت أبحث عن نص هذه الجملة الدقيق، التي كتبتها على هامش إحدى كراسات مادة الجغرافيا للثانوية العامة في منتصف التسعينيات. كتبتها بعد فوز فريقنا «المصنف الأخير» على المصنف الثاني (بين نحو 40 فريقًا في دوري المدرسة). قفزت هذه الجملة إلى ذهني على نحو عفوي بعد سماع تعليق أحد أهم الكهنة الإعلاميين لفترة حسني مبارك مؤخرًا بأنه «يشعر بالقلق لأنه يرى كيف أن كرة القدم لحست دماغ المصريين» بمفردات تليق بهلع السبعينيات من سطوة ظاهرة الكرة الكاسحة، وخطاب ربطها بالضحالة، وهو ما يشكل فصلاً مملاً متكررًا من طبقة ثقافية ترفض أن تغادر المجال العام المصري دون إغراقه بمخزونها الاستراتيجي الوافر من البلادة والكسل، في رفض صريح للخروج بخطاب مختلف عن المنتج المتعالي نفسه، الحافل بالكليشيهات ذات المغزى التربوي، الساعي في شكله الظاهري إلى حجز مقعد في مولد «استنهاض الأمة»، الذي أضحى مصدر رزق مضمون الأرباح لما يطلق عليه بالرموز الثقافية المصرية، بجناحيها العلماني والديني على حد سواء.
مفارقة حقيقية أن تكون ماكينة «لحس الدماغ» هي السبب الحقيقي «على المستوى الشخصي» لمعايشة ثلاث تجارب محورية تكاد تكون مطموسة بالكامل في دورة الحياة العادية للمواطن المصري منذ البلوغ وحتى التقاعد. الأولى في المرحلة الثانوية بإعطائي مساحة ما عادلة للمنافسة مع خصم أكثر استعدادًا وتجهيزًا، ثم الفوز عليه على عكس كل التوقعات التي تنبأت بهزيمتنا الساحقة. المناسبة الثانية كانت بإعطاء المساحة للتنافس مع أبناء طبقة كانت ولا تزال في صدام يومي معي لأسباب تاريخية وثقافية، طالما أراد المجتمع المصري أن يهيل عليها التراب في إطار نسج خيالاته الخاصة عن تناغمه وتدينه وسماحته (التي كلها تأتي مصادفة على نحو فطري استثنائي)، دون الاعتراف بشكل صريح أنه مجتمع يمارس طبقيته متنوعة الأشكال بإيقاع يومي، وبأشكال متفاوتة في عدوانيتها.
المناسبة الثالثة كانت تمهد الأرض لأهم لقاء فكري عايشته في مصر، ومع مجموعة من أبناء شريحتي العمرية في أثناء ثلاث ساعات كاملة من لعب الكرة، وتحديدًا في أبريل من عام 1997. لا يتعلق الأمر بانسجام أو اتفاق على خطوط عامة تجمع تحت ظلها هذه الحفنة من الشباب، ولكنها «تجربة» الالتقاء مع مجموعة من البشر لديهم النظرة نفسها للحياة، ولديهم تصور مشترك في موقفهم من العالم، بداية من نظرتهم إلى أدوارهم في إطار الفريق، واستغلال المساحات، والاستمتاع أسلوبًا للحياة، وتنظيم الأدوار، واحترام خصوصية واختلاف الأفراد (حتى لو كانوا في الفريق نفسه)، وهي كلها مفاهيم تصيب قلب الممارسة السياسية المجتمعية، حتى على المستوى الفلسفي، واستحالت معايشتها تمامًا ضمن أي إطار حزبي أو تنظيمي مصري، «تجربة» غائبة كطوطم أثري في الحياة العامة في مصر على مدار عقود طويلة، خيال مآتة مطلوب وجوده دون السؤال فعليًّا عن جدواه، المطلوب فقط هو قبول دورك في تلك المسرحية أو «المهزلة»، بل اعتبارها الواقع الوحيد المراد معايشته، وما غير ذلك هو «لحس الدماغ».
مملكة العالم الأوسط
مفارقة ثانية أن يأتي تصريح «الكاهن المباركي» في توقيت إصدار الفليسوف البريطاني المعاصر سايمون كريتشلي لكتابه المهم «ما الذي نعنينه عندما نذكر كرة القدم»، والذي يحاول من خلاله تأصيل دور كرة القدم في القرن الجديد، محاولاً الذهاب إلى أبعد ما ذهب إليه جاك دريدا أو إدواردو جاليانو في علاقتهما بهذه الظاهرة العالمية. وهو تأصيل متجاوز لنظريات «لحس الدماغ»، متوغلاً فيما أسماه بمملكة العالم الأوسط التي تشغلها كرة القدم، بين التخطيط والمصادفة، وبين الذاتية وموضوعية الإحصاءات القاسية، وبين فردية الأداء وجماعية الهدف. دون أن ينكر «سخف» كرة القدم، وربما «الغباء» الذي يسكن تفاصيلها في أحيان كثيرة، إضافة إلى الفساد والعصبية القبلية في أحيان أخرى، باعتبارها «حربًا مقنعة محملة بكل الحقائب التي نحملها معنا من العالم الخارجي إلى داخل مستطيل اللعب».
إلا أن الاستنتاج الأكبر الذي يشغل بال كريتشلي في كتابه هو أن كرة القدم تشغل مملكة العالم الأوسط بين طبيعتها كلعبة اشتراكية المذهب، وبين موتورها الرأسمالي الصريح. واشتراكيتها فيما يتعلق بتوزيع الأدوار، وعلاقة الفرد بالمجموع، والتي يدلل عليها بقوله «يكفي النظر إلى حركة اللاعبين داخل أرض الملعب كجسم واحد على الرغم من فروق عناصره الفردية للتعرف على الطابع الاشتراكي للعبة، في الوقت نفسه لا يمكن إغفال أن موتور كرة القدم هو المال». بيل شانكلي المدير الفني الأسطوري لليفربول يمكنه أن يتحدث عن ميوله الاشتراكية الصريحة، والدور الذي يصنعه الفريق على المستوى المجتمعي والشعبي، ولكن كل إنجازاته مع الفريق تحققت بفضل نظام رأسمالي صريح، معتمدًا بشكل كبير على سياسة شراء لاعبين جيدين للفريق.
تتزامن مملكة العالم الأوسط التي تحدث عنها كريتشلي مع تطبيق فعلي من ما ينتهجه نادي مانشسر سيتي الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتناوله بالتفصيل التحقيق المهم الذي كتبه جيليس تريمليت، ونشرته صحيفة الجادريان البريطانية عن منهج النادي الإنجليزي للسيطرة على عالم كرة القدم، متبنيًا «أممية» فلسفة كرة القدم المبهرة التي قدمها نادي برشلونة، لينشرها في القارات الست عن طريق تأسيس أندية صغيرة تسير على الفلسفة نفسها في الإدارة ورعاية اللاعبين، وأسلوب اللعب. في الوقت نفسه فالتطبيق الرأسمالي لهذه الفلسفة الأممية تبدو تفاصيله مرعبة، حيث يركب مانشستر سيتي طموح مديره التنفيذي فيران سوريانو في جعل «ماركة» النادي أكبر من مجرد نادي للكرة، وتحويل «الحب» الذي يكنه له ملايين من عشاق النادي حول العالم إلى رأس مال ملموس، يمكن صرفه من أي بنك، بدلاً عن أن يصبح حبًا مجانيًّا، والاستثمار في الطابع المحلي الصرف للنادي وجعله السلعة التي يمكن غزو أسواق عالمية بملايين المستهلكين في إندونيسيا على سبيل المثال، إنه الحب الملموس الذي سيمكن للنادي من إنشاء أندية أصغر تمثل خطوط إمداد حيوية للنادي الأم، إنها مدرسة حصد «فائص قيمة الحب» التي يتمتع بها أي نادٍ مهم على مستوى العالم، إنشاء وادي سيليكون كروي متنقل.
تبعات ذلك التطبيق لتسويق أممية مانشسر سيتي أرعبت القوى التقليدية الأوروبية، والتي اتهمت مانشسر سيتي برأسماله الإماراتي، وباريس سان جيرمان برأسماله القطري بإحداث عملية تضخم مالي كبرى بالسوق الأوروبي، وبأنها أنديه لا تدعمها مؤسسات خاصة، بل دول وأنظمة حكم كاملة، تحمل في أغلبها سجلاً مقلقًا في حقوق الإنسان واضهاد العمالة الأجنبية والأقليات وملاحقة المثليين. حسب الجادريان إنه مصير غريب لنادي تم تأسيسه في بداية الأمر فى ثمانينيات القرن التاسع عشر كوسيلة لصرف نظر العمال عن شرب الخمر وممارسة القمار الذي قد يؤثر على مردودهم المهني.
دولة النادي
كريتشلي تحدث في كتابه عن حالة التورط التي توفرها كرة القدم لجمهورها، شعور بالملكية، بأنه يمتلك أسهمًا بحصص الأندية التي ننتمي إليها، استثمارًا لجزء من الطفولة والبلوغ، والتذاكر الموسمية، والتضحية بصداقات وربما بعلاقات عائلية، كريتشلي يصف كرة القدم بأنها تطبيق لمفهوم الفيلسوف الأمريكي ويليم جيمس عن «التجربة»، وهو ما يفسر الكثير من الارتباط بالتجارب الشخصية الثلاث، حتى في أكثر القيم اضطرابًا، كالغش والإحباط والهزيمة والشعور بالظلم، إنه ليس عالمًا لطيفًا حسب تعبير كريتشلي، ولكنه مفعم بالأمل، ربما في إمكانية تحويل الهزيمة إلى فوز في أي لحظة. العالم يوجد فقط داخل المستطيل وليس خارجه، وهو ما يعطي تلك الأهمية المضاعفة للأندية صاحبة السطوة، أن تصبح دولة داخل الدولة، مؤسسة لها قانونها الخاص، إلى الحد الذي يشير فيه العديد من الكتاب أن الاعتقاد بأن ريال مدريد كان في خدمة نظام فرانكو هو اعتقاد ساذج، وأن فرانكو في حقيقة الأمر هو الذي كان في خدمة ريال مدريد ورئيسه آنذاك سانتياجو بيرنابيو.
نفس ما ألمح إليه الفيلسوف والكاتب الإسباني الكاتالوني جوسيب رامونيدا في حوار عدد ديسمبر من مجلة ريفيستا ليبيرو الإسبانية بأن نادي برشلونة كان «حجر عثرة» أساسي في قرار استقلال كاتالونيا يوم الأول من أكتوبر، بعد قراره خوض مباراة لاس بالماس في الدوري المحلي بدلاً عن قرار الانسحاب بعد ساعات من الفوضى والعنف الذي ساد يوم استفتاء الأول من أكتوبر الخاص باستقلال الإقليم، يدعو رامونيدا الجميع للتفكير في سير الأحداث لو كان البارسا غادر أرض ملعب الكامب نو في لفتة احتجاجية أو حتى رمزية، إلا أن رامونيدا يلخص الموقف كله بقوه «لقد اكتشف النادي أن استقلال كاتالونيا لا يستحق التضحية بخصم ست نقاط من رصيده في الدوري الإسباني، وهي عقوبة المنسحب من خوض أي مباراة في المسابقة».
سيعجز دعاة مكافحة «لحس الدماغ» عن تأمل المعادل المصري لظاهرة دولة النادي، وهي المتابعة الكاسحة التي عرفتها انتخابات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وذلك في الأسبوع نفسه الذي عرف مجزرة مسجد الروضة في شمال سيناء، فلا يمكن تصديق أن حالة الفراغ السياسي التام التي يعيشها المجتمع المصري، يمكنها أن تنتج قطاعًا طاغيًا من الشباب يقدمون متابعة مستقلة فاعلة في عملية الحشد والتأييد وتكوين الحملات، وتشكيل رأي عام، ومراقبة لحظية لعملية فرز الصناديق، ومحاولات تحريك المشهد في محاولة لإسقاط الرئيس الحالي للنادي مرتضى منصور، والذي يأخذ منه قطاع كبير من شباب مشجعي النادي (ممن ليس لهم حق التصويت في الأصل) موقفًا مبدأيًّا، وربما سياسيًّا أيضًا بداية من القرارات الإدارية اليومية وصولاً إلى يوم مذبحة ملعب الدفاع الجوي، والصدام المستمر مع مجموعات ألتراس النادي.
حالة الموات المجتمعي قابلها شكل من أشكال الحراك واسعة النطاق، تستخدم كل وسائل الضغط وتشكيل الجبهات والتحالفات، والتي وصلت إلى تحميل مسؤولية فوز مرتضى منصور إلى الرموز الشعبية بالنادي من معارضي المستشار من أمثال حازم إمام، وذلك برفضهم إعلان تأييدهم الصريح لجبهة المعارضة واستخدام أوراق دبلوماسية للتعامل مع هذا الملف، في الوقت نفسه كان مشجعو النادي الراغبون في التغيير على موعد مع مواجهة حقيقة ديموقراطية مريرة تتلخص في أن الجمعية العمومية للزمالك اختارت مرشحها الذي أبدى اهتمامًا فائقًا للبنية الأساسية وخدمات الأعضاء دون التوقف كثيرًا عند موقفه السياسي.
فائض قيمة الحب
إنه قرار التورط أو الملكية التلقائية الذي يشير إليه كريتشلي في كتابه، وظهر جليًّا بعد أسبوع من أحداث الزمالك، وذلك مع انتخابات الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتي تورط فيها مشجعو وأعضاء النادي تورطًا سياسيًّا حقيقيًّا، كان كاشفًا لدور رأس المال في عملية الدعاية الانتخابية، وللطبقة الحاكمة التي صنعت دولة الأهلي في العقدين الماضيين، وتعقيدات التحالفات مع السلطة (والتي عبر عنها رئيس النادي محمود طاهر تلفزيونيًّا بأن رئاسة الأهلي تسهم في تسهيلات عديدة في البزنس الخاص به)، بالإضافة إلى أهمية النوستالجيا ورأس المال الشعبي خصوصًا فيما يتعلق بحملة محمود الخطيب، حتى على مستوى تفنيد الشعارات السياسية الدعائية من أمثال «مباديء النادي» أو «الأهلي فوق الجميع»، والمتابعة الشعبية الطاغية لكل مناظرة تلفزيونية، فرص كاملة لكل المرشحين للتعبير عن تصوراتهم، واقع سياسي على قدر كبير من الشفافية، والتعبير عن رغبة حقيقية في التغيير بقدوم مجلس إدارة جديد، حتى لو كان الخطيب نفسه ليس بالقيادة الثورية الطامحة لصنع حقبة مختلفة في النادي، فيما يمكن اعتباره أنه عودة لأسطورة صالح سليم لتولي زمام الأمور بعد سنوات من سلطة «الدخيل» محمود طاهر كما كان يلقبه بعض معارضيه.
من جانبه، كان الخطيب مستوعبًا كبقية أعضاء وجمهور النادي لدور وحجم تلك المؤسسة، خصوصًا في الوقت الحالي، باعتبارها المؤسسة الوحيدة القادرة على الحشد الجماهيري، ويعتبر هذا متسقًا مع توصيفات كريتشلي التي أشار فيها إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به العديد من الأندية، خصوصًا الإنجليزية منها، والتي حصد تراكمات تاريخية لعقود طويلة مكنها من لعب أدوار أكبر من حجمها كمجرد كيانات رياضية، وهو ما يجعل الأمر منطقيًّا مثلاً مع احتجاجات جمهور فريق ساندرلاند ذي الطبيعة العمالية الكاسحة على تعيين الإيطالي باولو دي كانيو مديرًا فنيًّا للفريق، وهو المعروف بتعاطفه مع العديد من حركات الفاشيين الجدد في إيطاليا، أو الصدامات المتكررة لألتراس إي سي ميلان الإيطالي ذي الخلفية اليسارية مع إدارة مالك النادي سيلفيو بيرلسكوني، عراب نيوليبرالية الثمانينيات والتسعينيات، خصوصًا إزاء العديد من قراراته الإدارية والتنفيذية، حتى في ظل حصد الفريق للعديد من البطولات والألقاب.
مفارقة حقيقة أن تكون عملية «لحس المخ» مفتاحًا سحريًّا لفهم طبيعة السنوات الـ25 الماضية، خصوصًا بالنسبة لعملية التحول القيصيرية لتعاقدات اللاعبين (بصفتهم عمالاً يتقاضون أجرًا) والفصل بين الهواية والاحتراف، ومفهوم القبول الشعبي في الثقافة السياسية المصرية، ففي الوقت الذي كان يهندس فيه نظام مبارك عملية إقصاء وزير الدفاع عبد الحيم أبو غزالة عن المشهد كان الجماهير تهتف علنًا باسم «الجنرال» محمود الجوهري، هو نفسه الجوهري الذي تمت إقالته وتعيينه بقرارات جمهورية مباشرة استجابة للضغط الشعبي في الحالتين، عملية «لحس المخ» قد ترسم صورة أكثر صدقًا لعلاقة جماهير الأقاليم بالقاهرة وسطوتها، باختفاء الأندية ذات الطابع الشعبي واكتساح أندية الشركات، ثم أندية الأجهزة السيادية، كيف أصبحت الكرة حصان طروادة لتسيير الأعمال الخاصة، منحنى العلاقة بين الجمهور والشرطة، وتغيير الطابع الديموغرافي لجمهور الكرة، وتحديدًا منذ كأس الأمم الأفريقية 2006 واختفاء ما يسمى كلاسيكيًّا بجمهور الدرجة الثالثة. إن قصة صعود عمرو مصطفى مراد فهمي من قيادي في مدرجات ألتراس الأهلي، وصولاً إلى منصبه الحالي أمينًا عامًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم تستحق تأملاً خاصًا، فيما يمكن اعتباره «ميكروكوزم» بسيط لميكانزيمات «لحس الدماغ» وفقًا للتعبير الكسول.
«لحس الدماغ» الحرفي
مفارقة أخرى تحملها تعبيرات «لحس الدماغ» أن مطلقيها يغضّون البصر حرفيًّا عن عمليات «اللحس» الفعلية التي تتم بايقاع يومي في المجال العام المصري، آخرها صعود شركات بعينها ل«الاستحواذ» على مؤسسات العمل الإعلامي الخاص المصري، وتعبير «الاستحواذ» هو التعبير الذي استخدمه قيادي أمني لوصف هبوط شركة إيجل كابيتال على مؤسسة المصريين الإعلامية، وحسب قوله فإن الاستحواذ لا يعني الاحتكار، ولكنه التحكم التام في طبيعة الرسالة الإعلامية التي يتم تقديمها للجمهور، وتأتي عملية إيجل كابيتال على قدر من الخطورة، خصوصًا أنها «استحوذت» على شركة بريزنتيشن للتسويق الرياضي، واحدة من أذرع مؤسسة المصريين فائقة الأهمية، وأنها للشركة المحتكرة على نحو حصري لحقوق الدوري المصري لكرة القدم (الذي تقام مبارياته دون جمهور)، وذلك في سياق عام لا يسمح بإذاعة جلسات مجلس الشعب، وليس لدى الجمهور معلومات واضحة عن أبسط وقائع حياته السياسية اليومية، لتبقى كرة القدم هي النشاط الوحيد الذي يتمتع بحد أدنى من الشفافية (يسمح فيه على أقل تقدير بمحاسبة المدربين ورصد مظالم ركلات الجزاء التي لم تحتسب أو البطاقات الحمراء التي لم تشهر).
المفارقة الأخيرة أن عملية «لحس الدماغ الحقيقية» أنه عندما يتم خلطها بكرة القدم تكون العواقب معاكسة تمامًا، وكأن تلك الرياضة تقوم بعملية تصحيح ذاتي تلقائي، ويدلل كريتشلي على ذلك برغبة البوليس السري في ألمانيا الشرقية في تسهيل مهمة فريقه الكروي دينامو برلين خلال نهاية السبعينيات، وذلك من خلال عملية ممنهجة لشراء أفضل لاعبي الفرق الأخرى، إضافة إلى رتوش أخرى في ما يتعلق بالقرارات التحكيمية وترتيبات جدول المباريات، كانت النتيجة هي نجاح ساحق لدينامو برلين بالاستحواذ على لقب الدوري المحلي لعقد كامل، إلا أن معدل حضور المباريات وصل لمعدل صفري، لينصرف الألمان الشرقيون إلى دوري الجيران في الشطر الغربي، في تفضيل لعملية «لحس دماغ» من نوع آخر.
تبدو الرغبة في البقاء لاعبًا وحيدًا في الساحة أمرًا ساحرًا في عالم السياسة، فكرة طالما راودتني كلما تذكرت المناسبة الثانية التي أهدتني إياها كرة القدم، بملاقاة فريق يمثل طبقة معينة بعجرفتها وصلفها المنفر إلى أقصى حد، ذلك الاعتقاد بأنه لا يوجد من يقارعهم، وأن الهزيمة أمر غير مطروح، وغير ممكن بالنسبة لهم، والأخطر من هذا هو أن نظريتهم نجحت لوقت ليس بالقصير، مما دعم صلفهم ظاهريًّا، ما أتذكره كطابع بريد مطبوع في ذهني لم يتعرض للخدش، أن مجرد وجود فريق منافس راغب في الفوز على الملعب نفسه، أفقدهم رشدهم وأطلق جنونهم، لتبدأ حفلة عنف بدون كرة في كل الاتجاهات، فكرة المنافسة قد تكون الأكثر رعبًا، وقبل الاستغراق لوقت أكثر في ما يحمله ذلك اليوم أتذكر سريعًا الملحوظة الجانبية «كل ما داخل هذا المستطيل هو الواقع. وما خارجه هو المسرحية».
ترشيحاتنا