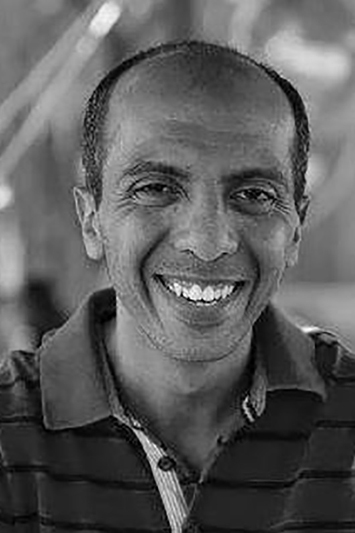هوامش
محمد جادكورونا وعصر جديد من تراجع فرص العمل فى الخليج
2021.01.01
كورونا وعصر جديد من تراجع فرص العمل فى الخليج
«أعنف أزمة تواجه سوق إلحاق العمالة بالخارج منذ نصف القرن..»، هكذا وصف عبد الرحيم المرسي؛ نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، حال سوق عمل المصريين في الخارج بعد أن تسبب وباء كورونا في تعطيل سفرهم، وانهيار معدلات منح تراخيص العمل في الخليج.
لم تكن كورونا هي الأزمة الأولى؛ فقد كانت أسواق بلاد النفط تنغلق في أوجه المصريين خلال العقود الأخيرة واحدة تلو الآخر، بدءًا بأزمة حرب العراق، إلى حرب ليبيا الأهلية، وأخيرًا تراجع أسعار النفط منذ 2014 وتأثيره على فرص العمل في دول مثل السعودية والإمارات.
لكن بلا شك فإن أزمة كورونا هي الأشد، فهي تعطينا إنذارًا بأننا قد نكون مقبلين على تغيرات عميقة في بنية الاقتصاد المصري، مع تراجع دور الريع النفطي في حياة الملايين من المصريين، والذي نشأ منذ السبعينيات، وأسهم في إعادة تشكيل حياة المصريين على أصعدة مختلفة.
جاء رد فعل بلدان الخليج لوباء كورونا متسقًا مع ما جرى في العديد من بلدان العالم؛ إذ عُلِّقَت الفور الرحلات الجوية من وإلى البلاد. وهو ما تسبب في إصابة منظومة عمل الأجانب في هذه البلدان بحالة من الشلل؛ فمن ناحية كانت العمالة الأجنبية المقيمة هناك ترغب في الحصول على إجازة، والعودة إلى لبلدانها خشية عدم القدرة على زيارة ذويهم فيما بعد مع استمرار تعطيل حركة السفر، ومن جهة أخرى لم تفتح هذه البلاد أبوابها لتصاريح عمل جديدة إلا للضرورة القصوى.
وعلى الرغم من تخفيف قيود الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في الخليج بدءًا من الصيف الماضي، فإن الأوضاع لم تعد إلى سابق عهدها؛ على سبيل المثال قررت الكويت عدم التجديد للعاملين ممن هم فوق الستين، وكذلك للعمالة متدنية المهارة، التي يطلق عليها العمالة الهامشية. كما قررت عدم التجديد أيضًا للمقيمين في البلاد ممن يتحايلون على السلطات بادعاء أنهم يعملون لدى شركات ليس لها وجود في الواقع. وتذهب تقديرات إلى أن إجمالي أعداد العمالة المتضررة من هذه السياسات الكويتية الجديدة تبلغ 360 ألف عامل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع الاقتصاد كان طاردًا حتى للعمالة التي كانت تقرر البقاء لفترة طويلة في البلاد، ولا تنوي العودة إلى بلادها في وقت قريب، على سبيل المثال تتحدث تقارير عن أن العاملين الأجانب في دبي ممن فقدوا وظائفهم بسبب التداعيات الاقتصادية للوباء لم يقدروا على تحمل نفقات المعيشة في الإمارة، خصوصًا وأنهم، كأجانب، محرومين من أشكال الحماية الاجتماعية التي توفرها السلطات للمواطنين، وهو ما دفعهم إلى العودة. وقد حاولت السلطات الإماراتية أن تشجع على هذا التوجه من خلال إعفاء من أقاموا في البلاد على نحو مخالف للقانون من غرامات تلك المخالفات بشرط أن يغادروا البلاد فورًا. كذلك أسهم الانكماش الاقتصادي في السعودية لزيادة معدلات البطالة، وكانت هناك ضغوطٌ لأن تكون الأولوية في الاستغناء عن العمالة الأجنبية، وليس المواطن المحلي.
وأمام هذه الضغوط سمحت المملكة لأصحاب العمل بوقف العقود مؤقتًا بدلًا من إلغائها، وذلك في حالة ما إذا كانت الشركة متضررة من الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، ولا تحصل على دعم من الدولة، كذلك شجعت البلاد على الاستفادة من فائض العمالة الوافدة الموجود في المملكة بدلًا من السعي لاستقدام عمالة جديدة.
لا توجد بيانات متاحة بشكل مفصل عن تأثير أزمة كورونا على حركة تشغيل العمالة الوافدة في الخليج، لكن ربما تكون السعودية هي الأكثر إفصاحًا عن أوضاع العمالة لديها، ومن حسن الحظ فإن المملكة تعد أكبر سوق عربي لتشغيل المصريين، لذا يمكن أن ننظر إلى بياناتهم باعتبارها مؤشرًا أساسيًّا لأحوال المصريين في الخارج.
ومن أبرز المؤشرات السعودية التي تعكس حجم الأزمة بجلاء هو المؤشر الخاص بعدد تأشيرات العمل الصادرة، الذي هوى خلال الربع الثاني من 2020 إلى نحو 50 ألف تأشيرة، بعد أن كانت أعداد التأشيرات تقترب من 600 ألف في الربع الأول من العام نفسه.
ويمكن أن نتفهم الضغوط الداخلية في السعودية لتخفيف أعداد العمالة الأجنبية، بالنظر إلى الفارق الكبير في مستويات البطالة بين السعوديين، والتي بلغت في الربع الثاني 15.4%، وغير السعوديين والتي تقتصر على 3.1%.
ويظهر من البيانات السعودية أن بطالة الوافدين تكاد تكون ظاهرة مستحدثة في المملكة بعد كورونا، فحتى الربع الأول من 2020 كان معدل بطالة السعوديين يقترب من الصفر، عند 0.5%.
ويقول عاملون في مجال إلحاق العمالة بالخارج في مصر إن طلب السعودية للعاملين من مصر لم يتوقف خلال أزمة كورونا، ولكن التركيز في بداية الأزمة كان على العاملين في القطاع الطبي، ثم تم السماح تدريجيًّا بدخول أنواع أخرى من العمالة بشرط الخضوع لتحليل كورونا.
ويروي عن حال العمالة المصرية في الخليج خلال هذه الأزمة، عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بالغرفة التجارية، والذي ننقل شهادته كما هي لما تحمله من دلالات مهمة عن عمق تأثير هذه الأزمة، وما تطرحه من خيارات صعبة على العاملين.
يقول المرسي « بعض العاملين في المجالات التي تضررت، خصوصًا المطاعم والمحلات التجارية والسائقين والعمالة اليومية، كانوا أمام خيارات صعبة، وكان قرارهم بالبقاء حتى عودة الحياة لطبيعتها مرهونًا بعاملَيْن؛ أولهما مدخراته التي يمكنه الاعتماد عليها لتأمين مصروفاته خلال فترة الإغلاق، والثاني وضع عائلته في مصر، وإن كانت تعتمد على تحويلاته بشكل كلي أم جزئي، وهل سيقدرون على تأمين مصروفاتهم في مصر دون الاعتماد عليه، خصوصًا وأنهم يعانون بدورهم من ظروف الإغلاق الجزئي». ويضيف «بالنسبة للبعض؛ وهي نسبة ليست قليلة، كان البقاء في الخارج مكلفًا في ظل عدم وضوح الرؤيا حول موعد فتح الاقتصاد السعودي أو الإماراتي، وهو ما جعلهم يقررون العودة إلى مصر فور أن فُتح المجال الجوي، على أمل أن يعاودوا السفر مرة أخرى إذا ما وجدوا فرصة لوظيفة بعد تراجع الوباء.. بينما كان أمام البعض الآخر فرصة للاستمرار في الخارج، خوفًا من فقد الوظيفة نهائيًّا، وعدم القدرة على السفر مرة أخرى، حتى إن بعض المسافرين اعتمدوا على تحويلات عكسية؛ بمعنى أنهم تلقوا أموالًا من عائلاتهم في مصر، تساعدهم على تخطي الأزمة، وإن كانت هذه النسبة ليست كبيرة».
حتى عام 1969 كان عدد المعارين من قبل الدولة المصرية للعمل في الخارج يقتصر على 5545 فرد، وخلال ثلاث سنوات فقط تضاعف هذا العدد أربعة أضعاف ليصل إلى 20.6 ألفًا، كان ذلك إيذانًا بعصر جديد يصبح فيه الخليج أكثر من مجرد بلدان في الجوار، ليكون بمثابة امتداد للاقتصاد المصري يشغل نسبة رئيسية من قواه العاملة.
في ذاك الوقت كانت الشريحة الرئيسية من المعارين إلى الخليج هم من حملة المؤهلات العليا وكانت النسبة الأكبر منهم، أكثر من 60%، يعملون هناك في مجال التعليم، فقد استفادت مصر في ذلك الوقت من البنية الحضارية التي أسستها منذ القرن التاسع عشر، واستثمرت في أبناءها المتعلمين، ليصبحوا بمثابة مورد أساسي للنقد الأجنبي المتدفق من الخارج إلى أسرهم في مصر، والتي عادة ما تنتمي إلى الطبقة الوسطى.
والإضافة إلى الإعارات، كان تعاقدات العمل التي تتم بشكل شخصي بين المصريين وأصحاب العمل في الخليج تمثل رافدًا ثانيًا للانتقال إلى بلدان النفط، وكانت النسبة الأكبر من أصحاب هذه التعاقدات هم أيضًا من أصحاب المؤهلات العليا، ولكن يأتي بعدهم مباشرة شريحة من لا يحملون مؤهلًا دراسيًّا على الإطلاق، وقد مثَّلوا نحو 25% في 1972، ما يعكس احتياج هذا السوق أيضًا إلى العمالة التي تأتي عادة من الطبقات الأكثر فقرًا.
ومع توسع عملية التنمية في الخليج وفورة إيرادات النفط بعد حرب 1973، الناتجة عن الارتفاع الحاد في أسعار الخام، زادت أعداد المعارين للخليج بشكل ملحوظ.
ما بين 1970 و1975 ارتفعت أعداد المعارين إلى السعودية من438 إلى 10.1 آلاف، لتصبح أكبر مركز لاستقبال الإعارات المصرية في تلك الفترة، بنسبة 37.2% من مجمل الإعارات، بعد أن كانت حصتها تقتصر على 4.7%.
ومن خارج الخليج كانت ليبيا أيضًا مصدرًا أساسيًّا للتشغيل؛ إذ تضاعفت أعداد المعارين إليها في الفترة نفسها تقريبًا، وجاءت في المركز الثاني بعد السعودية. وإجمالا زادت أعداد المعارين في 1975 لأكثر من 27 ألف معار؛ أي أننا نتحدث عن زيادة بنحو 6 أضعاف تقريبًا منذ نهاية الستينيات إلى منتصف السبعينيات.
هذا التوسع القوي لدور النفط في الاقتصاد المصري شجع البعض على التنظير بأن إيرادات البلاد من النقد الأجنبي الذي يحوله العاملين في الدول العربية لأسرهم في مصر أصبح من مصادر الريع المتدفق من الخارج، ما يعني أن الاقتصاد المصري أصبح يحمل ملامح الاقتصاد الريعي الذي يهيمن على الخليج.
وبحلول عام 1980، وضع جهاز الإحصاء الرسمي تقديرات بأن أعداد المصريين في الخارج بلغت 1.5 مليون نسمة، القوة العاملة منهم نحو 500 ألف.
وفي 2005 قُدرت أعداد العاملين في الخارج بنحو 800 ألف أغلبهم في الدول العربية. وظل الاحتياج قويًّا لكل من الفئات مرتفعة المهارة القادمة من حاملي الشهادات العليا من الطبقة الوسطى، والذين مثلوا ربع العاملين، والفئات متدنية المهارة ممن لا يحملون أي مؤهل والذين مثلوا نحو 40% من العاملين.
لاحقا أعلن جهاز الإحصاء عن تعداد السكان، والذي قدر عدد المصريين المقيمين في الخارج بنهاية 2016 بنحو 9.5 مليون نسمة، هذا العدد يشمل بالطبع المهاجرون لأغراض العمل ولأغراض أخرى، ولكن تركز الهجرة في الدول العربية وتحديدا السعودية، كبلد مجاور لمصر ويوفر فرص عمل من الأيسر على المصريين الالتحاق بها مقارنة بالفرص المتاحة في الدول المتقدمة، ربما يدلل على أن الدافع الأساسي لهجرة المصريين هو البحث عن فرص لزيادة الدخل.
هذه القوة العاملة في الخارج تمثل رافدين مهمين للاقتصاد، الأول يتمثل في عوائد النقد الأجنبي التي تضخها تلك الفئات في بنوك البلاد.
صحيح أن ما يكسبه العامل المصري في الخليج هو دخله الخاص وليس دخل الدولة، ولكنه لأنه مقيم «بصفة مؤقتة» في الخارج يكون حريصًا على تحويل مدخراته إلى مصر، وتغيير تلك المدخرات داخل بنوك مصر من العملة الصعبة إلى الجنيه، وهنا يستفيد الاقتصاد المحلي من تلك العملات الصعبة التي تتدفق إلى احتياطاته دون أن تبذل الدولة أي مجهود.
أما الرافد الثاني فيتمثل في تعزيز طاقات الاستهلاك المحلي، لا شك أن أجور المصريين في الخليج ترتفع عن مستويات أجورهم داخل مصر، فهذا هو الثمن الذي يضحون من أجله ويتركون أهلهم وذويهم ليذهبوا للعيش في بلد آخر، ومع ترقي قطاعات من المجتمع طبقيًّا تتعاظم رغباتهم الاستهلاكية، بل ويلجأ الكثير منهم إلى الحفاظ على مدخراته في صورة سلع معمرة مثل شراء الشقق والسيارات، من هنا كانت الهجرة لبلاد النفط أحد المحركات الرئيسية لنشأة مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، مثل العقارات الفاخرة والتسوق في مولات تجارية متخصصة في بيع براندات عالمية مرتفعة الثمن، وغيرها من أشكال الرفاهية التي لم تكن منتشرة في بلادنا قبل فورة النفط.
وبالنظر إلى تطور تحويلات المصريين في الخارج، نجد أنها نمت بوتيرة سريعة من أقل من مليار دولار في السبعينيات إلى أكثر من 25 مليار دولار في الوقت الراهن. لكن من التبسيط المخل أن نتعامل مع تلك الأرقام بشكل مجرد عن الظروف المحيطة بها، فمن الوارد أن تكون التحويلات بقيم أكبر، ولكنها لم تظهر في البيانات الرسمية لأن التحويل لم يتم عبر البنوك؛ ففي الأوقات التي يتسع فيها الفارق بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق السوداء يلجأ الكثيرون إلى إجراء تلك التحويلات خارج القطاع المصرفي.
ولكن بصفة عامة، فإن تلك التحويلات على مدار تاريخها الطويل منذ السبعينيات كانت عادة ما تمثل 10% من ناتجنا الإجمالي، وهي نسبة مؤثرة تجعل تغير أحوال العاملين في بلاد النفط صداعًا مزعجًا للاقتصاد بأكمله، فماذا جرى في أسواق الخليج خلال السنوات الأخيرة؟
على الرغم من أن الوضع كان مثاليًا في السبعينيات، إذ كان النفط يتدفق بغزارة في شرق وغرب مصر، وترتفع أسعاره بشكل مذهل في بلاد تعاني نقص العمالة وتحتاج للمعلم والمهندس وعامل البناء، لكن خلال العقود التالية بدا الأمر وكأن لعنة ما تغلق أبواب تلك الجنة واحدا تلو الأخر!
بدءًا من أزمة العراق، بدا هذا البلد في نهاية الثمانينيات وكأنه يتحول إلى جحيم للمصريين مع فرض قيود على تحويل أموالهم إلى مصر وتأخر صرف الكثير من مستحقاتهم، بجانب موت الكثير منهم خلال الحرب مع إيران، أو حتى بعد انتهاء الحرب في ظروف غامضة، فيما يعرف بظاهرة النعوش الطائرة، وبحلول التسعينيات دخل العراق في دوامة الغزو الأمريكي التي جعلت العمل هناك عملًا انتحاريًّا.
انتقالًا إلى السوق الليبية التي تحولت إلى جحيم هي الأخرى مع اندلاع الحرب الأهلية في البلاد بعد سقوط القذافي في 2011، كان هذا السوق القريب جغرافيًّا من مصر ملجأ أساسيًّا لقطاعات واسعة من فقراء الصعيد من العمالة متدنية المهارة، لكن مع صعود نفوذ التيارات المتطرفة في البلاد استُهدِف مصريون بالاغتيال، كما دخل اقتصاد البلاد بأكمله في دوامة من التدهور مع انقسام السلطة.
وعلى الرغم من استقرار الحالة السياسية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، فإن اقتصاد هذه المنطقة تضرر بشدة منذ 2014 مع انخفاض أسعار النفط العالمية، الأمر الذي تسبب في تعطل حركة الإنفاق على الإنشاءات في السعودية على سبيل المثال، وما مثَّله ذلك من نقص في فرص العمل لقطاعات واسعة من المشتغلين في الهندسة وأعمال البناء وغيرها.
كما أن بلدان الخليج كانت حريصة خلال العقود الأخيرة على توطين الوظائف لديها، وذلك لعدة أسباب أهمها رغبتها في الحد من نزيف الاقتصاد الناتج عن تحويل أجور العاملين الأجانب إلى بلادهم الأصلية، بدلًا من استهلاكها داخل البلاد.
بدأت السعودية في صياغة خطط خمسية لإدارة اقتصادها منذ الستينيات، وذلك بهدف تمدين المملكة واستثمار عوائد النفط في التنمية، وقد تبنت مفهوم سعودة الوظائف منذ الخطة الخمسية الخامسة للحد من تدفق الأموال للخارج.
وفي الوقت الراهن تدعم الدولة مؤسسة تحمل اسم «صندوق هدف»؛ والذي يقوم على تدريب العمالة المحلية، ودعم نسبة من أجورها لدى القطاع الخاص لتشجيع أصحاب العمل على تشغيل السعوديين.
كما أعلنت السعودية قبل أيام عن تعديلات جذرية في نظام الكفالة، وهو النظام الذي اعتبرته الدوائر الحقوقية الدولية أنه ينطوي على انتهاكات واسعة للحقوق الأساسية في العمل، وكانت المملكة ترى أيضا أنه في غير صالحها.
نظام الكفالة كان يقيِّد حق العامل الأجنبي في قبول عرض عمل آخر داخل المملكة غير الذي تعاقد عليه مع الكفيل، بل ويمنعه من السفر للخارج طالما لم ينته عقده مع الكفيل، هذا النظام كان يعزز من رغبة أصحاب العمل في تشغيل الأجانب، فهم لا يقدرون على التحكم والسيطرة على العمالة السعودية إلى هذه الدرجة، لذلك اتجهت المملكة قبل أيام للإعلان عن أنها سترفع هذه القيود في مارس القادم بهدف المزيد من السعودة.
الجنة، كما تبدو في خيالنا هي مكان نشعر فيه بالأمان، لأن الأنهار تتدفق فيها من تحت أقدامنا ولا تنضب أبدًا، هكذا بدت أسواق العمل في بلاد النفط العربية خلال السبعينيات؛ حيث كانت إيرادات النفط تتدفق بلا توقف.
وبدت حكومات تلك البلدان في أشد الحاجة لنا وهي تتعطش لاقتباس خبراتنا الطويلة في المدنية عن طريق أصحاب المؤهلات العليا، كما تحتاج إلى العمالة متدنية التعليم أيضًا كي تشيِّد لها الأبراج على أنقاض حياة البداوة القديمة. وقد أسهم هذا التكامل، بين توفر الموارد والجوار المصري الغني بفائض ضخم من العاملين على مختلف مستويات مهاراتهم، في نقل جزء مهم من عوائد النفط إلى مصر، ومعها جرت تحولات عميقة في بنية الاقتصاد المصري وأنماط معيشة واستهلاك الأسر المصرية. لكن عدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان النفط، وتراجع أسعار الخام لفترات طويلة، جعلت أنهار الموارد تبدو شحيحة للمرة الأولى منذ عقود. ولا يزال غير واضح مستقبل الاقتصادات النفطية في المنطقة وظروف العمل فيها، خصوصًا وأن أسعار النفط كانت تتراجع من قبل أزمة كورونا، مما يدلل على أن مشكلة أسعار الخام لم تكن أمرًا عارضًا يرتبط بالوباء وإنما أزمة تتعلق بأساسيات الاقتصاد العالمي. كذلك فإن تركيز بلدان الخليج على توطين فرص العمل لديها، خصوصًا في ظل شح الموارد في الفترة الأخيرة، يزيد من ضغوط وصول المصريين إلى فرص العمل في هذه الأسواق، كل هذه العوامل قد تنبئنا بأننا مقبلون على حقبة جديدة تختلف عما رأيناه منذ أن صعدت أسعار النفط في السبعينيات.
ترشيحاتنا