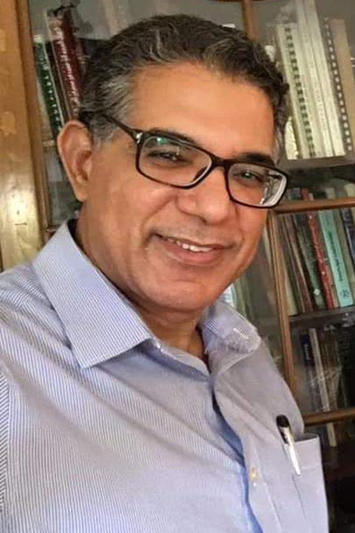دراسات
ناصر أحمد إبراهيمالبعد النقدي في الكتابة التاريخية عند جيل الستينيات: رؤوف عباس ومنطلقاته الفكرية نموذجًا
2018.11.01
البعد النقدي في الكتابة التاريخية عند جيل الستينيات: رؤوف عباس ومنطلقاته الفكرية نموذجًا
إن من يتصدى لدراسة تطور المدرسة التاريخية المصرية في القرن الماضي، لن يمكنه إلا أن يتوقف عند جيل الستينيات، ليمعن النظر في النقلة النوعية التي أحدثها الإنتاج الأكاديمي الرصين لهذا الجيل في مجال الكتابة التاريخية، سواء على مستوى المناهج والأفكار أو من ناحية طبيعة الموضوعات البكر غير المطروقة التي فتحت مجالات جديدة للدراسات والأطروحات العلمية بالجامعات المصرية والعربية. فقد كانت الجامعة المصرية، منذ إنشائها، تتمسك بمنهجيات المدرسة التاريخية الألمانية والمدرسة المثالية والمدرسة الوضعية، تمزج بينها بوعي أحيانًا، ودون وعي في أغلب الأحيان، إلى أن نهض بعض المؤرخين المصريين باستخدام المنهج المادي الماركسي في منتصف الستينيات، وهو ما قادهم –ضمن أسباب أخرى– إلى الاتجاه بالكتابة التاريخية نحو دراسة تاريخ المجتمع.
يبدو أن التغير الذي طرأ على بنية النظام الاجتماعي والسياسي قد ترك انعكاساته على المناخ الفكري لهذا الجيل الجديد الذي نشأ ونما وعيه خلال الأربعينيات والخمسينيات، حتى استوى على عوده في الستينيات. بات هذا الجيل نازعًا نحو دراسة الواقع الاجتماعي قبل وبعد ثورة يوليو 1952 وما أثارته من قضايا تتعلق بتاريخ المجتمع والقوى الاجتماعية، وتلمس جذور تكوينها الاجتماعي في الماضي، الأمر الذي هيأ الظروف -لأول مرة- لكسر هيمنة التاريخ السياسي على الساحة الأكاديمية، وفتح المجال للتاريخ الاجتماعي كنمط جديد في الكتابة التاريخية.
كان هذا عين ما جرى مع جيل الستينيات الذي كان شاهدًا على التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مرت بها مصر منذ قيام ثورة يوليو. فقد عاصر شباب هذا الجيل بوعي تام تطورات ثورية غير مسبوقة أحدثت تغيرًا هائلاً في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: ففي هذه الفترة صدرت قرارات الإصلاح الزراعي، وحماية العمال من الفصل التعسفي، وخروج الإنجليز من مصر، ثم تأميم شركة قناة السويس، ووقائع العدوان الثلاثي على مصر (1956)، وحركة التأميم الكبرى لوسائل الإنتاج الكبيرة، وتكوين القطاع العام وقيام الدولة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطنين ورعايتهم لمواجهة احتياجات الحياة ومتطلباتها...إلخ. كان لهذه التطورات تأثيرًا مباشرًا على المجتمع بكل طبقاته الاجتماعية، وهو ما أثر بالضرورة على التوجهات الفكرية لجيل الستينيات، والتي وجدت انعكاساتها جلية في اختياراتهم لموضوعات رسائلهم العلمية (الماجستير والدكتوراه) بمبادرة شخصية من جانبهم متأثرين في ذلك بالتيار الواقعي الجديد في مصر.
كان من بين ذلك جيل من المؤرخين الشباب أمثال رؤوف عباس، وعاصم الدسوقي، وعلى بركات، وعبد الرحيم عبد الرحمن، ومحمود متولي وغيرهم ...إلخ ممن تفتق ذهنهم على مناخ اجتماعي جديد، فجر فيهم أسئلة جديدة، تحاول مساءلة الواقع الاجتماعي قبل وبعد ثورة يوليو؛ من خلال التركيز على فهم دور البنية الأساسية في صياغة حركة المجتمع المصري بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وكان ذلك سببًا في انجذابهم إلى استخدام «المنهج المادي الماركسي» بدرجات متفاوتة من الفهم والتوفيق، إذ مضى بحثهم المعرفي حول تلمس أسس هذه المنهجية خارج رحاب مؤسسة الجامعة؛ أي أنهم تفاعلوا مع هذا الجانب من المعرفة المنهجية بجهود فردية لا مؤسسية. ويكفي أن نشير إلى أن بعض أساتذتهم المشرفين عليهم لم يتقبلوا بسهولة استخدامهم لهذه المنهجية ومصطلحات العلوم الاجتماعية المتعلقة بها كمفهوم الطبقة الاجتماعية والقوى الإنتاجية وعلاقات الإنتاج...إلخ.
صحيح أن بعض الكتابات كانت قد سبقتهم في استخدام التفسير المادي للتاريخ، إلا أنها كانت تعاني قصورًا في أساسها المعرفي والنظري، من جراء منهجيتها التي غلب على بعضها الوصف السردي، ولم يستطع بعضها الآخر الفكاك من إسار النظرية الماركسية وطابعها الأيديولوجي الصارم. في حين أن جيل الستينيات أفاد من تلك الأطر النظرية واستطاع توظيفها كمجرد أدوات معرفية مساعدة في التحليل والبناء الموضوعي (لا الأيديولوجي)، مما جعل كتاباتهم الجديدة تمتاز بالبعد النقدي والتماسك المنهجي دون الوقوع في فخ القولبة النظرية.
التمرد على الكتابة التقليدية وتحطيم الأوثان الثلاثة
من هنا مثَّلت أعمال جيل الستينات نوعًا من التمرد على التقليد، إذ أمكنهم الاتجاه بالكتابة إلى تبني تقاليد جديدة، تقضي بتحطيم الأوثان الثلاثة الشائع تقديسها في الكتابة التاريخية المصرية والعربية بشكل عام، وهي: الوثن السياسي، والوثن الفردي البطولي، والوثن السردي الوصفي (أسلوب القص التاريخي). هذا الاتجاه الجديد، الذي وسع من استخدام أدوات المنهجية المادية، أعطى دفعة قوية لتحرير الدراسات التاريخية من هيمنة التاريخ السياسي والدبلوماسي وتاريخ الحروب، ليصبح المجال مفتوحًا أمام دراسة تاريخ المجتمع وتطوره، وحركة القوى الاجتماعية فيه، وشبكة العلاقات الرأسية والأفقية داخله بكل تناقضاتها، وتحليل البنية الاجتماعية لفهم الطبيعة المعقدة للنظم والتقاليد والأعراف، إلى جانب تطور البناء الاقتصادي بكل ما يتضمنه من قوى الإنتاج وعلاقاته، وتأثير شكل الملكية وما يرتبط بها من ممارسات على تشكيل العلاقة بين الناس في عملية الإنتاج الاجتماعي والثقافي. كانت هذه المنهجية الجديدة والمفاهيم المرتبطة بها بمثابة ثورة في الكتابة التاريخية.
وهكذا أمكن لجيل الستينيات تجديد شكل الكتابة التاريخية وأدواتها، ليكونوا بحق رواد مدرسة التجديد في الكتابة التاريخية العربية. اطلع هذا الجيل على كل جديد في ثورة المناهج الحديثة، وتواصل مع الدوائر الأكاديمية في الشرق والغرب بطرق وتجارب وأشكال مختلفة من التواصل والتفاعل. كما قام بترجمات لها صلة وثيقة بهذا الاتجاه، فضلاً عن كتابة العديد من المقالات التي حاولوا من خلالها لفت الانتباه إلى نشر الثقافة المنهجية وضرورتها في الكتابة، علاوة على تنظيمهم للقاءات فكرية ونشر حواراتهم ومناقشاتهم إلى جانب عدد من الدراسات تحت عناوين مهمة ودالة على وعيهم بوجود أزمة منهجية في حركة الكتابة التاريخية المصرية والعربية على حد سواء. من ذلك مقالات حملت عناوين من قبيل «تاريخنا: كيف كتب، وكيف ينبغي أن يكتب؟» و«إشكاليات كتابة التاريخ المصري في واقعنا الراهن»، و«في الطريق إلى مدرسة اجتماعية في كتابة تاريخ مصر الحديث»، و«ملاحظات منهجية حول كتابة تاريخ مصر»...إلخ. تلك المقالات التي تابعتها ورحبت بنشرها مجلة فكر، التي أفردت لها ثلاثة أعداد كاملة (العدد 5/ 6/ 11) التي صدرت بين عامي 1985 و1988.
كان جيل الستينيات إذن يحمل في يد مشعل التجديد في شكل الكتابة، وفي اليد الأخرى مشعل تشخيص الأزمة الماثلة في منهجية الكتابة، ومحاولة نشر الوعي بها وبكيفية معالجتها وتقويمها. كان هذا القلق المبكر بحقيقة المنحنى الصعب للأزمة بمثابة صرخة مدوية، لكن لسوء الحظ لم تكن ثمة استجابة حقيقية. وخلال عقد التسعينيات اهتموا بإقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة التي احتلت فيها أزمة المنهج بؤرة الاهتمام والنقد والتحديد لأبعادها.
لكن فور انتهاء تلك الندوات «كان ينفض السامر –والكلام لرؤوف عباس- دون أن يترتب على ذلك أي تغيير نوعي في واقع الحال». ومن ثم انعكس أثر ذلك جليًّا في استمرارية تفاقم الأزمة المنهجية، وتجاوزها الألفية الجديدة، لتستغرق جيلاً آخر، وبشكل ربما أكثر ضعفًا مقارنة بما كانت عليه الحال في الربع الأخير من القرن الماضي، ما ساهم في تكريس حالة الضعف التي ترتب عليها تخلف الكتابة التاريخية العربية عن تطوير نفسها ومعالجة مواطن قصورها وضعفها.
أضحت الأزمة المتفاقمة بمثابة ظاهرة مستمرة، سادت الوطن العربي عمومًا، ومصر خصوصًا، وتجلى ذلك في معظم ما تخرجه المطابع من كتب وما تجيزه الجامعات من أطروحات للماجستير والدكتوراه. وكان رؤوف عباس أكثر أبناء جيله قلقًا واهتمامًا بدراسة هذه الظاهرة والتي أفرد لمعالجتها العديد من المقالات المتخصصة في مناقشة أبعاد الأزمة، كما تناولها ضمنيًّا عبر مؤلفاته المختلفة. وكان من بين ما لفت الانتباه إليه أن أسباب تفاقم الظاهرة واستمراريتها مرده إلى حالة القصور الشديد في الإعداد المنهجي للباحثين، والتي انعكست بدورها سلبيًّا على مكون الرسائل العلمية التي بات الاهتمام فيها برصد المعطيات الإخبارية من المصادر الأرشيفية على حساب الاهتمام بمنهجية المعالجة والتحليل. وبالمحصلة أصبحنا كنتيجة لهذه الأزمة أمام «حالة من التضخم في الإنتاج وضآلة في المعرفة»، على حد وصفه.
وهنا تحديدًا تظهر قيمة إسهامات رؤوف عباس؛ وبالأخص دوره في تشريح هذه الظاهرة، وتشخيص أسبابها، فضلاً عن تقارب وجهات نظر أبناء جيله مع ملاحظاته النقدية ومواقفه الفكرية إزاء الحالة المتردية في الكتابة التاريخية التي أطلق عليها رؤوف عباس اصطلاحًا دقيقًا «الإفلاس المنهجي». وعبر كتاباته ومؤلفاته التي ربت على الخمسين مؤلفًا (ما بين دراسات وبحوث ومقالات وترجمات) نشرها على مدار ما يقرب من أربعة عقود من الزمن، قدم رؤوف عباس ما يمكن تسميته بـ«الخطاب النقدي في الكتابة التاريخية المعاصرة».
تحاول هذه المقالة تكثيف معالجتها حول تحليل بنية الخطاب النقدي التاريخي في كتابات رؤوف عباس، وتحديد منطلقاته الفكرية التي شكلت على مستوى الممارسة منهجيته في الكتابة من ناحية، ومن ناحية أخرى عكست موقفه النقدي إزاء كثير من الإنتاج الأكاديمي المنشور في الساحتين المصرية والعربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
النظريات النموذج وقولبة تاريخ المجتمعات
ثمة أربع منطلقات فكرية أساسية ارتكزت عليها تحليلات رؤوف عباس في معظم دراساته وبحوثه، يأتي في مقدمتها: رفضه لقولبة تاريخ المجتمعات في إطار ما أطلق عليه «النظريات النموذج» التي تحاول تفسير التاريخ من منظور «أحادي النظرة» يتسم بالصرامة والتعميم، ويتعمد إغفال التباين الواضح بين المجتمعات. إذ يعمل أصحاب هذا الاتجاه على التقاط المادة التاريخية التي تتفق مع «القالب النظري» الذي يروجون له، في حين تستبعد عشرات الدلائل والشواهد التي تتناقض مع أسس النظرية. يجعلنا هذا في النهاية أمام «منتج مشوه» لا يساير الواقع التاريخي بأي حال من الأحوال، كما تخرج هذه «المنهجية الانتقائية» دراسة الظاهرة التاريخية عن سياقها الواقعي.
وفي هذا السياق النقدي بيَّن رؤوف عباس ضرورة تحرر المؤرخ من النزعة الذاتية الضيقة، وأن يعالج الظاهرة في السياق التاريخي الأرحب الذي برزت من خلاله، ليغوص في عمق واقع الظاهرة المدروسة، محللاً ما نجم عنها من آثار مختلفة على المستوى اﻻقتصادي/اﻻجتماعي. كما يتعين عليه أن يأخذ في اﻻعتبار تجلياتها اﻷخرى المباشرة وغير المباشرة على تشكيل البنية السياسية والثقافية للمجتمع، وهذا تحديدًا ما يعرف عند رؤوف عباس «بالمنظور التاريخي (الواقعي) في فهم التاريخ».
كما أوضح أن الآخذين بهذا التفسير (أحادي النظرة) وقعوا في تناقضات شديدة عند تفسيرهم لتاريخ مصر الحديث: فكل منهم حاول تطبيق النظرية بحذافيرها دون مراعاة الظروف الموضوعية لتطور كل مجتمع، وتباين الموروث الثقافي والاجتماعي، وتفاوت درجة الاستجابة للتحديات التي يتعرض لها كل مجتمع. وعنده أن «المجتمع لا يمكن أن يُشَكلَ في قالب معين، فهو كائن عضوي متغير، تحكم تطوره ظروف موضوعية مادية، لا تتفق بالضرورة مع بعضها البعض من حيث المظهر والجوهر، ولا تتساوي بالضرورة -أيضًا- من حيث ما تتركه من أثر على المجتمع، فوجودها وطبيعتها ودورها في دفع التغيير يختلف اختلافًا جذريًّا من مجتمع إلى آخر». ولذلك رأى أنه من غير المقبول استخدام إطار نظري بعينه لتفسير تطور مجتمع ما تختلف ظروفه ومراحل تطوره اختلافًا بيّنًا عن المجتمعات الأخرى.
وفي هذا الصدد انتقد عباس أرباب الفكر الاستشراقي بشكل خاص؛ جراء اعتيادهم الترويج لأطر نظرية مُعَدة بعناية لجعل الشرق بالضرورة «الصورة المضادة» للغرب في كل مناحي الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن ثم فالأهداف والنتائج محددة سلفًا قبل البحث والدراسة، ويصبح دور المؤرخ/المستشرق تأويل ما ينتقيه أو يرصده من حالات فردية (ﻻ تمثل سوى حالات استثنائية)؛ سعيًا إلى تشكيل انطباع عام، يؤدى إلى التأكيد على فكرة الفصل بين ما هو شرقي (متخلف/ ومتدهور) وبين ما هو أوربي أو غربي (متقدم/ مزدهر) بصورة حتمية! ومن هنا تصبح مهمة الأخير المتقدم أن ينهض بالأول المتخلف، وهو ما ﻻ يمكن تحقيقه -وفقًا لأصحاب هذا الاتجاه- سوى من خلال «أطروحة التدخل» (الغزو الاستعماري). وهذا ما يفسر ارتباط )الاستشراق في القرن التاسع عشر) بالكولونيالية (الاستعمار). وعلى ذلك فالكتابة التاريخية الاستشراقية ليست اختبارًا لفرضيات أو طرحًا لإشكاليات تستهدف البحث عن إجابة (موضوعية)، وإنما هي نظرة متحيزة ذات طابع أيديولوجي؛ من جراء شدة اﻹفراط في التنظير المجرد واﻻبتعاد عن دراسة حقيقة الواقع التاريخي الذي تدلل عليه الوثائق الأصيلة. لا يقدم اﻻستشراق الكولونيالي بهذا المعنى سوى «رؤية افتراضية» أو «صورة مُتخيلة» عن الشرق، ﻻ تمت للواقع التاريخي بصلة، ويصفها رؤوف عباس «بالنظرة اﻷحادية للتاريخ».
غير أن ذلك لا يعني أن رؤوف عباس نادى بطرح المقولات النظرية جانبًا، أو أنه اتخذ منها موقفًا سلبيًّا، بل على العكس من ذلك تمامًا، نجده يؤكد أهمية الاستفادة من النظرية في تفسير (بعض) مراحل تطور المجتمع التي تصلح النظرية كأداة منهجية لتحليلها، وأن على المؤرخ أن يتجنب الانتقائية في استخدام المادة التاريخية، والتزام النظرية النقدية، وتحاشي التعسف في توظيفها في سبيل تفسير الحالة التي يدرسها. خلاصة الأمر أن النظرية لا تصلح للتعميم الذي يتغاضى عن التباين الواضح بين كل مرحلة وأخرى، وأنها لا تعدو أداة معرفية لتحليل بعض أوجه الظاهرة التاريخية خلال عملية تطورها.
تعدد أنماط التطور
ويرتبط بهذا إيمان عباس بــ«تعدد أنماط التطور»، وهو ما يمثل المنطلق الفكري الثاني في كتاباته: فالمجتمعات ﻻ يمكن أن تتطور وفق سياق تاريخي واحد، فلكل مجتمع مقومات التطور الخاصة به، وليس ثمة نموذج واحد ووحيد للتطور؛ وأنه ﻻ يوجد قانون واحد يحكم المجتمع، أي مجتمع، ومن ثم يتعين مراعاة جانب الخصوصية التي تنبع من الظروف البيئية، والتي تحدد مسار التجربة. تتعدد أنماط التطور إذا تبعًا لتباين ظروف وسياق التطور في كل مجتمع من المجتمعات. من هنا جاء رفضه للطرح اﻻستشراقي عند «دعاة التحديث» و«نمط اﻹنتاج اﻵسيوي» أو «فكرة اﻻستبداد الشرقي»، أو فكرة «نمط اﻹنتاج الخراجي»...إلخ. مؤكدًا على أن التاريخ اﻹنساني تيارٌ من التطور، ﻻ يثبت على حال واحدة، في حين يحاول دعاة اﻻستشراق البرهنة على وجود «جوهر ثابت» يمايز بين المجتمعات الشرقية والمجتمعات الغربية.
مجيء الغرب ليس شرطًا للتطور
يقودنا ذلك الطرح التحليلي إلى المنطلق الفكري الثالث في كتابات رؤوف عباس، والمتمثل في رفضه التركيز على تفسير التطور والتغير الذي يطرأ على المجتمعات من خلال ما يعرف بـ«المؤثر الخارجي». فذلك ليس سوى عامل واحد، وحركة تطور المجتمعات تتسم بالتعقيد والتداخل بين العوامل الذاتية الكامنة في المجتمع، التي تدفع حركته التاريخية، وبين العامل الخارجي الذي عادة ما يُشكل تحديًّا قويًّا للمجتمعات التي تقع ضحية للاستعمار.
وعلى ضوء ذلك يرى رؤوف عباس أن قدوم الغرب لم يكن بعثًا للحياة في مجتمعات الشرق، وإنما كان من معوقات تطورها، ويعد هذا قلبًا لكل المنظومة الفكرية للمدرسة الكولونيالية التي تحاول الترويج لفكرة شيوع «التخلف والركود الحضاري» في المجتمعات اﻹسلامية الشرقية، وأن الغرب كان مضطرًا؛ انطلاقًا من مفهوم «الرسالة الحضارية» المزعومة، ﻹزالة هذا التخلف والركود الذي ران على الشرق؛ وذلك من خلال أطروحة الغزو. هنا يكشف رؤوف عباس عن أن اﻻستشراق كان جناحًا هامًا للمدرسة اﻻستعمارية، وأن تبرير التدخل اﻻستعماري كان أحد اﻷفكار التي بلورتها المدرسة الاستشراقية للقوى اﻹمبريالية منذ القرن التاسع عشر لتجميل وجهها القبيح.
ويكشف رؤوف عباس عن حقيقة الدور الذي لعبه اﻻستعمار في إعاقة النمو اﻻقتصادي في البلاد التي خضعت لحكمه، وربطها باقتصاده بروابط التبعية كمناطق لتزويده بالمواد الخام في أسواقه، وهي آليات أدت في رأيه إلى إعاقة تكوين السوق الوطنية، وشل حركة نمو اﻹنتاج المحلي. بل إنه يؤكد على أن اﻻحتلال اﻹنجليزي كان مسؤولاً عن إجهاض مشروع النهضة أو التنمية الذاتية التي تحققت في عهد محمد علي باشا. كما يُعزى إليه تكريس التخلف الحضاري «فالغرب لم يسمح إﻻ بتحول محدود للبنية اﻷساسية للمجتمع المصري، بالقدر الذي يتيح له ربط البلاد بروابط التبعية اﻻقتصادية والسياسية والثقافية«.
أما الحملة الفرنسية فيرى رؤوف عباس أنها كانت بمثابة «صدمة» هزت المجتمع بدرجة عنيفة، أسفرت عن إفاقته من سباته العميق، فنشطت عوامل التغيير الكامنة في المجتمع والتي استغلها محمد علي باشا أحسن استغلال في تحقيق مشروع دولته الحديثة. وهو يوضح أن اﻹصلاح والتحديث ﻻ يأتي إﻻ تلبية للظروف الموضوعية للمجتمعات (بنية وتكوينًا وتجربة). ومن هنا جاء تشديده على ضرورة إعادة تقييم حجم الدور الذي ساهم به «المؤثر الخارجي» الممثل في قدوم الغرب، وذلك على ضوء تحليل العوامل الكامنة في المجتمع، والتي أطلق عليها «دور البنية اﻷساسية في صياغة حركة المجتمع بكل أبعادها». فالتحولات اﻻجتماعية واﻻقتصادية والسياسية في تاريخ المجتمعات مسألة معقدة، وﻻ يمكن تفسيرها من منظور «أحادي النظرة» وإلا جاء مجال الرؤية محدودًا، مما يؤثر على قيمة ما يتوصل إليه المؤرخ من نتائج تأثيرًا سلبيًّا.
ووفقًا لذلك فقد فسر غير مرة بأن مجيء الحملة الفرنسية (بكل أبعادها ومؤثراتها) لم يحدث انقطاعًا تامًا مع الماضي، دون أن يقلل من أهمية نتائجها. وإنما يري ضرورة الأخذ في الاعتبار مسألة الاستمرارية للكثير من الظواهر التاريخية متجاوزين فكرة التحقيب التعسفية، وأن فهم وتقييم تجربة مصر في القرن التاسع عشر لا يمكن أن تتم بمعزل عن دراسة التطورات السابقة في القرن الثامن عشر، من أجل فهم تاريخنا القومي فهمًا يستند إلى حركة ذلك التاريخ.
تباين مستوى النمو المادي والثقافي بين المجتمعات
ويتمثل المنطلق الفكري الرابع والأخير في تشديده على أهمية دراسة الموروث الثقافي والاجتماعي لكل مجتمع، إذ إن ذلك هو الرصيد التاريخي الذي يطبّع كل مجتمع بخصوصية فريدة في تطوره التاريخي: فالدين والقيم الأخلاقية والتراث الثقافي الاجتماعي تُشكل في مجملها منظومة أساسية تلعب دورًا محوريًّا في تشكيل حركة تطور المجتمعات، وهي المسؤولة عن اختلاف مسارات التطور بين مجتمع وآخر، بغض النظر عن تماثل المجتمعات في بعض مراحل التطور.
وعنده أن كل ظاهرة تاريخية ﻻ تظهر مصادفة أو فجأة، ولكن ﻻبد أن يكون وراءها تراث ثقافي وفكري واجتماعي طويل معقد يؤدى إلى بروزها فوق السطح في لحظات نضوجها واكتمال دورتها من النمو والتَشكُّل. ومن ثم يتعين على المؤرخ أن يولي اهتمامه بإعادة تركيب الظاهرة في ضوء الإلمام بهذا التراث المرتبط بتكوينها، والبحث في عوامل الحركة فيها، ثم تفسير تطور المجتمع في إطارها، دون التقيد المسبق بقالب نظري معين أو بالأفكار الجاهزة التي يسعى إلى إثباتها لا اختبارها أمام البحث والاستقصاء المعرفي التاريخي.
إن ما قدمه رؤوف عباس من إنتاج (نموذجًا لجيل الستينيات) جدير بأن نستدعيه اليوم، ونعكف على دراسته وتأمله، وأن نخضعه لمقاربات تسمح بفهم واضح لأبعاد هذه التجربة الستينية الرائدة في مجالها. فما أنجزه هذا الجيل من إنتاج علمي متميز أحدث تجديدًا لمستوى الكتابة التاريخية المصرية والعربية، وذلك على مستويين: الأول مستوى المنهجية الجديدة (المنظور المادي للتاريخ) التي اختبرها في أطروحاته العلمية، والذي أمكنه من خلالها تحريك بوصلة الاهتمام من دائرة التاريخ السياسي (تاريخ السلطة: السلالات والجنرالات) إلى تاريخ الأمة (المجتمع، وشبكة علاقاته، ودينامية القوى الاجتماعية داخل نسيجه)، وهو ما بلور في النهاية مدرسة علمية رائدة في التاريخ الاجتماعي. وجاء المستوى الثاني في التجديد عند هذا الجيل انطلاقًا من المسؤولية الأخلاقية والعلمية قبل الأجيال التي أشرف على تكوينها، وذلك باهتمامه بتقديم خبرته في معاناة الكتابة، وفي الإلمام بكل جيد في مجال المنهجيات، وذلك عبر سلسلة من المقالات واللقاءات العلمية، متبعًا النقد الموضوعي وممارسة فن المراجعة لمحصلة الإنتاج العلمي التي جرى إنجازها خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي وبدايات الألفية الجديدة.
ولعل المعنى العميق والبعيد في (التجربة الستينية في الكتابة) -إذا جاز هذا التعبير- أنها اعتبرت المؤرخ لا الوثيقة هو منتج المعرفة التاريخية، وأنه من خلال تنمية كفاءة المؤرخ وإثراء خبرته عبر تسليحه بالثقافة المنهجية التي لا تتوقف عن تجديد نفسها، يمكننا تطوير مستويات الكتابة وأدواتها وجعلها مسايرة للتجارب المختلفة المنجزة في الشرق أو الغرب. ولذلك كانت خلاصة تشخيص رؤوف عباس للأزمة المنهجية أنها ترجع إلى غياب الوعي بوظيفة التاريخ، ونقص ثقافة المؤرخ، واختلاط المفاهيم عنده، وسوء التقدير لأدوات الكتابة التاريخية. وما يثير الدهشة حقًا أنه بعد أكثر من ربع قرن على كتابة تلك المقالات والبحوث التي خلفها رؤوف عباس، لا تزال الكتابة التاريخية عندنا تعاني من هذه الأدواء نفسها.
وأحسب أن هذا التشخيص للأزمة المنهجية إنما يقدم لنا نموذجًا عمليًّا لأهمية الممارسة النقدية؛ بقصد نشر ثقافة تقويم مسار الفكر التاريخي في تجربتنا الراهنة، من فترة إلى أخرى، واستمرارية المتابعة والتجاوب مع كل جديد يُنتج في حقل منهجيات العلوم الاجتماعية التي لا يمكن عزل التاريخ (كعلم ومعرفة) عن التعاطي مع إنجازاتها الفكرية والفلسفية والمنهجية. ولا يزال المرء منا ينتظر الوقت الذي تشيع فيه ثقافة قبول النقد الموضوعي المتسمة بالجرأة والابتكار، وأن تتحول إلى عدوى حميدة واسعة الانتشار بما يخلق مجالاً مستقلاً لفن المراجعات النقدية التي تعالج أوجه القصور المنهجية السائدة في كتابتنا التاريخية.
المصادر
- بيتر جران: دنيا المؤرخين في الستينيات إشارة إلى الدراسات المبكرة لرؤوف عباس، منشورًا في «رؤوف عباس :المؤرخ والإنسان»، إعداد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، الطبعة الأولى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2010، [ص 33 - 38].
- رؤوف عباس: ملاحظات منهجية حول كتابة تاريخ مصر، مجلة فكر، العدد رقم 6، يونيو 1985، [ص 111 – 118].
رؤوف عباس: أزمة الكتابة التاريخية في مصر: تضخم في الإنتاج وضآلة في المعرفة، مجلة الكتب، وجهات نظر، 1999.
- رؤوف عباس: التاريخ والمستقبل، مجلة الهلال، يناير 2002، [ص 128 -135].
- رؤوف عباس: الفرضية في البحث التاريخي، مقال منشور في كتاب: ثقافة النخبة وثقافة العامة في مصر في العصر العثماني، تحرير ناصر أحمد إبراهيم، مركز البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة، مايو 2008، [ص 65 -70].
- رؤوف عباس: دراسات الملكية وإشكالية تفسير تاريخنا الاجتماعي، مجلة كلية الآداب – جامعة القاهرة، المجلد 58، العدد 2، أبريل 1998.
- عاصم الدسوقي: ابن جيل الستينيات الذي وعى التاريخ الاجتماعي، منشور في «رؤوف عباس :المؤرخ والإنسان»، إعداد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، الطبعة الأولى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2010، [ص 21- 32].
- ناصر أحمد إبراهيم: نقد الاستشراق في فكر رؤوف عباس، منشورًا في: رؤوف عباس «المؤرخ والإنسان «، إعداد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، الطبعة الأولى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2010، [ص 89 – 99].
- ناصر أحمد إبراهيم: الترجمة والمشروع الفكري عند رؤوف عباس، منشورًا في: رؤوف عباس «المؤرخ والإنسان»، إعداد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، الطبعة الأولى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2010، [ص 137 - 151].
- ناصر أحمد إبراهيم (إعداد وتحرير): كتابة تاريخ مصر إلى أين؟ أزمة المنهج ورؤى نقدية، مقالات مجمعة من تأليف رؤوف عباس، الإصدار رقم 76، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة 2009.
ترشيحاتنا