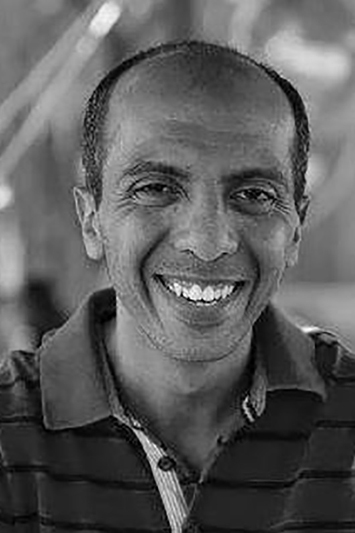رؤى
محمد جادالتجـارة.. مرآة حال الاقتصاد تحت سياسات الإصلاح
2021.06.01
التجـارة.. مرآة حال الاقتصاد تحت سياسات الإصلاح
شرعت مصر منذ ٢٠١٦ في تطبيق (إصلاحات) صندوق النقد الاقتصادية ولديها عجز في ميزان المدفوعات بـ ٢.٨ مليار دولار، وأنهت العام المالي ٢٠٢٠ وقد تفاقم العجز لديها إلى ٨.٥ مليار دولار. لا شك أن أزمة كورونا كان لها دور في تضخيم عجز الميزان المصري خلال هذه الفترة، ولكن أيضا هشاشة (إصلاحات) الصندوق وتركيزه على الإصلاحات المالية بدلاً من دعم الجانب الإنتاجي في الاقتصاد المصري، كان له دور بارز في استمرار الموازين المصرية في منطقة العجز.
لماذا نهتم بميزان المدفوعات؟
يمثل ميزان المدفوعات الحصيلة النهائية لتعاملات البلاد من النقد الأجنبي، بمعنى أنه يحسب ما يتدفق داخل البلاد من هذا النقد، سواء في صورة حصيلة الصادرات أو إيرادات سياحة وغيرها من الموارد، ويخصم منه ما تدفق من نقد أجنبي للخارج على مجالات مثل الاستيراد وسداد مستحقات الأجانب، ويحسب الرقم صافي الفارق بين هذين النوعين من المعاملات.
وإذا انتهى صافي تعاملات ميزان المدفوعات إلى عجز كبير فهذا يعني أن البلد يواجه صعوبات في تدبير العملة الصعبة، وهو الوضع الذي من المفترض نظريًّا أن صندوق النقد يساعد البلدان على تجنبه من خلال السياسات التي ينصح بها. ولكي نفهم بشكل أعمق طبيعة الضغوط التي تواجه مصر نحتاج إلى نظرة أقرب لتكوين ميزان المدفوعات. قبل أن نبحر في هذا الميزان من الضروري أن ننوه إلى ما نقصده بسياسات (الإصلاح) في هذا المقال، وهو حزمة من السياسات النقدية والمالية بالأساس تبنتها مصر منذ نوفمبر ٢٠١٦، بعد أزمة عنيفة واجهتها بشأن شح موارد النقد الأجنبي، وهذه السياسات (الإصلاحية) جاءت بدفع من صندوق النقد الدولي الذي منح مصر قرضًا كبيرا في هذا الوقت، ووجهت انتقادات عدة للصندوق نظرًا إلى أن مفهومه عن الإصلاح الاقتصادي يركز على إجراءات نقدية مثل تعويم الجنيه أو مالية مثل ضريبة القيمة المضافة، ولا يقدم إسهامات في إصلاح الاقتصاد الإنتاجي بنفس الوزن.
بالعودة إلى ميزان المدفوعات، يتكون الحساب الإجمالي لهذا الميزان من عدة موازين فرعية، أحدهم يرتبط بشكل مباشر بالسياسات الإنتاجية للبلاد وهو الميزان التجاري، الذي يرصد الفارق بين الصادرات السلعية للبلاد ووارداتها.
لو نظرنا إلى ميزاننا التجاري منذ بداية (إصلاحات) الصندوق أي في العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧ وحتى العام المالي الأخير سنجد أنه لم يتغير تقريبًا، يدور حول عجز بين ٣٦ و٣٨ مليار دولار، أي أن سياساتنا الإنتاجية تحت سياسات الإصلاح محلك سر. لكن هناك ميزان آخر يستطيع صناع القرار أن يتحكموا فيه بشكل أكثر مرونة وهو الميزان المالي، وذلك لأن هذا الميزان يضم التعاملات الخاصة بسياسات الدولة للاستدانة من الأجانب، وقد زاد فائض هذا الميزان بقوة خلال السنوات التالية للتعويم، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بقوة خلال هذه الفترة، وهوما دفع الأجانب للإقبال بقوة على الاستثمار في هذه الأذون بحثًا عن هذا العائد السخي.
وكما يظهر في الشكل التالي؛ في وقت من الأوقات كان إجمالي ما نصدره من إنتاج ماكيناتنا الصناعية الضخمة وحصاد مساحات شاسعة من مزارعنا يقارب قيمة صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في عمليات شراء وبيع على أوراق مالية في مصر (ومن ضمنها الأوراق الخاصة بالديون) وهم قابعون خلف شاشات الحواسب في أبراج زجاجية.
ما يعيب هذا الميزان المالي أنه سريع التقلب خاصة في وقت الأزمات، فقد تعرضنا لصدمة قوية خلال العام المالي الأخير الذي تخللته أزمة الكورونا، مع خروج الأجانب بقوة من استثمارات الأذون، كما يظهر من الشكل السابق الذي يرصد تحول صافي تعاملات الاستثمار في محفظة الأوراق المالية من الفائض إلى العجز بشكل سريع وعنيف. تُظهر الأزمات إذن ميزة أن تكون تدفقات النقد الأجنبي مبنية على أسس أكثر متانة مثل النفاذ بالمنتجات عالية القيمة لأسواق التصدير، والنجاح في تحقيق ذلك هو ما يمكننا أن نطلق عليه فعلا (إصلاح اقتصادي).
هل كان ميزاننا التجاري قادرًا على إغاثتنا من أزمة كورونا؟
الواقع أن التجارة العالمية في مجملها تراجعت خلال أزمة كورونا، لكن حركة التصدير والاستيراد لم تتوقف، لقد استطاعت البلدان صاحبة الصادرات عالية التكنولوجيا والأكثر تنوعًا أن تجد لنفسها فرصة لجني الإيرادات الأجنبية في ظل هذه الأزمة، بالنظر إلى أن صادرات الأدوية نمت بشكل هائل خلال الفترة الماضية، وكذلك الصادرات المرتبطة بظروف المكوث في المنزل تحت الحظر مثل راوتر الواي فاي واللاب توب وغيرها، بحسب تقرير حديث لمنظمة أونكتاد.
في الحالة المصرية، سنجد أن صادراتنا غير البترولية حققت أداء إيجابيًّا خلال أزمة كورونا، إذ زادت حصيلتها في العام المالي ٢٠٢٠ بنحو مليار دولار، كما أنها ارتفعت منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي بنحو ٥ مليارات دولار.
ولا شك أن وراء هذا الزيادات قصص نجاح لا يسلط عليها الإعلام ضوءًا كافيًا، كما أن ارتفاع قيمة صادراتنا منذ بدء برنامج الصندوق في ٢٠١٦ يعكس استفادة من تعويم الجنيه، إذ يساهم تخفيض العملة المحلية في النزول بسعر المنتج المصري في الأسواق الخارجية مما يجعله أكثر جاذبية للأجانب.
لكن تظل قيمة صادراتنا غير البترولية محدودة للغاية أمام الموارد الأخرى سريعة التقلب والتغير، وهو ما يحد من قدرتها على إغاثتنا في أزمات مثل انسحاب الأجانب من أسواق الديون، أو التراجع المفاجئ لأنشطة خدمية مثل السياحة، مثلما جرى في أزمة كورونا. في مقابل زيادة بمليار واحد من هذه الصادرات كان هناك انخفاض بنحو ٣ مليارات دولار من صادراتنا البترولية في نفس الفترة، انعكاسًا لانخفاض الأسعار العالمية للنفط في ظل أزمة كورونا. كما أن فاتورة وارداتنا الضخمة تسهم بشكل رئيسي في استمرار معاملاتنا التجارية في منطقة العجز، وهي الفاتورة التي تعكس انهزامنا في معركة التصنيع والتقدم، إذ تمثل وارداتنا من السلع الوسيطة نسبة مهمة من هذه الفاتورة.
ومن حسن الحظ أن العجز التجاري المحقق في ٢٠٢٠ جاء في وقت نتمتع فيه بوفرة من إنتاج الغاز، وهو ما أسهم في الحد من فاتورة الواردات، ولكن علينا أن نتذكر أن هذه الموارد النفطية ستنضب في المستقبل.
كيف يعوض الاقتصاد عجزه عن التصدير؟
عندما يعجز الاقتصاد الإنتاجي عن توليد العملة الصعبة بكميات كافية، فلا مجال لتعويض هذا النقص إلا من خلال الديون. وربما تكون أزمة كورونا أفضل شاهد على ذلك. لقد احتاجت مصر لقرضين جدد من صندوق النقد بعد أشهر قليلة من انتهاء برنامج الإصلاح، بقيمة ٢.٨ مليار دولار و٥.٢ مليار دولار، بالإضافة لتنفيذ طرح ضخم من السندات الدولارية في الأسواق الخارجية في مايو الماضي، وغيرها من أشكال الاستدانة. وتعرض دراسة حديثة لمبادرة الإصلاح العربي رصدًا مهما لأحوال الاقتصاد المصري خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا، تعكس كيف ساهم الاعتماد فقط على سياسات الصندوق في دفعنا نحو المزيد من الاقتراض.
تذكر الدراسة "لم يكن اعتماد مصر على العائدات الخارجيّة الهشّة أعلى في أيّ وقتٍ مضى منه اليوم. ففي عام ٢٠١٩، احتاجَت البلاد إلى جمع حوالي ١٠٠ مليار دولار لتلبية احتياجاتها من العملة الأجنبيّة؛ من أجل استيراد السلع الاستهلاكيّة والخدمات الخارجيّة التي تعتمد عليها (بقيمة ٧٠ مليار دولار)، ومن أجل دفع فوائد ديونها الخارجيّة. غير أنّه بعد عقود من الإصلاحات الداعمة للسوق، وبعد عمليّة خفض كبير للعملة عام ٢٠١٦ بنسبة ٥٠٪، استطاعَت مصر تصدير سِلَع بقيمة ٣٠ مليار دولار فقط (منها نحو ١٠ مليارات من الغاز الطبيعيّ؛ إذ صارت البلاد من مصدّري النفط والغاز في أواخر عام ٢٠١٨)". وعن التوسع في الاستدانة الدولية خلال أزمة كورونا تقول المبادرة "زادَت هذه القروض الجديدة إلى الدين العامّ المتنامي بسرعة فعليًّا، ممّا أثار نُذُر الخطر بشأن استدامته. فمنذ عام ٢٠١٢، نما الدين العام بشكلٍ أسرع من الاقتصاد المصري نفسه، وقد وصل الآن إلى أكثر من ٩٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأغلبُ الدين العام أساسًا دَين محلي، ولكن الجزء الخارجي منه قد نما بسرعة، وتجاوز الآن ٢٠٠٪ من صادرات السلع والخدمات".
لماذا عجزنا عن تنمية صادراتنا؟
يرى البنك الدولي أن تجربة تعويم الجنيه خير شاهد على وجود مشكلة عميقة في نظامنا الإنتاجي، فقد واكب التعويم فترة رواج في التجارة العالمية، وكانت لدينا ميزة انخفاض العملة المحلية، ولكن بحسب تقديرات البنك فإن النمو الذي حققناه في هذه الفترة أقل مما حققته دول مرت بظروف مشابهة. وأرجع البنك ذلك، في تقريره عن رصد الاقتصاد المصري في ٢٠١٩، لوجود عيوب في نظامنا الإنتاجي، وهي العيوب التي لو كنا عالجناها ربما كنا استطعنا رفع صادراتنا بشكل أكبر خلال أزمة كورونا، وقللنا من احتياجنا للاقتراض الخارجي.
تتلخص المشكلات التي يعرضها البنك في عدم وجود رؤية واضحة لتوجيه منظومتنا الإنتاجية نحو تعظيم عوائد التصدير، على سبيل المثال هناك منتجات لدينا فيها قدرة تنافسية عالية مثل صناعة السجاد ولكن نسبتها محدودة من مجمل الصادرات. أو أننا لا نقدر على المنافسة في صناعات يتزايد عليها الطلب العالمي بقوة مثل الأدوية، هذا بجانب تركيزنا على صادرات من المواد الخام مثل النفط أو السلع البسيطة وليس مرتفعة التكنولوجيا، واهتمامنا بالأسواق التقليدية مثل السوق الأوروبي وعدم اهتمامنا بشكل كافٍ بأسواق جديدة. وتتسق بياناتنا التصديرية إلى حد كبير مع تحليل البنك الدولي، بداية فإن الجزء الأكبر من إيرادات الصادرات غير البترولية يأتي من السلع تامة الصنع خاصة عالية التكنولوجيا منها وهو ما يعكس أهمية الاستثمار في تعميق الصناعة والإنفاق على البحث العلمي. لكن الصادرات تامة الصنع نمت بشكل محدود خلال الفترة التالية للتعويم، وهو ما يُظهر أن إجراءات نقدية مثل تخفيض العملة التي يضعها الصندوق على رأس أولوياته ليست هي لب الإصلاح، ولكن لو اهتمت الدولة بالبحث في كيفية تعزيز تنافسية هذه الصناعات كان من الممكن أن حقق إيرادات دولارية أكبر.
وفي العام المالي الذي تخللته أزمة كورونا، ٢٠٢٠، تراجعت صادرات العديد من منتجاتنا تامة الصنع، وهو ما قد يعزى إلى ضعف الطلب في بعض الأسواق الخارجية، ولكن قد يكون هذا التراجع أيضًا بسبب عدم قدرة مصنعينا على استيراد مدخلات إنتاج من دول أخرى تفشى فيها الوباء وتعطلت فيها حركة التصنيع، وإذا كان الأخير هو السبب فإن ذلك يدعونا للعمل على تعميق صناعاتنا المحلية وتحفيز إنتاج السلع الوسيطة التي نستوردها من الخارج. وأخيرًا فقد استفادت فعلا صناعة الأدوية من أزمة كورونا كما يتضح من نمو قيمة صادراتها، وزادت أيضًا صادرات السجاد التي يقول البنك الدولي أن لدينا ميزة تنافسية قوية فيها، لكن هاتين الصناعتين يمثلان نسبة هامشية من مجمل صادراتنا تامة الصنع، وهو ما يعكس الخلل في أولويات الإنتاج الذي يحذر منه البنك.
من المهم أن نشير في مجال حديثنا عن إصلاح قطاع الإنتاج من أجل التصدير إلى التطور الأخير الذي طرأ على نظام دعم الصادرات في ٢٠١٩، والذي جاء بعد حوارات موسعة مع مجتمع الأعمال من أجل الوصول لصيغة أفضل لهذا النظام من الدعم تحقق أهداف تعميق الصناعة وتحفيز الصادرات. وربما تكشف السنوات القادمة بصورة أوضح إن كانت الصيغة الجديدة للبرنامج قد أسهمت فعلاً في تحقيق إصلاح على أرض الواقع أم قوضها سوء الإدارة والفساد.
ترشيحاتنا