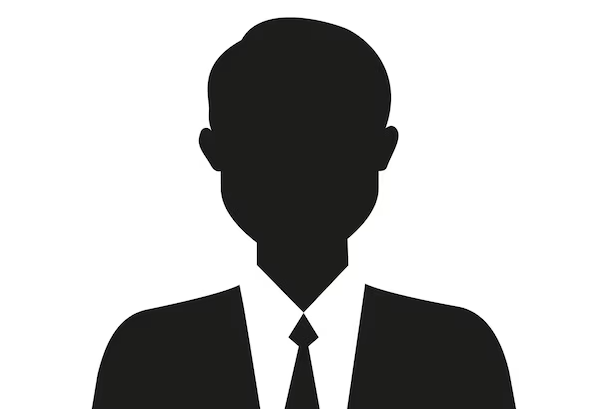عدد 10/11-100 سنة على ثورة 1919
بيتر جرانالدراسات الأمريكية حول ثورة 1919.. منظور تاريخي
2019.05.01
ترجمة: مروة الناعم
مراجعة: عادل عبد اللطيف
الدراسات الأمريكية حول ثورة 1919.. منظور تاريخي
شكَّلت ثورة 1919 حدثا جللًا في التاريخ الحديث؛ إذ هزت الامبراطورية البريطانية التي كانت واحدة من القنوات الرئيسية للاستثمار الأوروبي الأمريكي. ولم يرد الكثير بشأن هذا الحدث في الدراسات الأمريكية لأسباب تقتضي البحث والاستقصاء.
يتطرق هذا المقال لموضوع 1919 كما تناولته المدارس الفكرية الأمريكية في الفترات الرئيسية لدراسة مصر الحديثة، ويخلص إلى أن أحد أسباب ضعف اهتمام المدرسة الأمريكية يتعلق بالنسق المعرفي المُختار؛ أعني البارادايم الأرسطي . فلطالما افترض العلماء الأمريكيون المهتمون بدراسة مصر الحديثة بأن مصر كانت ديكتاتورية شرقية. وباتباع بارادايم الاستبداد الشرقي، ينتفي وجود أي إمكانية للثورة، وذلك لعدم وجود إمكان لتسيس طبقة الفلاحين، أو حتى جماهير الحضر ومشاركتهم في المجال السياسي بمفردهم. قد تكون هناك بعض الحالات التي اتبع الفلاحون أوامر ملاك الأراضي وارتكبوا بعض الأفعال، إلا أن هذا هو أقصى ما آلت إليه الأمور. ربما يفسر هذا كيف يتم التعامل مع أحداث عام 1882 و1919 و1952 و2011 حتى الآن في المدرسة الأمريكية باعتبارها سلسلة من الانقلابات. فقد افترض الدارسون أن كل هذه الأحداث قادتها بالضرورة عناصر من الطبقة الحاكمة؛ ونتيجة لذلك، لم تكن، بحكم التعريف، ثورات على الإطلاق.
ومع ذلك، فبإمعان النظر في كيفية استخدام الدارسين الأمريكيين والأنجلو أمريكيين لنموذج الاستبداد الشرقي في الممارسة العملية خلال القرن الماضي، تنكشف بعض التطورات. ولهذا السبب، تم اعتماد نهج تاريخي لدراسة موضوع 1919.
ولاتباع النهج التاريخي، سوف نبدأ من القرن التاسع عشر. ففي القرن التاسع عشر، يبدو أن مجال الدراسات المصرية الحديثة في الولايات المتحدة كانت موضوعًا يجمع بين شتى مناحي علوم الآثار التوراتية والعمل التبشيري والعلاقات الخارجية.
اعتقد الأمريكيون أن مصر الحديثة كانت امتدادًا لمصر الفرعونية، وهذا ما ألفوه من خلال قراءتهم في الكتاب المقدس، وإلمامهم بشكل خاص بالرواية التوراتية لسفر الخروج. وبشكل عام، كانت هذه الرواية المستقاة من العهد القديم تفهم بإحدى طريقتين. وهنا لا يواجه المرء صراعًا وحسب، أو صراعًا دينيًّا فقط، بل يواجه صراعًا ذا طابع سياسي أيضًا. استندت إحدى طرق فهم مصر على فهم النبي موسى رمزًا للتحرير العالمي؛ فهو شخص تزعم العبيد وقادهم نحو الحرية. وقد لاقت هذه الرؤية قبولًا واسعًا في قلب الثقافة الأمريكية، وكذلك بين الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية. أما الطريقة الأخرى التي فهم بها النبي موسى فقد كانت باعتباره شخصًا قاد شعبه إلى الأرض المختارة، لأنها إرادة الله، ولو تضمن ذلك مقتل العديد من المصريين الأبرياء وقت فيضان البحر الأحمر. فكانت فكرة «إرادة الله» تلك، وما تضمنته من سياسات توسعّية وكوارث تابعة، التي راقت للنخبة الأنجلو سكسونية البيضاء على الساحل الشرقي، والذين ما إن أصبحت لهم اليد العليا في الصراعات القطاعية the sectional conflicts الدائرة حول أوضاع العبيد حتى تواصلوا مع الإمبرياليين البريطانيين. كانت تلك هي المجموعة التي تبنت عمل اللورد كرومر «مصر الحديثة (1908)» واعتبرته عملًا تأسيسيًّا في هذا المجال.
ولرؤية هذا الموضوع من الزاوية الصحيحة، ينبغي للمرء أن يضع في اعتباره أن معظم الأمريكيين كانوا وربما لا يزالون انعزاليين. ونتيجة لذلك، فقد كانوا على الجانب الخاسر مما يسمى الصراعات القطاعية- أو على الأقل حتى سنوات حكم ترامب. ففي تلك الأيام، لم يدعم الأمريكيون، على أي حال، التوسع الإمبريالي؛ مما قد يفسر لجوء الإمبرياليين من أقطاب شركات النفط وكبار المبشرين والشخصيات البحرية إلى نظرائهم البريطانيين من أجل الدعم.
ظهرت المدرسة الأمريكية المعنية بدراسة مصر الحديثة- التي سنتعرف إليها اليوم-باختصار، في خضم الصراعات القطاعية داخل الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر كجزء من الصراعات الدائرة حول السياسة الخارجية والتعليم العالي والعلمانية وغيرها من القضايا. فاصطف الساحل الشرقي الإمبريالي الذي كان، وأكرر هنا، الطرف المنتصر في الصراع إلى جانب المملكة البريطانية. ونتيجة لذلك، لم تتبلور دراسة مصر الحديثة باعتبارها حقلًا علميًّا أمريكيًا بل باعتبارها حقلًا علميًّا انجلو-أمريكيًا.
وانطلاقا من منظور الساحل الشرقي المنتصر هذا، يمكننا التعرف على ثلاثة مراحل رئيسية في علم التأريخ الأمريكي أو الأنجلو-أمريكي لمصر الحديثة، والذي تبع كل منها رؤية محددة لثورة 1919. وتقدم هذه الورقة البحثية استعراضًا موجزًا للأعمال النموذجية التي تناولت ثورة 1919 في هذه الفترات الثلاث.
هذه الفترات الثلاث هي: الأولى، وهي فترة ذروة الاستعمار البريطاني التي تبدأ من أواخر القرن التاسع عشر وحتى أربعينيات القرن العشرين، والثانية، هي فترة ثورة التنمية والتي امتدت من أربعينيات القرن العشرين حتى سبعينياته، والثالثة هي فترة العولمة الممتدة من سبعينيات القرن العشرين حتى وقتنا الحالي. وبالنظر إلى عدم تناول الكثير من هذا الإنتاج التأريخي في أي دراسة منهجية لأسباب ما، فإن ما يلي سيكون بالضرورة وصفًا عامًا للغاية.(2)
المرحلة الأولى: ذروة الاستعمار
اعتمد الأمريكيون المهتمون بدراسة مصر الحديثة، في الفترة ما بين تسعينيات القرن التاسع عشر وحتى أربعينيات القرن العشرين، في المجمل وإلى حد كبير، على كتب كتبها مسؤولون استعماريون بريطانيون، وإلى حد أقل بكثير، على حفنة من المنشورات التي كتبها مبشرون، ككتاب تشارلز ر. واطسون « مصر والحملة الصليبية» على سبيل المثال. (فيلادلفيا، 1907) ، وفي مرحلة ما أو أخرى، كان هناك سوء فهم بأن توجه الرئيس وودرو ويلسون الدولي، كما عبر عنه في نقاطه الأربع عشرة عند نهاية الحرب العالمية الأولى، قد أشار إلى نوع مختلف من التورط أو الارتباط الأمريكي بالعالم الاستعماري. وهذا ما ذهب حزب الوفد المصري من بين آخرين عام 1919 لاستخلاصه؛ بأن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق. إذ لم يكن للولايات المتحدة في تلك الفترة أي مصلحة في إثارة الإمبراطورية البريطانية. وهذا ما يفسر امتداد تلك المرحلة من تسعينيات القرن التاسع عشر حتى أربعينيات القرن العشرين وليس حتى عام 1919.
في مرحلة ما أو أخرى، كان هناك ذلك الالتباس حول معارضة الدارسين الأمريكيين للثورة، ومن ثم، لم يرد أمر يذكر في هذا الصدد في دراسة مصر. وهذا ما أتشكك في صحته أيضًا. فقد طرحت الدراسات الأمريكية لجنوب شرق آسيا فكرة «أسلحة الضعفاء». واهتمت الدراسات الأمريكية لجنوب آسيا بل وشاركت في تطوير «دراسات التابع» حتى عندما اتسمت بالماوية. كما تناولت الدراسات الأمريكية لأفريقيا، وعلى نحو منتظم، فكرة التحرر الأفريقي باعتبارها فكرة جذرية رئيسية. بينما تعكس دراستها لمصر، على النقيض من ذلك، عدم وجود فاعل تاريخي لطبقة الفلاحين والطبقات الدنيا بشكل عام.
وإذا أخذنا في الاعتبار الفترة ما بين عامي 1890 و1940، فما النصوص المؤسسة التي أثَّرت على الفكر الأمريكي حول مصر عام 1919!
لم يكن هناك قدر كاف من الاهتمام بهذا الموضوع بحسب ما أشار إليه المؤرخ الأمريكي آرثر جولدشميت في العمل المذكور سابقًا، وحتى في الكتابات الإنجليزية التي تناولت تلك الفترة. إلى أن تمكن جولدشميت من الوقوف على كتابين علميين.(3) لذا، يبدو من المنطقي أن ننتقل هنا إلى النظر في هذين العملين البريطانيين بعد التأكد، كما فعلت، من وجود عدد لا بأس به من النسخ في المكتبات الأكاديمية الأمريكية الرئيسية. تشمل الأعمال التي يتعين النظر فيها: كتاب «عبور مصر» لبي.جي. إلجود (لندن، 1928)، وكتاب «مصر» لجورج يونج (نيويورك، 1927). وبالطبع كان من الضروري البحث عن الكتب الأمريكية أو على الأقل المراجع الدورية الأمريكية حول موضوع 1919. بيد أنه لم يظهر أي منها على الفور. فبالمرور سريعًا على فهرس النيويورك تايمز لا نجد سوى تعليق عابر عن ثورة 1919 كُتب بعد سنوات عديدة من الحدث.
في كتابه «عبور مصر»، أكد إلجود على بدائية نظام العدالة في مصر واصفًا فترة 1919 بأنها فترة اضطراب وفوضى غير ضرورية بالأساس، وانتفاضة ناتجة عن هذا النظام. ربما كانت نظرته هذه عن المصريين مستنتجة من ملاحظات عمومية. وعلى النقيض من ذلك، كان يرى البريطانيين على الساحة أناسًا ذوي موهبة وذكاء، إلا انهم قلما امتلكوا المؤهلات المميزة اللازمة لهذا الوضع تحديدًا. ومع ذلك، صنعوا التاريخ. لم يستطع إلجود تصور المصريين كفاعلين تاريخيين. ويظهر هذا القصور في معالجته لموضوع القومية المصرية ولموضوع 1919. كانت القومية المصرية بالنسبة له مفهومة من الناحية النظرية بالنظر إلى ما حققه اللورد كرومر من ازدهار في البلاد، ولكنها لم توجد فعليًّا على المستوى العملي حالما هزم أحمد عرابي. وبقدر ما عادت إلى الحياة، فقد كانت نتيجة لأحداث دنشواي المؤسفة وغير الضرورية، وعلى وجه الخصوص، للعقوبات الغاشمة التي أنزلت عقب تلك الأحداث تطبيقًا للعدالة. في هذه الرواية، اقتصر دور سعد زغلول على دور التابع للورد كرومر خلال سنواته الأخيرة، وعلى كونه شخصًا مجهولًا لولا زواجه من امرأة ارستقراطية.
ينتقل إلجوود بعد ذلك إلى الأسباب قصيرة الأجل لثورة 1919 ليلاحظ أنه مع انتهاء الحرب العالمية الأولى، استمرت الأحكام العرفية والتدابير العسكرية التعسفية على الرغم من ارتفاع حمى القومية التي وصفها بحمى الارتياب. أما الصراع الحقيقي الدامي فقد كان في صعيد مصر. وأما نظام العدالة، الذي رآه متدنيًّا واستهل به حديثه، فقد تم التلاعب به ليتمكن البريطانيون من نصب محاكمهم الخاصة.
نجد أن بي.جي. إلجود قد التحق بالخدمة العسكرية عام 1883 وظل يعمل بالخدمة فعليًّا حتى عام 1903. وبالتالي، فقد كان من جيل اللورد كرومر؛ وقضى حياته المهنية كلها تقريبًان في مصر لتوافيه المنية هناك عام 1941 عن عمر يناهز السابعة والثمانين. وعلى مدار حياته، عمل إلجود مراقبًا عامًا للإمدادات الغذائية (التموين) للحكومة المصرية، وسكرتيرًا ماليًّا للجيش المصري. كما كتب عدة كتب عن مصر تستهدف عامة الجمهور. وهذا على الأقل أمر واضح للغاية. وبإمكاننا اكتشاف المزيد من التفاصيل من خلال نعي زوجته، بونتيه آموس، في صحيفة التايمز اللندنية، إذ يصبح السؤال عن هوية هذا الشخص أقل وضوحًا. فقد ترعرعت زوجته في مصر، ابنة لقاضٍ في المحاكم المختلطة. كانت تتحدث العربية بطلاقة، وأصبحت طبيبة مرموقة؛ وهي احدة من أوائل النساء اللاتي مارسن المهنة، وكانت معلمة، كما أدارت صالونًا بمنزلهما بحي مصر الجديدة حتى وفاة زوجها عام 1941. وفيما يبدو، فقد استمتع المصريون والبريطانيون على حد سواء بهذا الصالون. إذن، هنا، نجد كاتبًا ينشر كتابًا عام 1928 وهو لا يزال متشبثا بذروة الإمبراطورية، ولا يزال ينظر للمصريين وللقومية المصرية باعتبارهما نوعا من الضباب، ومع ذلك، متزوج من إمرأة كان لديها على ما يبدو صلاتٌ واسعة في المجتمع وتدير صالونًا، ولا بد أنها كانت تعرف المزيد.
كان جورج يونج (توفى عام 1952) موظفًا حكوميًّا بريطانيًّا، تمركز في إسطنبول حيث قام بتجميع كتاب مرجعي عن القانون العثماني. ذاع عنه إلمامه بعشرات اللغات وعمله في الشؤون العسكرية والدبلوماسية، ويعكس كتابه عن مصر درجة أعلى بكثير من التقبل لثورة 1919 ولقومية العالم الثالث في العموم. فقد أحاط علما بنمو السكان المصريين، وثرواتهم وبالاقتصاد وبوعي الطبقات بالصراعات السياسية الروسية والتركية، مشيرًا كذلك إلى الأخطاء التي ارتكبها البريطانيون بعدم اتباعهم توصيات السير وينجت بمقابلة بعثة حزب الوفد في لندن. أخطاء، كما كتب، تمثلت باختصار في معاملة مصر كأيرلندا بدلًا من معاملتها كالهند. لقد كان الرفض البريطاني المتشدد هو السبب في دفع الأرستقراطيين المصريين إلى صفوف أنصار زغلول. وسرعان ما قوبل التفوق العسكري البريطاني، على الرغم من الاحتفاء البالغ به آنذاك، بمقاومة سلبية من جانب المصريين الذين جعلوا المفاوضات حول الاستقلال أمرًا حتميًّا. رأى يونج هذا الأمر جزءًا من تاريخ العالم، لكن ليس ذلك الذي يعني بالضرورة نهاية المملكة البريطانية.
ما الذي نجده إذن من رد الفعل الأمريكي على هذه الكتب. يشير البحث في بنك البيانات (جايستور) إلى أنه فيما يتعلق بكتاب يونج، فقد نوهت عنه مجلات التاريخ والعلوم السياسية بإشارات موجزة في ملاحظات ببلوجرافية عن الكتب الجديدة التي تستقبلها. ومع ذلك لم يحظ بمراجعة أو عرض تقليدي. كتب ويليان ل.لانجر، الدارس بجامعة هارفارد، في إحدى هذه الملاحظات بأن كتاب يونج كان بالأحرى مناصرًا للعمال ومناهضًا للاستعمار. إلا إن كتاب إلجود مضى أفضل حالًا.
المرحلة الثانية
تأريخ 1919 خلال ثورة التنمية (1940 – 1970)
في هذه المرحلة، يواجه القارئ فكرة أن المستبد الشرقي ليس مجرد عبء مضنٍ وثقيل من الماضي، بل شخص أو مجموعة من المؤسسات التي يمكنها تطبيق نظرية التحديث إذا ما تم توجيه ذلك. تعتبر ثورة 1919 في هذه المرحلة مجرد جزء من نسيج الماضي. فقد ذكرها بإيجاز كاتب واحد، شخص لم يكن على الإطلاق جزءًا من مدرسة التحديث.
فبينما كانت كُتب تاريخ مصر في أثناء الاستعمال البريطاني على نحو واسع على يد كبار الموظفين البريطانيين، تميزت هذه الفترة بأنها فترة الظهور الأولى لعلماء ودارسي الطبقة الوسطى الأمريكية. وبالنظر إلى مهنة التاريخ في الولايات المتحدة في مجملها، تعد هذه الفترة نقطة تحول رئيسية في تطور المنهج الدراسي، إلا أن الأمر غير مؤكد فيما يتعلق بدراسة مصر الحديثة، فضلًا عن الاستغراق في التحديث.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه الإمبراطورية البريطانية خصوصًا بعد هزيمة حرب السويس، برزت المدرسة الأمريكية في دراسة مصر الحديثة، بل وسيطرت في بعض السياقات المحددة على مذاهب/مدارس اللغة الإنجليزية. أما بالنسبة لدراسة 1919، وأكرر هنا، فقد بقيت إلى حد كبير كما كانت في الفترة السابقة. إذ قدم الصحفيون، في لندن وباريس، وبدرجة أقل في نيويورك، والذين كانوا متعاطفين مع تحرير العالم الثالث، مجموعة واسعة من الأفكار حول موضوع الثورات أكثر مما نوقش هنا، ولكن يبدو أن أعمالهم لم يتم استيعابها في الثقافة الأكاديمية.
نجد أن أقرب الأفكار التي تطرقت لديناميكيات التاريخ المصري إبان 1919 في السياق الأمريكي في تلك الفترة، نجدها في كتابات الدارسة المصرية الأمريكية عفاف لطفي السيد. ففي كتابها تشديد على الدور الذي لعبته الطبقة الحاكمة المصرية، وتصبح صورة الأحداث التي أدت إلى 1919 أكثر تعقيدًا. (4)
المرحلة الثالثة- تأريخ 1919 منذ عام 1970
في الفترة منذ عام 1970، حُمِل الدارسون على تجاوز الدولة القومية. وفي قيامهم بذلك، احتفظوا بافتراض الاستبداد الشرقي، إلا أنهم كتبوا عنه في أثناء متابعتهم لموضوعات أخرى. فقد حدث أن ظهر موضوع 1919 كمكون ثانوي لكتابين مماثلين من هذا القبيل. يتعرض هذا الباب لاثنين من أهم الأعمال التي تلقي بعض الضوء على الموضوع. أول هذه الأعمال كان للمؤرخ الاقتصادي إليس جولدبرج الذي كان ينظر إلى الضغوطات الاقتصادية قصيرة المدى التي تؤثر على قطاعات مختلفة من الريف كوسيلة لتفسير التوقيت والأماكن المختلفة التي شهدت الثورة. أما ثاني هذه الأعمال فهو للمؤرخ الجنساني بيث بارون والذي تناول مسألة «تظاهرة السيدات»(5).
استهل جولدبرج مقاله عن 1919 على النحو التالي «عانت مصر، منذ مارس وحتى أواخر أبريل عام 1919، من واحدة من أكبر تمردات الفلاحين في تاريخها بل وفي القرن العشرين». وبدأ فقرته الثانية «بدأ التمرد/العصيان عندما تم القبض على أربع قيادات من الحركة القومية المصرية في التاسع من مارس عام 1919». إن المكانة المميزة لهاتين العبارتين مع استخدامهما تعابير كـ «عانت» و»تمرد» يضع الدراسة في مكان ما بين السردية البريطانية الاستعمارية وسردية طبقة ملاك الأراضي. بدأت الفقرة الثالثة على المنوال نفسه، مشيرة إلى أن القاهرة كانت معزولة عن الريف لأسابيع. كان مما ادعاه الكاتب في مقاله استنكافه أن الثورة كانت رد فعل لفرض الرأسمالية، أو أن الثورة يمكن فهمها على أنها سلسلة من الاختيارات التي اتخذها الفلاحون. ووجد أن أفضل تفسير أن الثورة كانت نتيجة للتوترات والضغوط والمظالم التي وقعت خلال فترة الحرب العالمية الأولى، والتي لم يتم تسكينها منذ ذلك الحين فصاعدا ولو على المدى القصير. وكان من بين هذه الأمور مسألة نقص المواد الغذائية. فيقدم المقال مظالم الفلاحين حول طلب الحبوب والقطن دليلًا على ذلك. ويستطرد المقال في إشارة، غير منطقية على الإطلاق، إلى وجود نهج استراتيجي معين للأحداث في الريف، والذي استهدف عدد منه منع انتقال الناس والبضائع عبر السكك الحديدية. وهذا قد يوحي بالإشارة إلى وجود درجة من الفاعلية السياسية تنطلق من القاعدة، إلى وجود درجة ما من التنظيم. ولكن يتم استبعاد ذلك؛ إذ يعترف جولدبرج بأن فرضيته تتعارض مع الأدلة التي يمكن استخلاصها من خطاب هذه الفترة والذي كان ولا ريب خطابًا قوميًّا.
يتناول كتاب بيث بارون «مصر امرأةً» موضوع ثورة 1919 باعتباره جزءًا من جدل أوسع حول المرأة والسياسة والسلطة. ولتأريخ ثورة 1919 كجزء من تاريخ الجندر، أمعنت بارون البحث في التطورات التي أفضت إلى تظاهر النساء في هذا الحدث. وتحقيقًا لهذه الغاية، كرست بارون فصلًا كاملًا يعني بمسألة الأوضاع المسبقة التي حولت نساء الطبقة العليا نحو القومية المصرية ونحو دعم ثورة 1919، لتجد أنه ربما كان هذا هو العامل الحاسم في انهيار البيوتات أو الأسر الكبيرة متعددة الأعراق والأجناس ذات النمط العثماني والتي كانت سائدة حتى نهاية القرن التاسع عشر. تضمن هذا، من بين أمور أخرى، وضع حد لتجارة الرقيق، وبداية مرحلة تعليم المرأة، وظهور أيديولوجيات الزواج الأحادي والزواج الرفاقي (زواج العشرة القائم على الاستقلال التام للطرفين ماديًّا وقانونيًّا والحق في تحديد النسل). ويطرح الفصل الثاني، بعد ذلك، نماذج للتذكير المستمر لمسيرة النساء في الدوريات والكتب المصرية على مر السنين، وهو ما تفتقره بوضوح الكتابات الأنجلو سكسونية في هذا الصدد.
وفي الختام، إن ما يظهر لقارئ هذا المقال هو الثمن الباهظ والمستمر الذي يتكبده الدارسون للاحتفاظ بنموذج أو بارادايم الاستبداد الشرقي في دراستهم لمصر، ودراسة ثورة 1919 هي نموذج لذلك.
**الشكر للأستاذة نيلي حنا على التعليقات، يناير 2019
التعليقات الختامية:
1 - يعد آرثر جولدشميت هو الاستثناء الرئيسي، لإعادة التقييم انظر et al.(eds.) Re-Envisioning Egypt 1919-1952 (Cairo: AUC Press, 2005)
إن النهج الأكثر شيوعًا في التأريخ الأمريكي هو وضع التاريخ المصري في سياق تاريخ الشرق الأوسط، انظرZachary Lockman, Field Notes-The Making of Middle East Studies in the United States (Stanford: Stanford University Press, 2016) على سبيل المثال
2-Goldschmidt, op. cit., 467.
3-P.G. Elgood, The Transit of Egypt (London, 1928) chs. 8, 12 (more than 50 copies in US libraries) and George Young, Egypt. (New York, 1927) ch. 8 (more than 50 copies in US libraries).
4-Afaf Lutfi Al-Sayyid, Egypt and Cromer, A Study in Anglo-Egyptian Relations (New York: Praeger, 1968) Epilogue.
5-Ellis Goldberg, “Peasants in Revolt-Egypt 1919” International Journal of Middle East Studies v. 24(1992)261-280; Beth Baron, Egypt as a Woman (Berkeley: U. of California Press, 2005) ch. 5
ترشيحاتنا