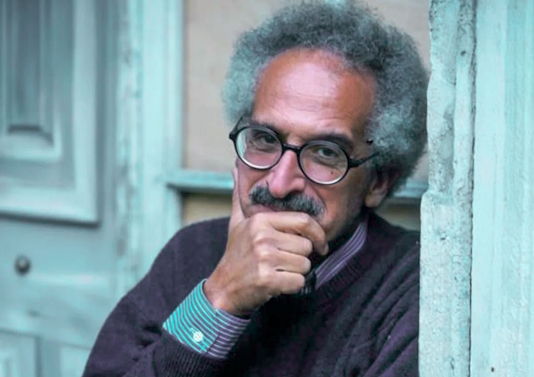اليسار والتنوير
المرايااليسار والتنوير - دعوة للحوار
2024.05.25
مصدر الصورة : آخرون
اليسار والتنوير - دعوة للحوار
في الآونة الأخيرة برز تكوينان على سطح الحياة الثقافية والسياسية المصرية. الأول أسمى نفسه "تكوين" وضم شخصيات "تنويرية" موالية للدولة الحالية، والثاني، الذي أعلن عن نفسه في مواجهة الأول، أسمى نفسه "تحصين" وضم شخصيات "سلفية" موالية هي أيضًا للدولة الحالية.
إذن فنحن نواجه تيارين يتحاربان تحت مظلة الدولة، أحدهما يدعو إلى التنوير، ويدافع عن قيمه، وأهمها بالنسبة إليه: الفصل بين الدين والسياسة (أو بين الدين والدولة)، والآخر يدعو إلى الدولة الإسلامية، التي تستظل بالشريعة الإسلامية كإطار ثقافي وسياسي للمجتمع المصري.
هذا سجال قديم، يتجدد بشكل أو بآخر، وبين الحين والآخر، منذ دخول مصر العصر الحديث، سجال حول "هوية الدولة"، ومنطقها السياسي والاجتماعي.
دعوة
التنوير ليس ظاهرة مصرية بالطبع. التنوير تيار فكري ظهر في أوروبا منذ منتصف القرن السابع عشر وحتى -تقريبًا- أواخر القرن الثامن عشر.
التنويريون المصريون -أغلبهم- يدَّعون أنهم يُعيدون إنتاج التنوير الأوروبي الأول وقيمه العقلانية الداعية إلى إحلال العقل محل الدين في التصرف في شؤون الناس. وعلى هذا فإنهم يرون أنهم يحاربون حربًا حاربها آخرون، من أمثالهم، منذ قرنين أو ثلاثة، وانتصروا فيها، وأنهم، مثلهم، سيخوضون الحرب نفسها وسينتصرون.
هذا، إذا أمعنا النظر، ليس دقيقًا. فحتى من دون تحليل، ليس من المعقول أن حروبنا المعاصرة تطابق حروبًا جرت قبل قرون في ظروف بعيدة أشد البعد عن ظروفنا الحالية.
أما السلفيون، فهم الآخرون يدَّعون أنهم أبناء الماضي ويحاربون للعودة 1400 عام إلى الوراء. وهذا أيضًا محض هراء، فليس من المعقول استعادة مشهد تم في القرون الوسطى إلى قرننا الحالي.
هذه الدعوة إلى الحوار بين المثقفين التقدميين، بتياراتهم المختلفة، تتطلع إلى أن يناقش التقدميون تلك المسألة المركزية في الثقافة والسياسة المصرية من وجهة نظرهم، التي من المفترض أن تكون مختلفة عن التيارين الآخرين (التنويريين والسلفيين).
هذا ليس ترفًا، على الأقل لأنه أثبت أنه كان العنصر الفعال الأول في مسار ومآل الثورة المصرية (2011-2013). فقد ظهر بلا شك أن الانقسام الإسلامي العلماني لعب دورًا محوريًّا في حياة المصريين ومستقبلهم السياسي والاجتماعي. وهذا يوجب على اليسار أن يبحث عن تحليلات وإجابات على أسئلة فرضها العصر علينا.
وفي السطور التالية، ولفتح النقاش، سنطرح بعض الإشكاليات التي يمكن من خلالها بدء الحوار وتطويره لينتج خطابات مختلفة عن الخطابين الآخرين، حتى لو كانت متعارضة وغير متناسقة.
إشكاليات
الإشكالية الأولى: في العقود الأخيرة، وبدعم فكري كبير من حزب التجمع (أكبر أحزاب اليسار)، هاجر قطاع واسع من اليسار من ممارسة السياسة الاقتصادية والاجتماعية (السياسة الطبقية) إلى مواقع التنوير، بل وأحيانًا إلى مواقع التنوير اليميني. ففي أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، غيَّر نفر غير قليل من اليساريين شعاراتهم من الدعوة إلى "العدل والحرية" إلى الدعوة إلى "العقلانية والتنوير". وفي هذا السياق تراجعت مواجهات أغلب اليسار مع الدولة، بل وتحالف معها، لمواجهة الخطر الأكبر: الإسلاميين.
هذه الإشكالية يمكن طرحها كالآتي: إن قطاعًا واسعًا من اليسار لم يرَ غير خيارين: إما الدولة وإما الإسلاميين، واختار الأولى ليتحالف معها.
هذا قطعًا انتحار لليسار. وقد تم هذا بالفعل، وبأسوأ الصور في حزب التجمع، الذي جر وراءه يساريين كثيرين آخرين كانوا في ماضٍ غير بعيد ينتمون إلى تنظيمات الشيوعية السرية.
كيف يحارب اليسار الإسلاميين دون أن يرتمي في أحضان الدولة؟ أصبح سؤالًا مطروحًا، وبقوة، منذ الثمانينيات، ساعة أن أعلن رفعت سعيد نظريته عن "تخفيض الأَسقُف". وهو سؤال محوري، يتطلب، من وجهة نظرنا، تحليلًا اجتماعيًّا وطبقيًّا، ورؤية جديدة (نقدية) للتنوير، حتى يستطيع اليسار أن يختط لنفسه مسارًا ممايزًا -وطبعًا مخالفًا- للدولة وسياساتها النيوليبرالية.
الإشكالية الثانية: على المستوى النظري، ومن وجهة نظر التحليل الأيديولوجي، يرجع هذا التراجع لليسار في اتجاه التحالف مع الدولة إلى نظريته: أنه يستكمل معركة انتصر فيها آخرون في بلدان أخرى كثيرة، بتعبير آخر: يرجع إلى اعتبار تنوير القرن الثامن عشر مساويًا لتنوير القرن الحادي والعشرين.
هذا، في وجهة نظرنا، ليس صحيحًا على الإطلاق، من نواحٍ عدة. أولها أن حتى تنوير القرن الثامن عشر ليس تنويرًا واحدًا، فروسو ليس ديدرو أو فولتير. هناك تنويريون رأوا في التنوير -مثلًا جان جاك روسو- جزءًا من مشروع متكامل من أجل مجتمع عادل وحر. وهناك تنويريون آخرون رأوا في التنوير مشروعًا يتطلب، من ضمن ما يتطلب، الحفاظ على التراتبية الاجتماعية السائدة بما تتضمنه من لامساواة وظلم.
كذلك، فقد خاض كارل ماركس (أبو الشيوعية الحديثة) حربًا ضروسًا ضد التنوير، ذلك ببساطة لأنه كان يرى مشروع التنوير معارضًا للأسس الفكرية لمشروعه. ظهر ذلك عندما انقسم الهيجيليون (تلامذة هيجل الفكريون) إلى يمين ويسار في النصف الأول من القرن التاسع العشر. وقد كان ماركس بالطبع من اليسار الهيجلي، الذي يهزأ بالأفكار التنويرية اليمينية أو المثالية. ماركس هو بالتحديد ما بعد تنويري؛ أصر على أن تغيير عقول الناس بنقد الدين نقدًا جذريًّا، لن يغير شيئًا، بل إن أصل العلة هي في تكوين المجتمع المدني وعلاقته بالدولة، بتعبير آخر: إن أصل العلة هي في الرأسمالية، وحلها في النضال ضدها.
الناحية الثانية أن تنوير القرن الثامن عشر، في أغلبه، أتى مع بدايات ظهور طبقات جديدة خارجة "عضويًّا" من قلب المجتمع، طبقات تطلب، لمصالحها الطبقية، التحرر من الكنيسة، وبناء مجتمع يقوم على الفردانية والعقلانية وعلى دور محدد، جديد، للدولة التي ينبغي أن تصبح راعيًا لحقوق البرجوازية الصاعدة.
أما تنويرنا، فقد هبط من أعلى إلى أسفل. فبعد قرنين من التطور البرجوازي الأوروبي، ومع بدايات تحول البرجوازيات الأوروبية إلى التوسع خارجًا، رأى حكام إمبراطوريات ما قبل الرأسمالية (ومنها الإمبراطورية العثمانية) أن التحديث ضرورة لا محالة لصد هجمات البرجوازية الصاعدة في أوروبا.
هنا نحن نتحدث عن حاكم مطلق ما قبل رأسمالي، يقوم بعملية تحديث للحفاظ على سلطته ما قبل الرأسمالية. وقد كان لهذه العملية آثارها المركبة التي ستتجاوز أغراض هذا الحاكم على مدى الزمن.
هذا النوع من التنوير الفوقي، غير المقترن بثورة اجتماعية، النامي في أحضان الدولة، له معانٍ وأغراض وآثار مختلفة تمام الاختلاف عن التنوير الغربي.
السؤال هنا: ما هو تنويرنا إذًا؟ كيف نفهمه ونضعه في سياقه الاجتماعي والسياسي؟ وكيف نتعامل معه كيسار؟ وهل نحن تنويريون أصلًا أم -كما ماركس- مابعد تنويريين لا بد أن ننظر للتنوير نظرة نقدية؟
الإشكالية الثالثة: وهي استنتاج مباشر من تحليل الإشكالية الثانية، هي أن تنويرنا لم يكن فقط -كبعض الحالات في أوروبا- يمينيًّا، على ارتباط بمصالح طبقة صاعدة عضويًّا تريد أن تعيد صياغة المجتمع (اجتماعيًّا وسياسيًّا وفكريًّا) على صورتها ولمصلحتها، بل إن تنويرنا كان في مرحلته الأولى دولتيًّا بشكل مباشر (مشروع محمد علي في سنواته الأولى وإرساله البعثات العلمية إلى الخارج لغرض بناء جيش قوي قادر على وراثة دولة الخلافة في إسطنبول).
ورغم أن محاولات الإصلاح الديني في مصر الخارجة من عُب الدولة انفصلت بعض الشيء عن السلطة بعد برهة قليلة من الزمن، حتى أن كثيرًا من قادة الإصلاح الديني، وعلى رأسهم الشيخ محمد عبده، شاركوا في ثورة عرابي (حتى لو في جناحها اليميني) بهمة ونشاط - فإن التطورات اللاحقة، وأهمها خلق الدولة لنواة طبقة برجوازية بقرار خلق طبقة الأعيان مع إقرار الملكية الخاصة للأرض، نقول إن التطورات اللاحقة جعلت من التنوير -في أغلبه- تابعًا ومنطلقًا من البرجوازية الجديدة.
ولأن البرجوازية المصرية لم تكن ثورية على الإطلاق، بل كان أقصى مداها هو الاستقلال والإصلاح بطرق سلمية تفاوضية، فإن تنويرها كان على صورتها. هنا ظهر تناقض مصري (له مثيله في بلدان كثيرة أخرى) وهو أن طالبي التحديث ورواد التنوير كانوا هم أنفسهم قيادات اليمين البرجوازي الذي انتمى بعضه، مباشرة، إلى أحزاب الأقلية. فأحمد لطفي السيد، وهو رائد التنوير المصري، كان هو الذي بنى حزب الأمة ليعبِّر عن مصالح البرجوازية الكبيرة. وكذلك طه حسين الذي عادى الوفد والتيارات اليسارية المختلفة. وهلم جرًّا.
بل والأنكى أن أشهر الاشتراكيين المصريين، الذين كان من المفترض أن يكون تنويرهم على أقصى درجة من الجذرية (سلامة موسى) كان فابيًّا إصلاحيًّا هو الآخر، ناهيك عن ضآلة أعداد تابعيه في الشارع.
إذن فالتنوير المصري، على الأقل منذ ما بعد ثورة عرابي، اختط لنفسه طريقًا يمينيًّا، يريد استقلالًا مبنيًّا على التفاوض ودستورًا يحمي الملكية الخاصة.
فأصبحنا واقعين بين شقي الرحى: تنويريين تحديثيين يطرحون تنويرهم من مواقع برجوازية قلبًا وقالبًا (طلعت حرب كان من ضمن هؤلاء التنويريين، وهو في الوقت نفسه يمتص دماء عماله ويستغلهم أبشع استغلال) ويتساهلون مع الدولة وينظرون غربًا إلى الاستعمار بتوقير واحترام، وتيارات أخرى، قويت بعد أن وضح أن ثورة 1919 لم تفِ بوعودها كاملة، وبالطبع لم تنجز معظم مهام الثورة البرجوازية من طرد للاستعمار وإصلاح زراعي وغيرها.
تلك التيارات الأخرى اعتبرت التنوير جزءًا من مشروع استعماري لسلبنا هويتنا الثقافية، وكانت، بالطبع، في أغلبها دينية يمينية محافظة، برزت وانتعشت في الربع الأول من القرن العشرين، حتى أنها كانت تضم (في مجموعها) ملايين من الأعضاء (انظر مثلًا إلى أعداد أعضاء جمعية أنصار السنة المحمدية أو أعداد أعضاء الإخوان المسلمين).
ادعت تلك التيارات أنها تنتمي إلى الماضي وتريد استعادته في صورته النقية (المفترضة من جانبهم)، بينما الحقيقة أن المحافظة الدينية، والسلفية المصرية على وجه الخصوص، كانا وما زالا جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الحديث. فهما، في أغلبهم أبناء الطبقات الوسطى ودون الوسطى التي صنعها التحديث على مدار أكثر من قرن.
إذن فالإسلامية السابقة والحالية (ببساطة) ابنة التحديث وليست شيئًا آتيًا من الماضي.
هي تيارات، كما قلنا، ابنة الحاضر تمامًا، صنعها تذمر البرجوازية الصغيرة وقِطاع من البرجوازية الوسطى (خاصة من الآتين من الريف الذين اضطروا إلى الهجرة وإلى "التوهة والضياع" في المدينة بسبب التحديث) مما يطلق عليه الاستعمار الثقافي.
تبنت تلك الطبقات، لحل تذمرها هذا، خطابًا يعود في شكله إلى الماضي، لكنه، في الحقيقة، ينتمي إلى الحاضر وإشكالياته تمام الانتماء. وهذا بالضبط تطبيق لما قاله ماركس من أن كثيرًا من معارك الحاضر تخاض بلغة وأوهام الماضي.
السؤال هنا: كيف نفهم مصطلحات ومفاهيم كالـ"تنوير" و"العقلانية" و"التحديث" و"السلفية" في إطار هذا المسار الخاص للتنوير والسلفية المصرية؟ كيف نحكي حكاية ذلك الصراع شبه الأبدي من وجهة نظر مادية واجتماعية؟ وكيف نتوقف عن إعادة تدوير رواية "أبناء رفاعة العظام" بالقراءة العلمية النقدية للتنوير؟
الإشكالية الرابعة: اليسار نفسه. فلم ينجح اليسار أبدًا (طوال تاريخه المديد) في معركة الهيمنة، سواء في معركة الهيمنة مع التنوير (اليميني في الأغلب)، أو في معركة الهيمنة مع المحافظة الدينية (سواء إخوان مسلمون أو سلفيون). هذا الفشل المقيم طويل المدى (مع انقطاعات قصيرة جدًّا) في بناء يسار له مشروع ثوري قادر على مقارعة (وليس مسالمة) التنوير اليميني والسلفية، هو ابن لرؤى وإستراتيجيات ومواقف اليسار.
هامشية اليسار في المعركة لها طبعًا أسباب موضوعية. لكن الأسباب الذاتية (فكر وإستراتيجيات ومواقف اليسار) لها دور كبير جدًّا. على اليسار أن يسأل نفسه جادًّا: لماذا لم ينجح في جذب قطاع معتبر من البرجوازية الصغيرة، من أبناء المدن، بل أيضًا من أبناء الريف، إليه في مشروع يستجيب لتذمرها المتفجر؟
لنعترف، اليسار المصري هو نفسه سبب معضلة اليسار المصري، اليسار المصري هو نفسه سبب فشله. فهو الذي اختار "الستالينية العالم ثالثية" أولًا كمرجعية، ثم لم يكتفِ بهذا، بل اتجه بعد ذلك إلى مرجعية أقل جذرية وهي التنوير الأوروبي (بالتحديد القطاع اليميني منه).
لهذا فالسؤال هنا: هو أن النقد الذاتي (الثوري والعلمي والموضوعي) الذي ينبغي أن يصبح على قمة أجندة اليسار: لماذا فشلنا؟ كيف نفهم طبائع وأدوار اليسار في تاريخنا السابق ثم في عصرنا الحالي؟ كيف نمتلك الجرأة على إعادة النظر في إستراتيجياتنا ورؤانا الفكرية، والنظر بشكل نقدي لموقف تذيل الدولة السائد حاليًّا، أو موقف الانتقال من اليسار الجذري إلى اليسار الحقوقي (الذي هو إعادة تدوير لليبرالية البرجوازية ذات الوجه الاجتماعي)؟
الإشكالية الخامسة: الناصرية. فقد بدا للبعض في المرحلة الناصرية أن إشكالية الانقسام الإسلامي العلماني قد حلت مرة وإلى الأبد. آنذاك علا صوت "الاشتراكية العربية"، ومشروع الناصرية، حتى غطى على هذا الانقسام بدرجة كبيرة. فقد صمت الإخوان وانتهوا كقوة منظَّمة على الأرض، وكذلك تصالح التنويريون اليمينيون السابقون، وأيضًا تصالح الشيوعيون، مع دولة ناصر، حتى خيل إلى البعض أن الأمر قد استتب وانتهى.
لكننا انتهينا، قبل أكثر من خمسين سنة، وبدءًا من أواخر العهد الناصري، إلى ما هو أسوأ من الانقسام الإسلامي العلماني السابق على الدولة الناصرية.
فشل الناصرية في حل أزمة الانقسام الإسلامي العلماني، بل وتعميقها بعوامل إضافية، أدت إلى انفجار الانقسام مرة أخرى بشكل أكثر مرارة وعمقًا، وهو مسألة تستحق التحليل والفهم.
بعد عبد الناصر، صعدت الحركة الإسلامية صعودًا مدويًا، ونما بداخلها التيار المعادي للدولة، ربما كرد فعل مباشر على الفشل الناصري. لكن مرور خمسين عامًا على الصعود الإسلامي، منهم ثلاثون سنة (الثلاثون سنة الأخيرة) كان فيها الصعود يتسارع ويتسع، يشير إلى أن الفشل الناصري ليس سببًا واحدًا وحيدًا.
فتغيرات التكوين الاجتماعي المصري (تغيير تكوين الطبقة العاملة، صعود الرأسمالية النيوليبرالية)، ومآلات اليسار الستاليني وغير الستاليني على مدى سنوات السبعينيات والثمانينيات، وصعود اليسار الحقوقي في السنوات العشرين الأخيرة، والتغيرات الهائلة التي تحدث في العالم حولنا، وعوامل أخرى كثيرة لها يد قوية في تعزيز الانقسام الإسلامي العلماني.
وهنا أيضًا، على اليسار المناضل أن يجد إجاباته الخاصة، المبنية على قراءة طبقية متأنية، لفشله الذريع في وراثة عبد الناصر.
السؤال هنا: نقد ذاتي يطرح الأسئلة الحرجة بلا وجل: لماذا كان فشل ناصر مدخلًا لتصاعد الانقسام الإسلامي العلماني؟ ماذا كان اليسار يفعل وقتها؟ أين كان؟ ولماذا وكيف غذت التطورات اللاحقة (محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا) نمو هذا الانقسام؟ وكيف أن صعود النيوليبرالية، وهزيمة المعسكر المسمى اشتراكيًّا (زورًا) قد خلقا، متضامنين، عالمًا يحتمل، بل يدعو، إلى تعزيز انقسامات الهوية على الانقسامات الطبقية؟ وما الحل لهذه المعضلة؟
الإشكالية السادسة: الثورة المصرية (2011-2013) ومآلاتها. وهذه أكثر الإشكاليات إيلامًا. فما كان قبل ذلك يُكتب في أوراق أو يُقال على منابر المساجد وفي محافل العلمانيين، أصبح واقعًا. فلقد كان الانقسام الإسلامي العلماني هو الخط الرئيسي في الثورة، ولم ينجح الليبراليون (الحقيقيون) واليساريون (بكل مثالبهم) أن يمثلا خطًّا ثالثًا يُعتد به. فمنذ الاستفتاء على الورقة الدستورية في 2011 وحتى آخر يوم من أيام الثورة، وهذا الانقسام هو الحد الرئيسي الفاصل في الصراع، والصانع الخفي والظاهر للسياسات والتكتيكات.
هذا قطعًا نتيجة لكل ما ذكرناه من مسائل في هذه الورقة. فلأسباب كثيرة، من أهمها أن اليسار لم يذاكر درسه، ولم يؤدِّ واجبه، انتهى الأمر إلى استيلاء هذا الانقسام على المشهد.
لكن الثورة أيضًا أظهرت أشياء أخرى كثيرة. أظهرت مثلًا أن الإسلاميين ليسوا واحدًا (ضمنهم مثلًا: الإخوان المسلمون، ومصر القوية، وحازمون، وحزب النور، وغيرهم). وأظهرت كذلك أن سيولة الوضع أثناء الثورة تسمح بتبديل المواقع وتطوير المواقف.. إلخ.
إذن فدراسة الثورة فرض عين على كل تقدمي من حيث أنها كانت بروفة شديدة الأهمية لما قد يأتي.
الدرس العملي للثورة المصرية ينبغي أن يذاكر بكل عناية. وعلى هذا فإن الأمر يمتد إلى الجذور الفكرية في علاقتها بالمواقع الاجتماعية، بتعبير آخر: إن التطورات الفكرية والسياسية خلال سنتي الثورة، لم تأتِ من فراغ، بل نضجت على مدى زمني طويل، وانفجرت في لحظة مواتية. الدراسة المدققة لكيف توافقت (أو لم تتوافق) الأفكار مع الأفعال، ولكيف تحولت الأفكار إلى حراك جماهيري واسع المدى، وللأصول الاجتماعية للتيارات المختلفة في الثورة - كل هذه الأمور وغيرها طرحتها الثورة المصرية. وحن فقط نحتاج إلى أن نبني على ما طرحه الواقع الثوري، وعلى التطورات الممهدة له، لنصل إلى مفاتيح كثيرة لإشكالية الانقسام العلماني الإسلامي.
لذا فالسؤال هنا: كيف تحولت حروب الكلام إلى حروب شوارع؟ كيف لعب الانقسام الإسلامي العلماني دوره في العملية السياسية على المستوى الاجتماعي الأوسع؟ كيف أن كل هذا له علاقة كبيرة بالتطورات الأيديولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي أتت بها النيوليبرالية في عالمنا؟
***
هذه هي الإشكاليات الست التي رأينا طرحها على الطاولة، فلربما تكون محفزًا على تجديد النقاش حول الانقسام الإسلامي العلماني بطريقة أكثر علمية ونضالية.
هناك بلا شك إشكاليات وقضايا أخرى كثيرة، ولو لم نلمس في هذه الدعوة بعضها أو معظمها، فلكم سيكون تقديرنا لمن يذكرنا بها ويطرحها للمناقشة هنا.
فهذه الورقة ليست تأطيرية للحوار، بل هي محض تحفيزية، ونرجو أن تكون قد أدت مهمتها.
فلنبدأ الحوار، ونصبر بعض الوقت، لتكون رؤانا أكثر عمقًا وفهمًا. فلربما ينتج من هذا تغيرات في المشهد الثقافي السياسي في مصر.
ترشيحاتنا