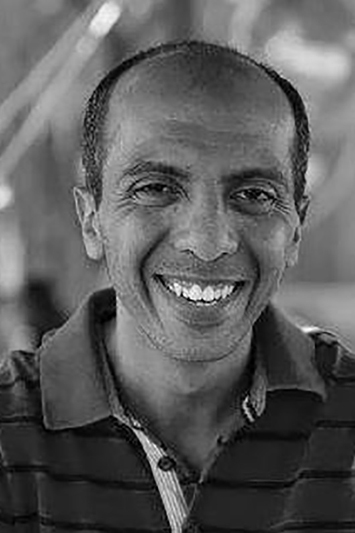رؤى
محمد جادهل يعود طلعت حرب؟
2017.09.12
تصوير آخرون
هل يعود طلعت حرب؟
ولأن شعار «طلعت حرب راجع» يمس وترًا خاصًا، باستثماره لاسم رسخ في السرديات الوطنية التقليدية باعتباره من آباء الصناعة والتحديث في «عصر النهضة المصري»، فلا ينبغي أن ندع الفرقعة الإعلامية، ولا التفاصيل اليومية، ولا هبوط الاهتمام، يشغلونا عن أصل الموضوع. وما هو أصل الموضوع؟ هو الدولة وسياساتها التصنيعية، واستراتيجيات تمويل الصناعة، وماضي وحاضر مستقبل الرأسمالية المصرية.
فإذا كان «طلعت حرب راجع» –كما أعلنت الحملة– ليساهم في مبادرة البنك المركزي الهادفة إلى تنشيط قروض المشروعات الصغيرة، على اعتبار أن تلك المشروعات قد تكون الحل لمواجهة مشكلات البطالة وضعف الدخول في المهن التقليدية، في ظل أجواء من التباطؤ الاقتصادي والضغوط الاجتماعية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن تكرار تجربة صعود الرأسمالية الصناعية المصرية في النصف الأول من القرن العشرين؟ وهل أصبحت المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية حاليًا، مثلما كانت مشروعات بنك مصر الضخمة قاطرة النشاط قبل ما يقترب من قرن؟ وكيف تختلف رهانات أحفاد طلعت حرب عن رهانات آبائهم وأجدادهم؟
البرجوازية الزراعية تحلم بالصناعة
ربما علينا البدء بالنظر إلى تاريخ تجربة طلعت حرب وعلاقتها بتكوين وصعود البرجوازية المصرية.
«تُشكل المعركة التي خاضها طلعت حرب من أجل إنشاء صناعة نسيج مصرية تحت إشراف بنك مصر تاريخًا خاصًا بها. مؤامرات دبلوماسية. ضغوط من القوى الكبرى. صعوبات في الحصول على حماية جمركية فعالة. تدريب العمال الفنيين وتكوين بروليتاريا من أصل فلاحي.» هكذا يصف المفكر الماركسي أنور عبد الملك تجربة البنك في لغة أقرب إلى مقدمات التشويق الدرامي في الأعمال التلفزيونية.
وفقًا لإريك دافيز، كانت جذور فكرة تأسيس بنك وطني يمول الصناعة المحلية سابقة على تاريخ تأسيس بنك مصر في عشرينات القرن الماضي. حيث كان الاحتياج لهذا النوع من المؤسسات المالية يتزايد باضطراد مع نمو طبقة البرجوازية الزراعية في مصر، وجاءت أزمة انهيار البورصة الأمريكية في 1907 لتجعل منه احتياجًا ملحًا.
ويروي لنا دافيز في كتابه «مأزق البرجوازية الوطنية الصناعية في العالم الثالث: تجربة بنك مصر، 1920 - 1941» كيف ساهمت أزمة مديونية الخديوي إسماعيل في صناعة البرجوازية الزراعية. لقد اضطره احتياجه للسيولة في 1871 إلى منح حقوق ملكية الأراضي لكبار المزارعين مقابل تمويل ديون الدولة المتفاقمة، فكان ذلك تاريخًا لميلاد تلك الطبقة.
ثم جاء الاستعمار البريطاني لمصر مواكبًا للتوسع في بيع الأراضي الزراعية لكبار الملاك. يقول دافيز في هذا السياق، «أدى امتلاك كثير من عائلات أعيان الريف لمساحات كبيرة من الأرض إلى جانب ألقاب الوجاهة الاجتماعية إلى تجانس طبقة كبار الملاك في مصر إلى الحد الذي يجعل من الممكن الحديث عن برجوازية زراعية واعية لمصالحها السياسية والاقتصادية بحلول نهاية القرن التاسع عشر».
لكن سرعان ما اصطدمت تلك الطبقة بالنظام المالي العالمي في مطلع القرن العشرين، عندما أحجمت المؤسسات المالية الأجنبية عن تمويلها في ظل الأزمة المالية العالمية لعام 1907، الأمر الذي جعل أكبر حزبين في هذا الوقت، الأمة والوطني، بكل ما يمثلانه من نفوذ للبرجوازية المصرية، يُجمعان على ضرورة أن تسيطر الدولة في مصر على القطاع المالي بشكل أكبر.
وزاد من الإحساس بالحاجة للسيطرة على مقدرات الاقتصاد المحلي في مواجهة الهيمنة الاستعمارية ما أنتجته ظروف الحرب العالمية الأولى. إذ دفعت الحرب بريطانيا إلى إبقاء أسعار القطن منخفضة بشكل مصطنع، كما تسببت في انقطاع التجارة بين مصر وأوروبا لفترة، الأمر الذي جعل السوق المصري يستشعر ضرورة التوسع في الصناعة المحلية لسلع ضرورية مثل الصابون والمنسوجات ومواد البناء.
ويوجز دافيز العوامل الدافعة لتأسيس البنك الوطني بقوله «كان يتعين على المصريين أن يحققوا تراكمًا للفائض إذا ما قيض لهم تحدي رأس المال الأجنبي والحيلولة دون تكرار الانهيار المالي الذي وقع في 1907».
في هذا السياق تقدم طلعت حرب بفكرة تأسيس البنك، والذي كان يستهدف من البداية تحقيق طموحات البرجوازية الزراعية المصرية في توفير تمويل يكون منحازًا لنشاطها القائم، ودافعًا أيضًا للتحول إلى التصنيع. وكان رد فعل البرجوازية الزراعية على حرب إيجابيًا للغاية، إذ ساهم كبار الملاك الزراعيين في رأس مال البنك بنحو 92٪.
ويكرر كل من عبد الملك ودافيز في معرض تحليلهما لتجربة طلعت حرب ملاحظة الاقتصادي علي الجريتلي بأن بنك مصر لم يكن مجرد جهة تمويل ولكنه كان يلعب دورًا أقرب للاستثمار المباشر وهو يؤسس شركة تلو الأخرى في قطاعات صناعية مختلفة.
ومن حسن طالع حرب أن صعوده تزامن مع تراجع النفوذ الاستعماري نسبيًا، ومع صعود الروح القومية في أوروبا وما أنتجته من توجهات اقتصادية حمائية استلهمتها السلطات في مصر ودعمت بها تجربة الصناعة الوليدة في البلاد.
فمن جهة كانت آخر معاهدات الامتياز الأجنبية، والتي كانت تعطي للدول الأجنبية امتيازات تجارية، قد سقطت في فبراير 1930، ومن ناحية أخرى دأبت السلطات في مصر على إصدار سلسلة من التعريفات الجمركية الحمائية للصناعة المصرية خلال الفترة من 1930 إلى 1938.
ومن جانب آخر، بنى حرب إمبراطوريته الاقتصادية في وقت كانت لا تزال الحقوق العمالية شبه غائبة عن التشريع المصري، ما أتاح له توظيف العمالة بأجر شديد التدني، بل وتعريضهم في بعض مراحل الإنتاج لمخاطر الأمراض الصدرية.
ولا نستطيع أن نقول إن حرب كان مجرد مستفيد من سير سياسة الدولة في صالحه، بل كان شريكًا في صناعة هذه السياسة، فقد كان حريصًا على لعب أدوار تبدأ من الضغط على البرلمان لتمرير سياسات تخدم نشاطه الاقتصادي، وتصل إلى حد أن تصبح الوظائف العليا في شركاته مكافأة للسياسيين المتقاعدين الذين خدموا مجموعته وقت أن كانوا في مناصبهم.
من التمصير إلى التأميم
ربما يكون الدور السياسي لطبقة حرب ورفاقه هو الذي عجل بصدامها مع الدولة بعد انقلاب يوليو 1952. لم يكن حرب على رأس مجموعته الصناعية الضخمة آنذاك، فقد استقال عام 1939 وتوفي في 1941. لكن الدور الكبير لمجموعة شركات بنك مصر في إدارة الاقتصاد، وما يمثله ذلك من نفوذ، كان يمثل قلقًا لرجال العسكر، كما يبدو الأمر في رواية عبد السلام عبد الحليم عامر عن تلك المرحلة التاريخية.
لقد جاء رجال يوليو بطموحات مشابهة لما تطلعت إليه البرجوازية المصرية في بدايات القرن الماضي بدفع الصناعة نحو التمصير والتعميق. وتبنى النظام رؤية تقوم على أن التصنيع مدخل رئيسي لتحقيق التقدم والتنمية. لكن المفارقة أن الطبقة الحاكمة الجديدة رأت أن تحقيق هذه الطموحات يستلزم الإطاحة بالعديد من رموز تلك البرجوازية، وهو ما حدث في تطورات علاقة بنك مصر بالدولة خلال تلك الفترة، والتي انتهت إلى التأميم في مطلع الستينات.
وكما يروي عامر في كتابه «الرأسمالية الصناعية في مصر»، فإن شركات بنك مصر كانت مستفيدة من سياسات الخمسينات الداعمة للصناعة، وقت أن كان نظام يوليو يطور رؤيته الاقتصادية من التمصير إلى فكر إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع الذي انتشر بين بلدان العالم الثالث كتوجه لتحقيق الاستقلال الاقتصادي عن الغرب المستعمر.
لكن في الوقت نفسه انزعجت الشركات الصناعية من تدخلات نظام يوليو في تحديد الأرباح الموزعة على المساهمين وإلزام الشركات بشراء سندات حكومية والحد من عضوية مجالس إدارات الشركات.
وفي المقابل كان النظام يرتاب من النفوذ السياسي للرأسمالية الصناعية. وما ساعد على هذا الارتياب هو عدم استجابة الرأسمالية الصناعية لخطط النظام الخاصة بتعميق الصناعة، مما رسخ لديه رؤية بأن القطاع الخاص لا يميل إلى الصناعات ذات الطابع التنموي ويبحث عن الربح السريع. هذا بالرغم من أن مجموعة بنك مصر ساهمت في صناعات مهمة في هذا الوقت كان من أبرزها شركة الحديد والصلب بحلوان وشركة مصر للكيماويات.
أدت كل تلك الملابسات إلى خطوة التأميم التي يعلق عليها عبد الملك بقوله «تأميم البنك الأهلي وبنك مصر جناحي القوة المالية الرئيسيين في مصر في 11 فبراير 1960 كان نقطة التحول في تطور التحالف بين البرجوازية الصناعية المصرفية الكبيرة وبين الجهاز العسكري».
من تمويل الصناعة إلى تمويل الديون
كان المبرر الرئيسي لتأميم بنك مصر والشركات التابعة له هو تمكين الدولة من تنفيذ مخططاتها التنموية، خاصة بعد أن أصبح النظام الناصري في مطلع الستينات عازمًا على إنجاح خططه الخمسية وعدم تكرار تجربة خطته التنموية الأولى في 1957 التي لم يكتمل تنفيذها.
لكن المفارقة كانت أنه بعد أكثر قليلًا من عقد واحد من الزمان كانت توجهات النظام الحاكم تتغير بالكامل. إذ أعلن السادات «ورقة أكتوبر» في 1974، مدشنًا التوجه إلى «التحرر» الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص، أو ما يُعرف بسياسة «الانفتاح».
وبالقفز عدة سنوات للأمام سنرى النظام يواجه أزمة مالية متفاقمة، خاصة في النصف الثاني من الثمانينات، تجلت بشكل صارخ في الديون الخارجية التي بلغت نحو 50 مليار دولار في نهاية يونيو 1990، بما يمثل نحو 144٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الوقت.
لم يترك النظام العالمي مصر لكي تسقط في أزمتها المالية. كان صندوق النقد حاضرًا بقوة في البلاد منذ السبعينات. وبعد عدة اتفاقيات خلال عقدين من الزمان، توصل الصندوق والسلطة في بداية التسعينات إلى الاتفاق الأكبر والأهم، والمعروف بالتثبيت والتكيف الهيكلي، وهو الاتفاق الذي حوّل وجهة النظام الاقتصادي بالكامل إلى اقتصاديات السوق ودفع الدولة للتخلي عن قاعدتها الصناعية من القطاع العام تحت مسمى «الخصخصة».
في تلك المرحلة كانت الدولة لا تزال تحافظ على ملكيتها للبنوك الكبرى، لكن احتياجها للتمويل كان لأسباب مختلفة. صحيح أنها لم تتخلى عن ملكية المصانع دفعة واحدة، وكانت تستفيد بقوة من تمويل البنوك العامة للقطاع العام، لكن ثمة دور ثان للبنوك العامة تجلى بوضوح وهو تمويل الدين العام.
تعلم نظام مبارك من أزمة المديونية التي وقع فيها في نهاية الثمانينات، واتجه بقوة منذ التسعينات للاعتماد على مصادر الدين الداخلي بدلًا من الخارجي. حدت هذه السياسة من فرص القطاع الخاص في النمو، لأن أموال المدخرين كانت تتجه إلى الديون بدلًا من الاستثمار، فيما يعرف بظاهرة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في التمويل.
لم يقتصر الأمر على المزاحمة، لكن النظام الاقتصادي الجديد الذي أرساه صندوق النقد الدولي في مصر انطوى على سياسات أدت إلى ما وصفه جودة عبد الخالق بـ«إهدار التصنيع» (de-industrialization). يشرح جودة هذا قائلًا إن «زيادة أسعار الفائدة المحلية ورفع أسعار الطاقة وفرض الضريبة العامة على المبيعات وتحرير التجارة قد يقود إلى اتجاه واحد فقط هو إهدار التصنيع ... أما الميزة الوحيدة التي تقدمها تلك الحزمة إلى الصناعة الخاصة فربما كانت العمالة الرخيصة، ولكن ذلك قد يعني أيضًا ضحالة السوق ومن ثم يحمل في طياته التهديد بانكماش الطلب المحلي».
شجعت سياسات «التحرر» الاقتصادي على زيادة تكاليف الاستيراد. حيث تراجع سعر الجنيه أمام الدولار تحت نظام سعر الصرف المعروف بـ«التعويم المُدار»، وهو ما وضع سياسة إحلال الواردات أمام معضلة الكبيرة. حيث كانت القاعدة الصناعية التي تركها ناصر تعتمد على استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج في كثير من الحالات.
تجسدت إذن مشكلات الصناعة تحت اقتصاد مبارك وصندوق النقد في مزاحمة الدولة للاستثمار في التمويل وتذبذب قيمة العملة مع الاعتماد الكبير للصناعة على الاستيراد، وهي الأزمات التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، عندما أعلن بنك مصر أن طلعت حرب راجع من جديد بينما عملة مصر تنهار أمام العملة الأمريكية.
أزمة رجال مبارك في الصناعة
بالرغم من العوامل المثبطة للصناعة تحت حكم مبارك، لكننا لا يمكن أن نأخذ بمفهوم «إهدار التصنيع» الذي أطلقه عبد الخالق كحكم معمم على تلك الحقبة، حيث استطاعت مجموعات صناعية عدة أن تنشيء وتساهم في عملية التنمية، وإن كان نموذج مبارك الصناعي قام على استغلال موارد الدولة من الطاقة الرخيصة والعمل في ظروف احتكارية، علاوة على انتهاك حقوق العمال وتشغيلهم بأجور متدنية في كثير من الأحيان.
من تلك المجموعات صناعات التجميع التي استفادت من الحماية الجمركية في بعض الفترات، ومنها صناعات تجميع السيارات، بجانب الشركات التي استفادت من الاستحواذ على أصول الدولة والتمتع بوضع احتكاري في السوق مثل نموذج عز في حديد التسليح أو شركات الأسمنت وغيرها.
وتشير بعض الدراسات إلى استفادة المجموعات المقربة من نظام مبارك بالتمويل المصرفي بشكل واضح. فترصد إحدى الدراسات ارتفاع قيمة الديون طويلة الأجل لـ«مجموعة عز» بين 2004-2008 بنحو 172٪، ولـ«النساجون الشرقيون» بنحو 173٪.
وتُظهر بيانات البنك المركزي أن قطاع الصناعة في مجمله كان يحظى بأهمية نسبية بين باقي الجهات المقترضة من البنوك. فحسب آخر البيانات المتاحة، وصل نصيب الصناعة من إجمالي أرصدة الإقراض والخصم للقطاع الخاص بالعملة المحلية خلال 2015 إلى نحو 43.9٪ مقابل 35.2٪ في 1999. وتطورت حصة الصناعة في مجال قروض العملات الأجنبية إلى نحو 55.3٪ مقابل 41.6٪ في الفترة نفسها.
لكن نموذج مبارك في التصنيع واجه مشكلات متتالية منذ 2008، من تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلى التأثيرات السلبية للاضطرابات السياسية التي تلت ثورة يناير، وهو ما حد من قدرته على النمو. تزامن ذلك مع اضطرار الدولة إلى سحب بعض الامتيازات التي كان مبارك يقدمها للقطاع الصناعي في مجال الطاقة منخفضة السعر بشكل تدريجي في ظل مساعيها لكبح عجز الموازنة.
كما أثرت بيئة الاقتصاد بشكل واضح على فرص الصناعة في التمويل. فقد تنامى اعتماد الدولة على القطاع المصرفي في تمويل الديون المحلية بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، وهي المشكلة التي أشرنا إلى نشأتها وتطورها في التسعينات.
تلك الحقائق سيجدها طلعت حرب في ملف الصناعة المصرية فور استلامه مهام عمله بعد عودته. كما ستفاجئه، وربما تصدمه، قرارات البنك المركزي المتتالية منذ نوفمبر الماضي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، بـ700 نقطة أساس، في ظل مساعيه منذ تعويم الجنيه على جذب الدولارات عبر زيادة العائد على الديون الحكومية، لجلب كميات من العملة الصعبة تدعم العملة المحلية المتدهورة.
انتقد عديد من المحللين سياسة البنك المركزي برفع الفائدة لما سيكون لها من آثار سلبية بالغة على تكاليف الإقراض للمنتجين. لكن المركزي تجاهل تلك الانتقادات واستمر في رفع العائد مستمعًا فقط إلى توصيات صندوق النقد الدولي الذي كان متحمسًا لهذه السياسة النقدية.
وكانت المفارقة أن أكبر الشركات الصناعية المستفيدة من التمويل المصرفي في السابق هي أكثر الشركات المتوقع أن تتضرر من رفع العائد، ومنها غبور أوتو والعز وبالم هيلز للتعمير، حيث تقترب قيمة القروض والتسهيلات البنكية لشركة العز وحدها من 25 مليار جنيه.
وإن كانت سياسة المركزي في سعر الفائدة تعوق قدرة الصناعة على التوسع في الحصول على التمويل، فإن ظروف الاقتصاد الكلي تمثل عائقا آخر أمام قدرة هذا القطاع على النمو والتوسع.
فقد ساهم التعويم في نوفمبر 2016 في إفقاد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، وهو ما زاد من تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة. وكما أشرنا من قبل فإن النموذج المصري يعتمد بشكل كبير على استيراد المنتجات الوسيطة والسلع الرأسمالية من الخارج بشكل كبير.
كما ساهم التعويم في إطلاق معدلات التضخم لتصل في مستهل العام الحالي لأعلى مستوياتها، على أساس سنوي، منذ الثمانينات، وهو ما ساعد على تآكل القيمة الحقيقية للأجور وضعف معدلات الاستهلاك، وبالتبعية تقليص فرص الشركات المعتمدة على الطلب المحلي في النمو.
طلعت حرب عاد لينقذ مبادرة المركزي
وسط تلك الأجواء المثيرة للتشاؤم لفتت الحملة الإعلانية لبنك مصر الأنظار. وكما أشرنا من قبل فقد كشف البنك بعد أسابيع من التشويق عن أن هدف الحملة هو الترويج لقروض موجهة للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزي. فما هي هذه المبادرة؟
سبق وأن أطلق البنك المركزي مبادرة لتنشيط تمويل المشروعات الصغيرة وسط أجواء الركود العالمي في أزمة 2008. وعاد المركزي في بداية 2016 ليطلق مبادرة جديدة تقوم فكرتها على إلزام البنوك بالوصول بنسبة القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20٪ من إجمالي محفظتها التمويلية في 2019. وقال المركزي إن تطبيق هذا الشرط سيضخ تمويلات في القطاع بنحو 200 مليار جنيه.
تهيمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النشاط الصناعي في مصر وعلى الاقتصاد بصفة عامة. كان ذلك هو الوضع القائم حتى خلال الحقبة الناصرية عندما كانت الدولة ترعى المشروعات الصناعية الكبرى. لذا يعول على هذا النوع من المبادرات بشكل كبير في تنشيط العملية الإنتاجية وتوفير فرص العمل. لكن وقوع نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة في القطاع غير الرسمي وعدم القدرة على توثيق الأصول المملوكة لديها تظل عائقًا كبيرًا أمام القدرة على التوسع في تمويلها.
وربما تساهم مبادرة المركزي في تحقيق واحدة من أهم التوصيات المتكررة للنهوض بالصناعة في مصر، ألا وهي التوسع في الصناعات المكملة. ففي ظل الاعتماد بقوة على استيراد السلع الصناعية الوسيطة من الخارج، فإن تمويل صناعات وسيطة محلية قد يمثل المرحلة الثانية من إحلال الواردات التي بدأتها البلاد في الستينات، مما قد يحد من أزمة العملة الصعبة الجارية.
لكن جهات مراقبة للاقتصاد المصري، مثل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اعتبرت أن المبادرة تمثل تحديًا أمام القطاع المصرفي في ظل «النمو السريع» المطلوب في حجم القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة، وقالت إن قواعد المركزي ستحتم على كل من بنك مصر والتجاري الدولي تنمية نشاطهما في مجال المشروعات الصغيرة بأكثر من 50٪ سنويًا.
ومن حسن طالع المشروعات الصغيرة أن مبادرة المركزي وضعت شرطًا واضحًا يتعلق بأسعار الفائدة المقدمة في تمويلات تلك المشروعات، 5٪ متناقصة، وهو ما سيجنبها التأثر بالزيادات المتتالية في أسعار العائد على الإقراض على عكس المشروعات الكبيرة. لكن بيانات القطاع المصرفي لا توضح لنا أيضًا إلى أي مدى سيمثل التوسع في الإقراض بهذه الفائدة الميسرة عبئًا على البنوك في ظل سياسة البنك المركزي برفع العائد.
بإيجاز شديد: محاولات القطاع المصرفي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة هو توجه إيجابي للاقتصاد من حيث المبدأ، وللصناعة على وجه خاص، نظرًا إلى أن النسبة الأكبر من مشروعات هذا القطاع تعمل في مجال الصناعة. ومن جهة أخرى قد يسهم تمويل الصناعات الصغيرة في التوسع في إنشاء صناعات مكملة للصناعات الكبرى.
لكن غياب المعلومات عن هذا القطاع يظل تحديًا أمام القدرة على التوسع فيه. ومن جهة أخرى، فقد لا يكون التمويل البنكي للمشروعات الصغيرة مدخلًا مناسبًا للعدالة الجغرافية نظرًا لتركز المشروعات الصغيرة التي تتعامل مع البنوك في محافظات الدلتا، ولا للعدالة على المستوى القطاعي نظرًا لتركز القروض البنكية في الشركات الأكبر داخل قطاع المشروعات الصغيرة.
وبجانب العوامل السابقة، فإن ظروف الاقتصاد الكلي تعمل حاليًا ضد الصناعات الكبرى، وهو ما يفرض تحديًا إضافيًا على المشروعات الصناعية الصغيرة المرتبطة بخدمة المشروعات الكبرى في ظل تقلص نشاط تلك الأخيرة، إلا إذا نجحت المشروعات الصغيرة في تقديم مدخلات إنتاج بسعر ينافس المدخلات المستوردة، وأصبح نشاطها مدخلًا لتعميق إحلال الواردات في مصر.
أما عن المشروعات الصناعية الكبرى، فتنتظرها تحديات تتعلق بقدرتها على المنافسة في سوق محلي يعاني من انكماش الطلب وسوق عالمي يتسم بالتباطوء وضعف البنية التكنولوجية والاعتماد القوي على المدخلات المستوردة، علاوة على ميل القطاع المصرفي إلى الاستثمار في الديون السيادية.
ترشيحاتنا