فنون
صفاء شاكر"ميرامار" بين رؤية محفوظ وسيناريو الليثى
2025.05.11
مصدر الصورة : آخرون
"ميرامار" بين رؤية محفوظ وسيناريو الليثى
يحتل نجيب محفوظ مكانًا فريدًا في تاريخ الرواية العربية. وقد تنقل في كتابته الروائية عبر تاريخه الطويل بين أكثر من لون من ألوان الرواية: التاريخي، والواقعي، والرمزي، إلخ. وفي إحدى مراحل كتابته مع مطلع الستينات بدأ في رصد نقدي لمجتمع ثورة يوليو 1952: "اللص والكلاب" 1961، و"السمان والخريف" 1962، و"ثرثرة فوق النيل" 1966، ثم "ميرامار" 1967. والرواية الأخيرة هى مقصدنا اليوم.
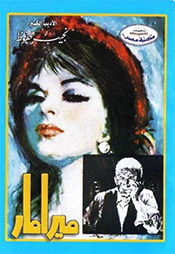
كلمة "ميرامار" هى من أصل لاتيني، وتتركب في اللغة الإسبانية من الفعل "ميرا" ويعني: شاهد بإعجاب، ومن الاسم "مار" ويعني البحر، ومعنى الكلمة ينسحب على بعض المفردات مثل المسكن والفندق الجميل، وأيضًا المكان الجميل على الشاطئ. و"ميرامار" هى الرواية الوحيدة تقريبًا لنجيب محفوظ التي تدور أحداثها في الثغر بعيدًا عن القاهرة. وقد اتخذ الكاتب من هذا البنسيون إطارًا مكانيًّا ضيقًا، يتسع في مرونة ليضم نماذج متعارضة المصالح والتكوين تدور بينها حرب دائمة.
اختار محفوظ زمن الستينيات بعد قرارات يوليو الاشتراكية، وما تبعها من إجراءات ليتتبع تأثير هذا التغير الكبير في حياة مجموعة من الشخصيات تمثل فئات المجتمع الأكثر حساسية تجاه قرارات الثورة: ثلاثة من الشيوخ: عامر وجدي (الصحفى القديم العجوز)، طُلبة مرزوق (الإقطاعي الذي الذي يحقد على الثورة)، ماريانا (صاحبة البنسيون)، وثلاثة من الشباب: سرحان البحيري (الشاب الانتهازي)، حسني علام (الثري العابث)، منصور باهي (الشاب المثقف). ومع كل هؤلاء: علية (المدرِّسة)، صفية (الراقصة)، محمود أبو العباس (بائع الصحف) وزُهرة.
تتلخص الرواية في هروب زُهرة من بلدتها بعد أن تضغط عليها أسرتها للزواج برجل ثري عجوز، لتستقر في بنسيون ميرامار وتعمل به خادمة، وتتعرف هناك على علية المدرِّسة التي تعلِّمها القراءة والكتابة والتي يتقدم سرحان لخطبتها بعد أن وعد زُهرة بالزواج، فتُصدَم الأخيرة، وتترك البنسيون.
نُشرت رواية ميرامار قبل نكسة 1967 بأسابيع، وتحولت إلى لفيلم عام 1969 من إنتاج ممدوح الليثى وإخراج كمال الشيخ. ويكشف الليثى في هذا الفيلم عن موقف معادٍ للثورة، تصاعد بعد ذلك في "ثرثرة فوق النيل" و"الحب تحت المطر" ووصل إلى قمته في "الكرنك"، وكلها عن روايات لنجيب محفوظ تحمل نقدًا لمجتمع يوليو، إلا أن الليثي حمّلها بروح كارهة للثورة، وأبدى تعاطفًا -بل انحيازًا- إلى الطبقات التي حاولت الثورة تحجيم سيطرتها وسطوتها، وأظهر كراهية للطبقات الكادحة والمطحونة. هكذا أعلاد الفيلم (ميرامار) صياغة شخصيات رواية محفوظ لتحمل رؤية الليثي الكارهة ليوليو.
فمثلًا قدَّم محفوظ شخصية طلبة مرزوق كرجل في الستين من عُمره كان يملك ألف فدان وُضعت تحت الحراسة لشُبهة اشتراكه في عملية تهريب، وأنه جبان ومنافق، يخاف أن تصل معارضته للثورة إلى المسؤولين، فيستميت في النفاق، وأن القاهرة تُشعره بهوانه بعد أن كان وكيلًا لوزارة الأوقاف عن أحد أحزاب السراي فجاء ليعيش في البنسيون السكندري. ويرى أن سعد زغلول "بذر البذرة الخبيثة" التي نمت كالسرطان وقضت على عالمه وجعلت الحاضر مقبرة غير مريحة. ويتساءل: "ما الذي يدعو أحدًا إلى الالتصاق بالثورة؟ لقد سلبت البعض أموالهم وسلبت الجميع حريتهم"، "وحوش يتعاركون على أسلابنا هاتفين: تحيا الاشتراكية والتقشف". فكَّر في عشيقته القديمة "ماريانا" صاحبة البنسيون، التي فقدت زوجها في ثورة 1919، وجرَّدتها الثورة الثانية 1952 من مالها المستَثمر في الأسهم. وطبيعي أن يتآلف طلبة مرزوق مع ماريانا التي تمثل بقايا ذيول الاستعمار.
أما شخصية "طلبة مرزوق" في الفيلم التي مثلها يوسف وهبي فنجدها مغايرة تمامًا، وتترك أثر نفسي لدى المشاهد يختلف كلية عن الأثر النفسي الذي تتركه لدى قارئ الرواية. وقد وصل الفيلم إلى ذلك عن طريق: (1) حذف كل الاتهامات التي يمكن أن تُوجه ضده. (2) قلب بعض سماته السلبية المنفِّرة إلى نقيضها الإيجابى. (3) توسيع دوره في الفيلم عنه في الرواية. فالفيلم لا يذكر أنه عميل للسراي، ولا يذكر أنه وُضع تحت الحراسة لشُبهة تهريب، واكتفى بذكر السبب الذي زعمه مرزوق نفسه وهو أن الحراسة على ممتلكاته كانت نتيجة نُكتة أطلقها طلبة في النادي، وهو سبب ضعيف يبعث على الكراهية لرجال الثورة الذين يصادرون الأموال بسبب نُكتة، ولا يتطرق الفيلم إلى رغبته الصريحة في تسليم البلد لأمريكا، ولا يشير الفيلم إلى سبب هروبه إلى البنسيون، بل إنه الوحيد الذي لا نعرف في الفيلم سبب نزوله به حرصًا على عدم تشويه صورته. كما أظهره الفيلم رجلًا ساخرًا شجاعًا -عكس الرواية الذي ظهر فيها جبانًا- فسخر من أفعال رجال الثورة وقراراتهم الاشتراكية: "حقيقي الثورة حالتني على المعاش بدري، وحقيقي إنهم لغوا البهوية بتاعتي، وحقيقي إنهم فرضوا علىيَّ الحراسة، إنما ده لصالح مين يا ابني؟ لصالح الشعب، يبقى لازم كلنا نحب الثورة". وبسخريته اللاذعة أصبح طلبة مرزوق هو الشخصية الوحيدة التي تستحق إعجاب المتفرجين، وكان لأداء يوسف وهبي أهميته في تدعيم ذلك التأثير. وطوال الفيلم نرى مشاهد تحتوي على ألفاظ ساخرة ولاذعة له، وعندما تشتبك زُهرة مع سرحان البحيري، يعلق ساخرًا: "المثقفين وقعوا أخيرًا مع الفلاحين"، وعندما يوَّجه سرحان إهاناته إلى زُهرة يهتف طلبة: "فلتحيا الاشتراكية". وقد تضافر على إبراز بطولة طلبة مرزوق وسيادته على المناظر التي ظهر فيها: الدور الجديد الذي رسمه له السيناريو، والإخراج الذي خصَّه باللقطات المتوسطة، والقريبة المتوسطة، وتمثيل يوسف وهبي وحضوره الطاغي.

أما عامر وجدي، الذي مثل شخصيته عماد حمدي، الوفدي القديم، فكان صحفيًّا من أصحاب البلاغة، وكان أزهريًّا رموه بالإلحاد لأنه اشترك في تخت مطرب، فطُرد من الأزهر، وعندما تقدم للزواج رُفض لنفس التُّهمة. جاء إلى البنسيون بعد أن أُحيل إلى المعاش، يجتر ذكريات شبابه، فهو الذي يفتح الباب لزُهرة، وهو الوحيد الذي يودِّعها في النهاية، وطوال الأحداث يعاملها بحنان أبوي، يسدي إليها النصيحة، ويهديها قلمًا وكراسة عندما علم بعزمها على التعلم ويعرض عليها مساعدته، ويقف إلى جانبها في أزماتها، ويخاف عليها من أطماع الآخرين. وهو لا يشارك في أحداث البنسيون، وإنما يقوم في الرواية بدور الراوي. هو مؤرخ أحداث ميرامار المحايد، ويعلق عليها سواء بالارتداد إلى ذكريات سابقة أو تلاوة آيات معينة من القرآن. لكن دور عامر وجدي في الفيلم يتقلص حتى يكاد يتلاشى تمامًا، فلم نعُد نرى الأحداث من وجهة نظره، فقد اختار الفيلم -وله الحق في ذلك- وجهة النظر الموضوعية في سرد الأحداث، لكنه سَحب من عامر دور التعليق على الأحداث وأسنده إلى طلبة مرزوق! وأخذ التعليق هنا بالطبع شكلًا آخر يتفق مع شخصية طلبة. وهكذا، لم يبق في الفيلم من شخصية "عامر وجدي" القائمة في الرواية غير شبحها، وإن احتفظ له بمشاعر الأبوة نحو زُهرة لكنها بقيت في الظل.
أما حسني علام، الذي مثله أبو بكر عزت، فهو شاب ثري من أسرة إقطاعية يملك 100 فدان، طلب يد قريبته فرفضت لأنه لم يحصل على مؤهل علمي، والأرض تكاد تضيع، ضاق بالإقامة في فندق سيسيل بالإسكندرية لأنه يذكِّره بقصة أسرته في طنطا، فانتقل إلى بنسيون ميرامار. يكره سيرة الشهادات، ويخشى -مثل طلبة مرزوق- نزلاء البنسيون، ويقول عن طلبة: "الوحيد الذي أضمر له حبًّا واحترامًا"، ويشاركه الشعور بالجُبن من مواجهة الآخرين برأيه، تجمع الاثنان نفس الطبقة ونفس المشاعر تقريبًا، وإن كان طلبة يمثل جيل الشيوخ، وحسني يمثل جيل الشباب. وعندما رأى زُهرة أبدى إعجابه بها، لكنه لا يتخلى عن نظرة الاستعلاء الطبقية إليها. رُسمت شخصيته من خلال علاقاته بالجنس والسيارة والمشروع التجاري الموهوم، إذ عن طريقها يتجسد لنا ضياعه وهروبه من أزمته، فهو يزعم أنه يبحث عن مشروع تجاري يستغل فيه ثروته، لكنه لا يبذل أدنى جهد لتحقيقه إلى أن يحل محل صاحب الملهى الذي تعمل فيه صفية. وتكشف الرواية عن أزمته وتقدم إلينا من خلاله صورة إنسانية متكاملة لها أبعادها المتعددة تمثل نموذجًا من نماذج الشباب الضائع في مرحلة معينة من تاريخ مجتمعنا. أما الفيلم فقد أسقط عن الشخصية كل أبعادها تقريبًا باستثناء ما يجذب الجمهور وهو اهتمام حسني بالجنس، ذلك بعد أن أضفى عليه -كما فعل مع طلبة مرزوق- شيئًا من خِفة الظل يدعمها تمثيل الممثل الكوميدي أبو بكر عزت، كما خلَّصه من كراهيته للآخرين، ولم يذكر الفيلم فشله في الزواج أو إخفاقه في الحصول على مؤهل دراسي، ولم يتطرق إلى مسألة المشروع سوى مرة وحيدة، ولم يكن لها أي صدى في الأحداث أو في شخصيته. ويبدو حسني في الفيلم وكأنه لا يعاني شيئًا على الإطلاق، مجرد شاب ثري يعيش كما يهوى، وخسر الفيلم بذلك طابع الشخصية الإنساني، كما خسر الجانب الدرامي منها، وفشل في أن يجعل من حسنى علام ممثلًا لضياع فئة من شباب مجتمعنا، وأصبح لا يمثل إلا نفسه.
أما النزيل الرابع في البنسيون فهو سرحان البحيري الذي نزل فيه بعد أن رأى زُهرة لأول مرة في محل البقالة فلفتت نظره، وهو نفعي وانتهازي وله تطلعات طبقية، يعتبر نفسه أحد الورثة الشرعيين للطبقات القديمة وطريقتها في الحياة، حينما يحقق أهدافه ويصبح من أغنياء الاشتراكية، يكره فكرة مصادرة الملكية، فهو يحلم بنفسه مالكًا سيارة وڨيلا، فيعتذر لأفراد الطبقة القديمة عما فعلته الثورة مبررًا بأنها على أي حال أفضل من الشيوعية. يجمع صفات متعددة: وكيل حسابات شركة الغزل، وعضو مجلس الإدارة، عضو الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي، وهو يعتقد أن كل ما سبق الثورة كان فراغًا، ونسي أنه كان وفديًّا في الزمن القديم. يؤمن بالتخطيط، فيضع مع صديقه المهندس خطة لا ارتجال فيها، تضع في حسابها كل العوامل لسرقة الغزل بشكل منهجي أربع مرات في الشهر. وعند التعرض لحياته العائلية، نجد أنه تنازل لأمه وإخوته عن إيراد ميراثه من الأرض البالغ أربعة أفدنة، وهو ملتزم تجاه إخوته عند بداية كل عام دراسي جديد التزامًا يفرض عليه تضحيات مريرة. الحب عنده عاطفة يمكن معالجتها بشكل أو بآخر، أما الزواج "إذا لم يرفعني من ناحية الأسرة درجة، فما جدواه؟" ولذلك يصادر حبه لزُهرة ويقنع نفسه بالزواج بمدرِّستها علية -دون عاطفة- لأنها تحقق له نفعًا أكبر بوظيفتها وأسرتها.
يتودد سرحان إلى حسني علام أملًا في أن يعمل معه في مشروعه الوهمي "أنا قد أكره فكرة طبقته، ولكني أفتتن بأي شخص منها إذا ساقتني الظروف الممتازة إلى صُحبته". لا يطمئن إلى طلبة مرزوق، ومع ذلك فهو يتبادل معه الحديث ويحرص على احترامه ومجاملته والتودد إليه. وحينما تعثَّرت أقدامنا بجثته ملقاة في الطريق العام ابتداء من الصفحات الأولى للرواية، وبعد أن كدنا نوزِّع تُهمة قتله على الجميع -فثمة تناقضات حادة بينه وبين جميع الشخصيات المتنازعة على زُهرة التي تستطيع أن تقوى على القتل- عرفنا في الصفحات الأخيرة أنه مات منتحرًا، وكانت أداته شفرة حلاقة مستعملة وعارية، بعد افتضاح أمر السرقة، التي كان يحلم أن تصل به إلى الثراء. ولا شك في أن تلك الجُثة التي سقطت تشير إلى حتمية انهيار الواجهة الزائفة للمجتمع "الاشتراكي".
لقد قدمه محفوظ كعنصر سلبي يدين من خلاله الممارسات اللاأخلاقية والمنحرفة للذين ركبوا التنظيمات السياسية دون قناعة حقيقية. وكاتب السيناريو لم تسعده شخصية من شخصيات الرواية أكثر من "سرحان البحيري" فهي ممثلة الثورة في البناء الدرامي، وعليها أسقط كراهيته، فجعل منها نموذجًا بشعًا، ولم يكتفِ بسوءاته التي أوردها محفوظ، بل زاد عليها الابتزاز والسفالة الأخلاقية، كثَّف خيانته لزُهرة -التي أحبها حببًّا حقيقيًّا في الرواية- ولكننا في الفيلم نرى الحب في إطار انحرافاته "لم أبرأ تمامًا من حبها، وهو العاطفة الصادقة الوحيدة التي خفق بها قلبي الممزق الأهواء". ويكشف لنا هذا الشرخ في نفسية سرحان عن الجانب الإنساني منها، الذي لا يزال يخنقه فيخنق نفسه، وقد أغفله الفيلم تمامًا، لأنه أراد أن يذبح سرحان بلا شفقة.

أما منصور باهي، الذي مثل شخصيته عبدالرحمن علي، فهو شاب في العشرينيات، جاء البنسيون بتوجيه من أخيه بعد أن أصبح يعمل في إذاعة الإسكندرية منقولًا من إذاعة القاهرة. وكان أخوه الأكبر الذي يحمل رتبة لواء في الشرطة وراء نقله، ليبعده عن الارتباط بنشاطه السياسي السري في القاهرة. يروِّعه إحساسه الدائم بالفشل والعجز، يعيش حياته حالمًا غير قادر على تحقيق ولو جزء من حلمه. يحب درية، التي قامت بدورها سهير رمزي- زوجة أستاذه فوزي ويدفعها إلى طلب الطلاق حتى ينفي عن نفسه فكرة خيانته لأستاذه، وعندما تفعل ذلك، يعجز عن إتمام حلمه بالزواج بها. وهكذا، فخوفه من الخيانة دفعه إلى خيانة الشخصيْن. وهو شديد القسوة في تأنيب نفسه "العفن يجري في الهواء، ولعله يصدر أصلًا عن ذاتي أنا"، وعندما يتم القبض على أصحابه يقول: "كان يجب أن أكون معهم". وعندما يتخلى سرحان عن زُهرة بصق منصور في وجهه: "على وجهك ووجه كل وغد، وكل خائن" ثم يشتبك معه. ويحلم منصور بأنه يقتل سرحان، ثم يتبعه بالفعل، ويحدث أن يسقط سرحان وحده في الطريق، فيجري منصور نحوه ويضربه بقدمه في بطنه، وعندما يعلم -فيما بعد- أن سرحان قد مات، يعلن أنه قاتله، ويسلِّم نفسه للشرطة، ولكن القدر يأبى عليه إلا أن يعيش بعذابه، وذلك أنه قد ثبت من تقرير الطب الشرعي أن سرحان مات منتحرًا.
يعاني منصور باهي عند محفوظ من داء خطير يحكم سلوكه، وهو نموذج للشباب الذي حاول أن يبحث عن يقين لم يجده، وكان طموحه أكبر من إرادته، فهو بتخليه عن القضية التي كان يعمل من أجلها، والعقيدة التي يؤمن بها، يبدأ طريق الانفصال بين الفكر والفعل، ويتمزق بين الرغبة في الفعل وانعدام القدرة على ذلك. ولكن الفيلم لا يرى في منصور سوى واحد من الشيوعيين، وأنه شخصية ضعيفة تعاني من تسلط الأخ الأكبر، وقد أفقده السيناريو الصراع الداخلي، وحوَّله إلى نمط هزيل ذي بُعد واحد، ولا يشير إلى خيانته أو إحساسه الدائم بها. ويربط الفيلم تراجعه في الزواج بدرية إلى لقائه بشقيقه لواء الشرطة، بحيث تبدو الشخصية مهزومة ومنسحبة، وهو ما أراد الفيلم توصيله إلى المتلقي عن الشيوعيين وعن ضرورة احتقارهم، فهم خونة على كل المستويات: العامة والشخصية. ولا يعني ذلك أن الرواية لا تدين منصور، ولكن ما تدينه به غير ما يدينه به الفيلم. في الرواية يمثل منصور صورة لقِطاع كبير من شباب بالمجتمع المصري الضائع، أما في الفيلم فهو مجرد شاب ساقط.
وحينما أراد محفوظ محاكمة سلبيات الثورة، اعتبر أن سرحان البحيري هو موضوع المحاكمة، وما منصور باهي إلا أداة تنفيذ الحكم بالإعدام، وإن كان هو أيضًا لم يسلم من محاكمة ثانوية جعلت منه المتهم الثاني، إنه متهم لأنه مطوي برغمه تحت جناح السلطة، فأخوه أنقذه من الاعتقال، كما يأمره بالابتعاد عن محبوبته الشيوعية مثله، كجزء من انسحاب كامل من كل نشاط سياسي، ويأتي الأمر في شكل نصيحة تشف عن تهديد مبطن بالاعتقال كبديل وحيد للانصياع للأمر. وهذه العلاقة المريبة تعكس رؤية محفوظ للتحالف الذي كان قائمًا بين ثورة يوليو وبعض فصائل اليسار في عقد الستينيات. أما سرحان فهو النموذج الذي أفرزته ثورة يوليو حين تحولت إلى مؤسسات حاكمة تحمل الملامح الخارجية للديمقراطية دون مضمونها، ففتحت تلك الهياكل الورقية الباب على مصراعيه للانتهازيين والمتسلقين.
هناك أيضًا محمود أبو العباس، الذي مثل دوره عبدالمنعم إبراهيم، وهو بورجوازي صغير يبيع الجرائد ويعمل على أن يتوسع في تجارته بشراء مطعم بنايوتى، ويعرض عليه سرحان أن يشاركه فيرفض، ويطمع محمود في الزواج بزُهرة لكنها ترفضه: "سأعود معه إلى مثل حياة القرية التي هربت منها". يشتبك مع سرحان لأنه عشيق زُهرة، لكنه يتصالح معه في النهاية ويدعوه إلى العشاء على حسابه في مطعمه الجديد ويقبل سرحان الدعوة. وهكذا تربط الرواية بين محمود أبو العباس، وبين سرحان البحيري الذي يماثله في تطلعاته وتضمهما نفس الطبقة، والرواية عندما اختارت له أن يحل محل الخواجة تشير إليه بإصبع الاتهام، كما تشير إلى مرحلة التأميم وحلول المصريين محل الأجانب. لكن الفيلم رفع عن أبو العباس كل اتهامات الرواية، وبدلًا من شرائه لمطعم بنايوتي، افتتح مكتبة واستبدل بالجلابية القميص والبنطلون، وزعم أنه التحق بمدرسة ليلية ليتعلم مثل زُهرة. وقد أجرى الفيلم هذه التغييرات ليجعله جديرًا بالزواج بزُهرة، ولكن فقد القيمة الرمزية لإحلاله محل الخواجة في مطعم بنايوتى، واقتناع زُهرة به في النهاية هو تزوير لآراء محفوظ في روايته.

وأخيرًا، تبدو زُهرة رمزًا لشعب مصر في زمن الثورة، رمزًا لبدايات التحول والنمو والتطلع نحو الأفضل، رغم أن محفوظ لم يذكر ذلك تصريحًا أو تلميحًا. فزُهرة ليس لها وجود موضوعى في الرواية، وإنما نراها من خلال الآخرين. وهى تبدو ضحية للبعض، الذين يحاولون استغلالها والاستفادة منها دون إفادتها. وزُهرة إذ تنشد حريتها: "أنا حرة ولا شأن لأحد بي" تدخل في صراعات ضد الاستغلال، ذلك الصراع الذي بدأته في القرية وتواصله في المدينة برد طلبة مرزوق عن مداعباته، والدفاع عن نفسها ضد محاولة حسني الاعتداء عليها، ورفض وصاية ماريانا عليها بالتساهل مع الزبائن والاستسلام لمداعباتهم. وتكتشف زُهرة ارتباط حريتها بالعِلم فتقرر: "لن أبقى جاهلة" "سأتعلم بعد ذلك مهنة.. فلن أبقى خادمة". تنزع إلى الاشتراكية ممثلة في شخص سرحان البحيري وإن جاء وغدًا حقيرًا، فتلفظه غير عابئة ولا نادمة: "غور في ألف داهية".
لكن السيناريو والفيلم يفشلان في إيجاد البُعد الرمزي في شخصية زُهرة ويحوِّلانها إلى مجرد فلاحة جاهلة ألقت بها المقادير في بنسيون ميرامار، فترى فيه نفسها مجرد خادمة تقول لسرحان: "أنا ماليقش لمقامك وانت من توب وانا من توب"، بينما في الرواية يقول لنفسه عنها: "لم أتصور أنها معتزة بنفسها إلى ذلك الحد"، كما قالت له "كلنا أبناء حوا وآدم". والفيلم جعل من رغبتها في التعلم: "عشان أبقى زي كل الستات وما تخجلش مني"، وهو ما يتناقض مع سبب تعلمها في الرواية ومحاولتها الارتفاع، فهي بعد التعلم ستبحث عن مهنة تتعلمها أيضًا ولن تظل خادمة، فالعلم هدف خالص، ووسيلة إلى التحرر من ربقة الوضع الطبقي المهين. بينما في الفيلم فالتعلم وسيلتها إلى الزواج بسرحان، وشتان بين الهدفين، وهو ما يجعل من العلم وسيلة مظهرية لتحقيق هدف جزئي محدود فيحط من قيمة الوسيلة بقدر ما يحط من قيمة الهدف، ويحط بالتالي من قيمة الشخصية نفسها. إن حوار زُهرة في الرواية يكشف عن سلامة المنطق، والقدرة على الاستنتاج، إلى جانب قوة الشخصية وصلابة إرادتها. أما حوار الفيلم فيدل على عكس ذلك حينما يضعها في موضع الاستجداء والضعف والسذاجة.
وفى النهاية يُعد "ميرامار" أول الأفلام التي تعمد إلى التصريح من دون الرمز أو التلميح، فى ظل وجود عبدالناصر شخصيًّا، وأول خطوة في طريق سينما الرِدة التي تتابعت حلقاتها بعد رحيل عبدالناصر عام 1970. وقد يرى البعض أن سماح الدولة بعرض وإنتاج هذه الأفلام، يُعد نوعًا من الذكاء -أو الخبث السياسي- فهذه الأفلام تتيح للجماهير أن تُفرغ شحناتها من السخط والغضب داخل قاعة العرض، من دون أي تطور حقيقي لجوهر الصراع القائم، وتجمِّل وجه النظام، وتخلع عليه قناعًا زائفًا من الديمقراطية غير المتحققة في الواقع. لكن هناك رأيًا آخر يرى أن عبدالناصر حين سمح بعرض تلك الأفلام كانت لديه رغبة في اقتلاع جذور الخوف من نفوس الجماهير والمبدعين والمثقفين لنقد ما جرى، ما فتح الباب بعدها إلى الكثير من التحولات.
المراجع:
- علي أبو شادي: السينما والسياسة، مكتبة الأسرة 2000.
- علي أبو شادي: مراجعات، Adabwafan.com
- سهير علي رجب: ما بين الزقاق والحارة... كان الكنز محفوظ
- فوزية العشماوي: المرأة في أدب نجيب محفوظ
- بهاء جاهين: نجيب محفوظ وثورة يوليو، Smartwebinline.com
- غالي شكري: نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل، Masrawy.com
- سامي الفقي: شخصيات صنعت تاريخًا (جريدة الاتحاد)
- إبراهيم فتحي: العالم الروائي عند نجيب محفوظ
- هاشم النحاس: نجيب محفوظ على الشاشة (1945-88) الألف كتاب الثاني، العدد 80.
- درية شرف الدين: السياسة والسينما في مصر 1961-1981.
- فاطمة موسى: في الرواية العربية المعاصرة، الأعمال الكاملة، ج1.
ترشيحاتنا












