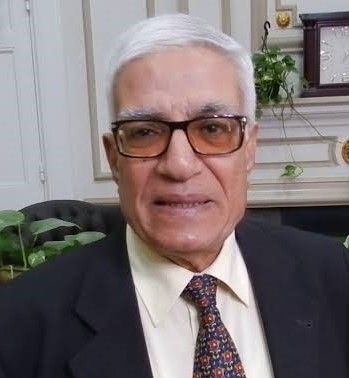دراسات
أحمد زكريا الشلقإدوارد سعيد: سنوات التكوين القاهرية (1935-1951) – الجزء الثالث
2024.08.23
تصوير آخرون
إدوارد سعيد: سنوات التكوين القاهرية (1935-1951) – الجزء الثالث
يروى إدوارد قصة التحاقه بفكتوريا كولدج بمصر في خريف 1949، وقد قارب الرابعة عشرة من عمره، وفيها قضى آخر سنتين له في القاهرة (1949-1951).. وذكر: "كنا ندرك أن القاهرة لا يمكنها أن تكون، على المدى البعيد، وطن "المستقبل" كما نتخيله، ذلك أن الأنباء عن اغتيالات وأعمال خطف غامضة معظمها لرجال مرموقين، تشهد على سطوة ملك بدين وشهواني أدت مغامراته الليلية وإجازاته الأوربية المديدة إلى تفكيك أواصر البلد، كما تضافرت فضائح حرب فلسطين عام 1948 -من صفقات الأسلحة الفاسدة، إلى الجنرالات عديمي الكفاءة- ووجود عدو قوي، على إلحاق هزيمة فادحة بالجيش المصري، وإيقاع الدولة المصرية المترنحة، التي لم تكن قد حققت استقلالها الناجز بعد، في مأزق عسير... وإذا بالصعود المفاجئ لجماعة الإخوان المسلمين يضاعف من قلقنا، نحن العرب وغير المسلمين. ثم إن الكفاح المسلح في منطقة القناة، بعد أن انتقلت معسكرات القوات البريطانية إليها، أخذت ترفع الفدائيين الذين يقاتلون الأجانب إلى مصاف الأبطال، ويسِمُ علاقاتنا بالأطباء والممرضين والمعلمين والموظفين الإنجليز في القاهرة بتوتر أشد بكثير من ذي قبل".
ويصف إدوارد مدرسة فيكتوريا كولدج بأن جهازها التعليمي كله من الإنجليز، باستثناء معلمي اللغة العربية واللغة الفرنسية، مع أنه لا يوجد فيها تلميذ إنجليزي واحد، خلافًا لما هو الحال في "إعدادية الجزيرة" وكان موقع المدرسة في البداية يقع في مبانٍ مؤقتة تابعة للمدرسة الإيطالية سابقًا بشبرا، وهي أشبه مناطق القاهرة بمدن الصفيح وأكثرها اكتظاظًا، قبل أن تنتقل إلى مبناها الجديد بالمعادي فيما بعد. ويحدثنا عن نظام المدرسة التي تضم نحو ألف صبي، وزعتهم الإدارة إلى "فرق" لمزيد من غرس إيديولوجيا الإمبراطورية البريطانية وتوطينها فيهم. وذكر إدوارد أنه كان عضوًا في فريق "كتشنر" وهناك فرق باسم كل من كرومر ودرايك.. وهلم جرًّا. وكانت فكتوريا القاهرة أقل فخامة من شقيقتها الإسكندرانية القائمة منذ ثلاثة عقود (وكان من طلبتها الملك حسين قبل تولي العرش) فكانت تضم من المعلمين الأكثر مهابة، فضلًا عن مجموعة من الأبنية الدراسية والملاعب الفائقة الجمال في العاصمة الصيفية المتوسطية الكبرى.. بينما وصف إدوارد المعلمين في فكتوريا القاهرة بأنهم من خريجي أكسفورد وكمبردج. جاءوها بعد الحرب لعدم وجود عمل لائق بهم في بلادهم، وكانوا ممن يرون التعليم في هذه المدرسة مهنة كريهة كتب عليهم ممارستها... وأضاف: "إن معظمنا يعتبر دراسة الشعر العربي من خلال القصائد الوطنية المقيتة في مديح الملك فاروق ليست أكثر من مجرد هراء.. وكان الانتماء العربي وتكلم اللغة العربية بمثابة جنحة يعاقب عليها قانون المدرسة، فلا عجب أبدًا في أن لا نتلقى أبدًا التعليم المناسب عن لغتنا وتاريخنا وثقافتنا وجغرافية بلادنا.. كانوا يمتحنوننا بصفتنا تلامذة إنجليز، نجرّ أذيالنا متخلفين سعيًا إلى تحقيق هدف مبهم يستحيل تحقيقه، بتنا ندرك أننا دونيون نواجه قوة كولونيالية جريحة وخطرة، وقابلة لأن تؤذينا ونحن مجبرون على تعلّم لغتها واستيعاب ثقافتها لكونها هي الثقافة السائدة في مصر".
ومن الطريف أنه تحدث عن عرض مدرسي راقٍ، قدمت فيه مسرحية "تنقضّ لتنتصر" مثل فيها الطالب ميشيل شلهوب (الذي صار الممثل عمر الشريف) دور السيدة هاردكاسل. وذكر أنه لم يجد خيرًا من السينما والمسرح الراقص وعروض الكباريهات مخارج لشهواته المكبوتة، فتحدث عن ذهابه إلى "كازينو بديعة" الذي كان في المكان الذي شغله شيراتون الجيزة اليوم، حيث شاهد تحية كاريوكا "أعظم راقصات زمانها ترقص ويرافقها المطرب عبدالعزيز محمود، فتلتف حوله وتتلوى ثم تدور حول محورها باتزان محكم إلى حد الكمال...".
كنا من "الشوام" مخلوقات مشرقية برمائية تتحايل على ضياعها الوجودي مؤقتًا بالنسيان وأحلام اليقظة التي تتضمن حفلات عشاء فاخرة وسهرات في المطاعم الفخمة أو في الأوبرا والبالية والحفلات الموسيقية. ولكن مع حلول الأربعينيات: "لم نعد مجرد "شوام" بل صرنا "خواجات" وهو اللقب التبجيلي الدال على الأجانب الذي يحمل دائمًا لسعة عداء عندما يستخدمه المصريون المسلمون. وعلى الرغم من أني كنت أتكلم باللهجة المصرية ولي مظهر المصري الأصلي، فقد كان ثمة ما يشي بي. وكنت أستنكر التلميح إلى أني أجنبي نوعًا ما، مع أنني أدرك في أعماقي أنهم يعتبرونني أجنبيًّا، على الرغم من أنني عربي".
وقد حدثنا عن أثر نادي التوفيقية الذي انضم والده إليه عام 1949، في زيادة الفرص أمامه لاستخدام اللغة الفرنسية فقد كان أعضاؤه من المشرقيين في تنوع يضم اليونانيين والفرنسيين والإيطاليين والمسلمين والأرمن واللبنانيين والشركس واليهود -بالمقارنة مع الطابع الإنجليزي الغالب في نادي الجزيرة- حيث كانوا يحتشدون في مكان صغير نسبيًّا في إمبابة، الضاحية الصناعية والعمالية المواجهة للزمالك عبر النيل.. ويسهب إدوارد في وصف النادي الذي كان يفتقر إلى ملاعب للبولو أو لكرة القدم أو الكريكت أو البولينج أو الإسكواش ولا يوجد فيه ميدان لركوب الخيل.. يعيش أعضاؤه حياة غير عربية وغير إسلامية، مفتوحة على الخارج، ولكنها ليست أوربية تمامًا، ويتمتعون بحرية نسبية بمعزل عن أي تدخل خارجي، ولا يتحدثون العربية إلا مع السفرجية النوبيين.
أما عن وعيه السياسي آنذاك فقد ذكر أنه في فكتوريا كولدج وحلقة أصدقاء العائلة لم يتعاطوا السياسة بأي شكل من الأشكال. غير أن خطاب القومية العربية والناصرية والماركسية قد دهمهم بعد خمس سنوات أو ست، وهم يرفلون في أوهام مبدأ اللذة والتعليم البريطاني والثقافة المترفة.. وعاد ليتذكر الفتى "شهلوب" الذي كان بمثابة رئيس للتلامذة آنذاك، وذكر أنه في احتفال بنهاية العام اعتلى المنصة حيث أعرب عن سعادته الغامرة لأنهم يتلقون ذلك التعليم الإنجليزي العظيم.. وأضاف إدوارد أنه لم يسمع عن شلهوب ثانية إلا بعد عقد من الزمن، عندما سمي "عمر الشريف" وتزوج فاتن حمامة وصار نجمًا سينمائيًّا افتتح نشاطه في الولايات المتحدة عام 1962، بفيلم "لورنس العرب" من إخراج ديفيد لين.
اكتمل تشييد المبنى المدرسي الجديد لفكتوريا بالمعادي وكان حرمها فخمًا ذا موقع ممتاز عند حدود الصحراء جهة المعادي، التي كانت ما تزال ضاحية حصرية يسكنها الأجانب وأبناء الطبقات العليا، وهي أقرب إلى مركز المعادي الهادئ وإلى محطة السكة الحديد. في خريف عام 1950، وصلت الحافلة التي أقلتهم إلى المعادي، بعد أن اكتمل بناء ثلاثة مبانٍ باتت جاهزة لاستقبالهم ابتداء من أكتوبر عام 1950.
وقدم إدوارد وصفًا تفصيليًّا للمدرسة الجديدة التي كانت "مؤسسة بريطانية فخيمة، ولكنها في نفس الوقت تعلن غطرستها وازدراءها للآخرين، وهذا ما زاد إحساسنا الجمعي بالنفور والعداء"، ولم يمر شهر حتى بدا له تدريجيًّا أن الحرم الجديد قد صمم لمراقبتهم والسيطرة عليهم أكثر منه لفائدتهم وتعليمهم، وأنه لذلك بدأ يشعر بالضيق من المدرسة الجديدة.
في عيد الميلاد من ذلك العام قضى مع والديه إجازة لبضعة أيام سافروا فيها بالقطار إلى صعيد مصر للسياحة في وادي الملوك والكرنك ومواقع أخرى، وكان انطباعه عن المنطقة أن صمتها المطبق وفراغها الكئيب أدى إلى تنفيره من مصر القديمة إلى الأبد.. (وقد سجل وصفًا للرحلة إلى الأقصر وأسوان).[1]
في تلك الفترة من حياة إدوارد في القاهرة كان والده يخطط لتسفيره إلى الولايات المتحدة منذ عودته إلى فكتوريا كولدج دون أن يذكر له شيئًا عن ذلك. وذكر أن الرواية الرسمية التي أبلغت له هي أنه مضطر إلى مغادرة مصر نهائيًّا لأن قانونًا أمريكيًّا غامضًا يقضي، لكي يحق له أن يصبح مواطنًا أمريكيًّا، بأن يعيش خمس سنوات على الأقل في الولايات المتحدة قبل بلوغه الحادية والعشرين، وأضاف: "على الرغم من أن أبي أورثني الجنسية. فصار الانتقال محتومًا لأني سأبلغ السادسة عشرة في نوفمبر 1951"!
والمعروف أنه بعد العدوان على مصر وحرب السويس عام 1956، صدر قرار بتأميم مدرسة فكتوريا كولدج، ضمن تأميم بعض المؤسسات البريطانية والفرنسية، وصار اسمها الجديد "كلية النصر". وانقطعت صلة إدوارد بها، ولم يقدر له أن يراها إلا عام 1989، عندما كان في زيارة لمصر لإلقاء سلسلة من المحاضرات، وكانت عائلته معه وأراد أن يريهم المدرسة التي طردته فيما مضى (على أثر خلاف نشب بين معلم أغضبه رفض تلاميذه قراءة شكسبير فاتهم إدوارد بأنه المتمرد الكبير وطرحه أرضًا في نوبة غضب، ثم طرد بعدها من المدرسة). فقصدها إدوارد في زيارة خاطفة، وقد ساءه أن يكتشف أن المساحة الفاصلة بين المدرسة والصحراء أصبحت مباني تعج بالبشر والغسيل المنشور والسيارات والحيوانات. وصور كيف استطاع دخول المدرسة بصعوبة في يوم العطلة (الجمعة) وكيف داهمت المكان مديرة المدرسة وطلبت منهم مغادرته فورًا، وذكر أنها: "كانت تعتمر المنديل الشرعي والجلباب الإسلامي، ورفضت السلام عليه.. وهكذا تحولت المدرسة البريطانية في مصر إلى حرم من نوع جديد، إسلامي هذه المرة". وها هو يطرد منها مرة أخرى بعد ثمانٍ وثلاثين سنة على طرده في المرة الأولى.
وذكر إدوارد أنه إلى سن الستين لم يكن يطيق التفكير في ماضيه، خصوصًا ماضيه في القاهرة والقدس. وقد احتجبت المدينتان عنه لأسباب مختلفة، القدس لأن إسرائيل حلت محل فلسطين، والقاهرة لأنه منع من دخولها لأسباب قانونية نتيجة صدفة قاسية، سيرويها لاحقًا.
وأضاف بأنه في صيف 1951 غادر مصر لقضاء أسبوعين في لبنان وثلاثة أسابيع في باريس ولندن وأسبوع واحد على الباخرة نيو أمستردام بين ساوثهامبتون ونيويورك. "بعد أن أتممت الدراسة الثانوية ونلت الشهادة الجامعية، فشهادة الدروس العليا، (أي بعد أن قضى ما مجموعه إحدى عشرة سنة) بقيت بعدها في أميركا إلى يومنا هذا.. ولما كنت قد عشت في نيويورك بإحساس مؤقت على الرغم من إقامة دامت سبعة وثلاثين عامًا، فقد فاقم ذلك من ضياعي بدلًا من مراكمة الفوائد"، وأضاف: "على الرغم من أني أمضيت ثلاثة أرباع السنة في "ماونت هيرمون" في الولايات المتحدة، فإن القاهرة كانت دائمًا هي المدينة التي تقترن في ذهني بالاستقرار".
وبالرغم من استقراره في الولايات المتحدة لاستكمال دراسته العليا، فإنه كان يتابع أخبار أسرته بالقاهرة، فذكر أنه أبلغ بأخبار حريق القاهرة في يناير 1952 واطمأن إلى أن أسرته بخير، بعد حدوث اضطرابات وحرائق في معظم أنحاء المدينة لا أحد يدري من وراءها.. وقد شعر بفزع من احتمال ألا يبقى له في القاهرة ما يعود إليه بعد رؤية مشاهد الدمار المروعة.. وتساءل عمن أشعل الحرائق: "هل هي عناصر مجهولة؟ جموع ثائرة؟ جواسيس أجانب؟ وعجزت عن تخيل الأسباب الكامنة وراء ما أشاهده على التليفزيون، وفي صحيفة بوستون جلوب، فقد صعقت لورود اسم أبي في تقرير من ثلاث صفحات يفصّل الدمار العظيم الذي وقع يوم السبت الأسود، والذي تحدث عن تعرض شركة الراية للقرطاسية لصاحبها المواطن الأمريكي ويليام أ. سعيد للنهب الكامل على يد الغوغاء.. المهم أن متجرينا الأساسيين صارا ركامًا ولكن سرعان ما أزيح الركام وأعلنوا أن العمل مستمر كالمعتاد من مكتب أبي الذي لم يتضرر، بعد أن حصل على القروض المصرفية اللازمة، إضافة إلى تعويض زهيد دفعته لجنة حكومية. وعندما وصلت إلى مصر في أواخر يناير 1952، لم يكن قد بقي فيها من آثار الحريق -الذي تبين أنه من صنع الإخوان المسلمين- إلا مجموعة من صور الخراب، جرى تأطيرها وتعليقها بالمكتب".[2]
وبعد شهور قامت ثورة الضباط الأحرار في مصر وذكر إدوارد أن الجنرال محمد نجيب أمسك بالسلطة -ووصفه بأنه جنرال أبوي ومدخن غليون- ورحل الملك فاروق إلى إيطاليا. وأضاف أنه: "قد تكوَّن انطباع لديّ ولدى أهلي وأصدقائهم بأن العهد الجديد لن يكون مختلفًا كثيرًا عمَّا سبقه، سوى أن رجالًا أصغر سنًّا وأكثر جدية سوف يتولون الأمور في مصر الآن ويضعون حدًّا للفساد لا أكثر من ذلك. وهكذا فإن جاليتنا الصغيرة من الشوام الذين يجنون أموالًا طائلة ويعيشون حياة باذخة، ظلوا يعيشون كأن شيئًا لم يكن... وعندما عاد إلى القاهرة خلال صيف 1952، سجل انطباعا نفسيًّا له دلالة مهمة عندما ذكر: "كنت أعيش على الجزء المصري من حياتي بطريقة طائشة، بينما أخذت حياتي الأمريكية تكتسب حقيقة أكثر ديمومة واستقلالًا، منفصلة عن القاهرة وعن عائلتي وعن العادات القديمة الأليفة".
لقد أنهى إدوارد دراسته في جامعة برنستون عام 1957، ثم أمضى العام التالي 1957-1958 في مصر قبل الذهاب إلى هارفارد لاستكمال دراساته العليا.
المهم أنه خلال نهاية المرحلة الأولى من الثورة المصرية ذكر: "كنا لا نزال نقيم في القاهرة، وأصبنا بعدوى الشجاعة والخطابة اللتين كانا ينم عنهما جمال عبد الناصر وهو يتحدث إلى شعبه، إلا أبي، بينما صارت أمي مؤيدًا حماسيًّا لنزعة عبد الناصر القومية.. وكانت أحيانًا تستفز الجميع، بمن فيهم أنا، بخطبها التبشيرية عن قومية عبد الناصر الاشتراكية، كانت تقول: نحن لا يحسب لنا كبير حساب دائمًا، الذين يحسب لهم حساب هم البواب والعامل والسائق، الذين غيرت إصلاحات عبد الناصر حياتهم ومنحتهم العزة والكرامة".
وفي الفصل الأخير من سيرته ذكر إدوارد أنه عندما عاد إلى القاهرة بعد التخرج اكتشف بسرعة أن ذكرياته عنها خلال منفاه الأمريكي، بوصفها مكانًا آمنًا، لم تعد صحيحة: "كان ثمة غموض مستجد يلف جنة الأجانب الهانئة وقد بدت مهددة بالزوال، ففي غضون أشهر قليلة حل عبد الناصر محل نجيب على رأس الحكومة. فإذا "بيئتنا" نحن تصير "بيئتهم هم"، و"هم" تعني المصريين الذين لم نولّهم سوى اهتمام سياسي قليل.. تكشّف لي مدى استخفاف الأجانب ذوي الامتيازات بالعالم الذي يعيشون فيه، فلا يسعون إلا إلى مصالحهم ولا يكترثون إلا بمشاريعهم التجارية دونما اعتبار للأكثرية الساحقة من السكان.. وأضاف: "من سخرية الأمور أن ثروة أبي تضاعفت على نحو كبير خلال الخمسينيات، ونما نفوذه كرجل أعمال بعد أن انفصل عن أبناء أشقائه وشركائه السابقين". وخلال العطل الصيفية من المدرسة والجامعة ازداد إنجذابي إلى تجارتنا في القاهرة، وأبي يضغط عليَّ لكي أعمل مساعدًا له خلال فترات بعد الظهر دونما تحديد لواجباتي أو مسؤولياتي، وأنا من جهتي لم أقبل تحمّل أعباء تلك المسؤولية ولا وافقت عليها من حيث المبدأ".
واستمر شعور إدوارد بالاغتراب عن عائلته وعن القاهرة يتزايد، فذكر: "عندما كنت في برنستون وقدمت شقيقتي الكبرى لمتابعة دراستها في الولايات المتحدة امتلكني شعور حاد بصعوبة الوصل معها، وأدركت آنذاك انقطاعي عن عائلتي وعن بيئتي الأصلية في القاهرة ولبنان معًا في آن واحد. فقد فطمتني سنواتي في الولايات المتحدة تدريجيًّا من عادات القاهرة -عادات الفكر والكلام والعلاقات- وببطء تبدلت لهجتي وملابسي واختلفت مقاييسي في المدرسة وبعدها في الكلية، وشهد حديثي وتفكيري تحولًا جذريًّا نأى بي بعيدًا جدًّا عن الثوابت المطمئنة لحياة القاهرة.. فبعد ماونت هيرمون انتقلت بمجهودي الخاص إلى برنستون في خريف عام 1953، وقد بتُّ أكثر استقلالًا وتدبيرًا مما كنته لسنتين خلتا.[3]
وعندما انتقل إلى الحديث عن فترة دراسته في كلية الدراسات العليا في هارفارد، ذكر أنه كان لا يزال معتمدًا ماليًّا على تجارة أبيه في مصر: "التي كانت تتلقى ضربات قوانين عبد الناصر الاشتراكية والتأميمات، وخصوصًا تحريم حيازة الحسابات المصرفية الخارجية التي تقوم عليها تجارتنا أصلًا. وما إن وصلت القاهرة حتى انتابني شعور بالتهديد والقلق إلى درجة أني حسبته لا يتأتى إلا من شعور بالاقتلاع من الجذور، مما لنا من جذور في مصر. فإلى أين يمكن لعائلتي أن تغادر؟ بعد أيام قليلة هَدأت من روعي وتائر المدينة الخالدة -الناس والنهر ومعارفي في نادي الجزيرة وحتى زحمة السير، وبالتأكيد الأهرامات التى كنت أستطيع مشاهدتها من نافذة غرفتي- ومهما يكن من أمر التناقضات والهواجس، فقد انسقت بهدوء إلى روتين الدوام اليومي في شركة أبي وأنا لا أملك إلا القليل القليل مما أؤديه فيها".
وفي هذه الفترة كان إدوارد قد نال شهادة الدراسات العليا وبدأ العمل في التدريس بجامعة كولومبيا.. لكن مشاعره باتت ممزقة بين غرائز متضاربة، أيستمر في العمل بالولايات المتحدة الأمريكية أم يعود إلى القاهرة؟ إلى أن: "اتخذت قرارًا مشتركًا مع أهلي بضرورة العودة إلى القاهرة لمدة سنة واختبار الحياة القاهرية التي سوف أعيشها فيما لو قررت أن أتسلم تجارة أبي..". لكنه ما لبث أن تبين أن عام 1957-1958 انتهى بعدد من الأبواب المغلقة، لذلك رأى إدوارد أنه لن يستطيع أن يعمل في شركة أسسها أبوه وامتلكها. ومع ذلك لم يلبث أن رضخ لإرادة والده الذي يريده أن يعمل معه، لمجرد أنه ابنه فقط.
في صيف عام 1960 عندما أدت "الاشتراكية العربية لعبد الناصر" إلى تحريم المبادلات الخارجية بالعملة الصعبة والمستوردات التي تتم تلك المبادلات من أجلها. لجأ والده إلى اتفاقات المقايضة الثلاثية أو الرباعية، وكان يعقد الصفقات مع وسيطه ومعاونه "دانيال" ما جعل إدوارد يتساءل عن مدى شرعية ما يقومان به وعمَّا إذا كانت الصفقات تتحايل بوضوح على القيود والتحريمات الموضوعة قي طريق المستوردين من أمثال أبيه، الذي كان يلجأ إلى مزيد من التلاعبات المعقدة ليحصل على ما يلزمه من المواد الخام من الخارج، وذكر أن والده كان يستمتع بتعقيد ما يقوم به، وأنه قد لجأ إلى تعيينه نائبًا لرئيس الشركة ليكون أحد المديرين التنفيذيين بها. ولم يلبث والده أن أرسل إليه عقودًا ليوقعها بحكم منصبه، ففعل ذلك ببساطة، ما أدى إلى تدخل الشرطة المصرية التي كشفت هذا التلاعب واتهمت إدوارد بخرق قانون الرقابة على العملة. وهكذا تورط الابن في ارتكاب هذا الخرق "معتقدًا أن الشرطة المصرية هي الملامة بسبب حماستها الزائدة والمفرطة، وليس والده الذي لم يكترث بمصيره، مما ترتب عليه أن منع إدوارد لمدة خمس عشر سنة "من دخول القاهرة، المدينة الوحيدة في العالم التي أشعر فيها بأني في بيتي..".
وكتب: "هكذا بدأ عالم القاهرة ينغلق علينا مهددًا، بل بدأ يتفكك، بينما الهجوم الناصري يزحف مطاولًا، لا الطبقات الميسورة وحدها، وإنما المنشقين اليساريين من أمثال فريد حداد، لقد أدركت إثر موت فريد ومحاكمة جورج فاهوم بتهمة "الفساد التجاري" أن أيامنا كمقيمين أجانب في القاهرة قد أشرفت أخيرًا على نهايتها. لقد ساد جو ثقيل من التوجس والإحباط حلقة أصدقاء أبي، فأعد معظمهم الترتيبات لمغادرة القاهرة، وسافر معظمهم فعلًا إلى لبنان أو أوروبا. وكتب إدوارد: "ولمَّا كان الشرق الأوسط ينأى أبعد وأبعد عن وعيي، فإنني لم أكن أقرأ بالعربية حينها ولا كنت أعرف أيًّا من العرب".
وقد يبدو ذلك أمرًا مثيرًا للدهشة والغرابة، من كاتب مشتغل بالأدب والنقد الأدبي تدريسًا وكتابة، عاصر طائفة كبيرة من المبدعين المصريين والعرب ممن اهتم بكتاباتهم نقاد وكتاب ومفكرون أوربيون وأمريكيون، بينما انصرف إدوارد عنهم واهتم بما كتب بغير لغته العربية.. وربما كانت تلك إحدى أزماته.
وفي الصفحات الأخيرة من سيرته الذاتية عبَّر إدوارد عن حزنه العميق لحرمانه من القاهرة ومن وطنه فلسطين: "وأصبحت قادرًا على أن أتبين بوضوح أكبر وقع خسارة القاهرة ووقع الخسارة المستمرة لفلسطين، على حياتنا وحياة سائر أقربائنا. وحمل عام 1967 مزيدًا من التفكك، وقد بدا لي أنه يجسد بامتياز التفكك الذي يختزل سائر الخسائر الأخرى: "لم أعد الإنسان ذاته بعد عام 1967. فقد دفعتني صدمة الحرب إلى نقطة البداية، إلى الصراع على فلسطين، ودخلت من ثم إلى المشهد الشرق أوسطي المتحول حديثًا بوصفي جزءًا من الحركة الوطنية الفلسطينية التي انبثقت في عمَّان ومنها انتقلت إلى بيروت في أواخر الستينيات وعلى امتداد السبعينيات".
واختتم إدوارد سعيد سيرته بمونولوج حزين قال فيه : "خير لي أن أهيم على وجهي في غير مكاني، وأن لا أملك بيتًا ولا أشعر أبدًا كأني في بيتي في أي مكان، خصوصًا في مدينة مثل نيويورك حيث سأعيش إلى حين وفاتي".
* * *
1- إدوارد سعيد، خارج المكان، ص 259-260.
2- المرجع السابق، 292-300.
3- المرجع السابق، 333-334.
ترشيحاتنا