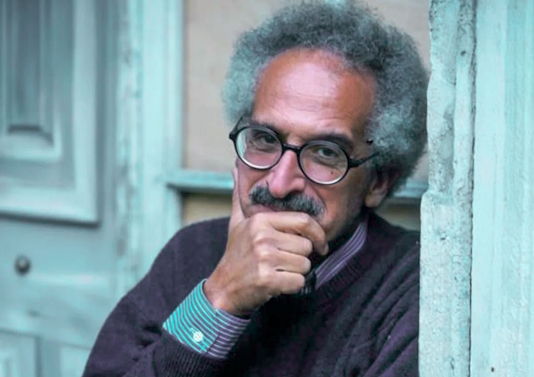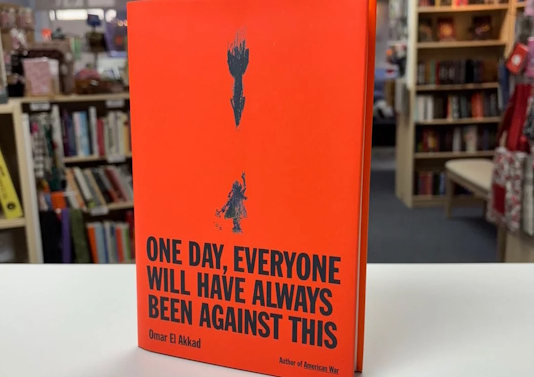هوامش
شريف إمامالقضيَّة الفلسطينيَّة في مَناهج التَّعليم الجامعيّ المِصريّة – الجزء الثاني
2025.10.12
القضيَّة الفلسطينيَّة في مَناهج التَّعليم الجامعيّ المِصريّة – الجزء الثاني
عندما التقى الرئيس السادات، أول مرة، رئيس الوزراء الإسرائيليّ مناحيم بيجن في الإسماعلية، ديسمبر 1977، بدا الأخير مذهولًا من مرونة الرئيس المصري، وهاله أن سمع محدثه يقول إنه يقول للرافضين من الدول العربية لمسار السلام الذي آمن به: «لا تضغطوا علينا كثيرًا، وإلا سنقرر أننا لم نعد عربًا(( [1] » ((Foreign Relations, 1981, p: 893.
عمليًّا، ألقت التوترات السياسية التي تبعت زيارة السادات إلى القدس بظلالها على تناول المقررات الجامعية المصرية لقضية القدس، وكانت أولى الإجراءات، إيقاف تدريس مادة المجتمع العربيّ كمقرر إلزاميّ في الجامعات المصرية، وذلك أواخر السبعينيات. يضاف إلى ذلك ما أشارت إليه دراسة سعيد نوفل من غياب تدريس القضية الفلسطينيَّة في مساقات مستقلة في التعليم الجامعي المصري في الثمانينيات، ففي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، اقتصر تدريسها في أقسام العلوم السياسية ضمن مقرر مشكلات معاصرة، (نوفل، 1989، ص: 7). وفي أقسام التاريخ بكليات الآداب والتربية، اقتصر تدريسها ضمن مقررات تاريخ العرب الحديث والمعاصر، أو المشرق العربي المعاصر أو تاريخ العرب المعاصر. أما أقسام اللغات الشرقية والعبرية بكليات الآداب وغيرها، فلم يركز واضعو المقررات في تدريس الصهيونيَّة والقضية الفلسطينيَّة، من خلال تدريس السياسة أو التاريخ؛ لقد ركزوا في الواقع على فهم الصهيونيَّة من خلال تحليل الأدب العبريّ الحديث. لقد اختاروا القصائد والقصص القصيرة والروايات كمواد مرجعية لتعريف الصهيونيَّة والصهاينة (Abukhadra, 2019, p: 231).
وانعكس الواقع السياسي ما بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، كذلك على مسارات البحث العلمي في المؤسسات الجامعية المصرية. فعلى سبيل المثال، عندما تأسس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس في ديسمبر 1967، كانت من أولى أعماله إصدار كتيبات تعريفية بالقضية الفلسطينية (تقرير رئيس الجامعة، 1969، ص: 58). وقد ألهم نجاح المركز عددًا من الكُتّاب للمطالبة بإنشاء مركز متخصص للدراسات العبرية والصهيونية في مصر، بهدف فهم العقلية الإسرائيلية كأحد أهم عناصر مواجهة العدو (العطيفي، 19 أكتوبر 1968). لكن هذا التوجه تغيّر بعد أن سلكت مصر طريق الحل المنفرد للصراع العربي الإسرائيلي. وسرعان ما أيّد مركز دراسات الشرق الأوسط خطوات كامب ديفيد، وأصدر دراسة تشرحها وتبررها بعد أيام قليلة من توقيع الاتفاقية (صلاح العقاد وآخرون، 1978).
وإذا انتقلنا إلى وضع القضية الفلسطينيَّة في أقسام التاريخ، فقد ظلت تُدرس ضمن تاريخ العرب الحديث والمعاصر ولم يفرد لها مقرر مستقل، لكن الدراسة الوصفية للطريقة التي عُولجت بها القضية في فترة الستينيات ومنتصف السبعينيات عن الفترة التي تلتها، تشي بوجود اختلاف في الكم والكيف. ففي جامعة القاهرة كان معالجة القضية الفلسطينيَّة يتم ضمن تاريخ المشرق الحديث والمعاصر، وكان الكتاب المقرر في تلك الفترة هو «المشرق العربيّ في التاريخ الحديث والمعاصر»، من تأليف الدكتور محمد أنيس والدكتور رجب حراز، واستحوذت القضية الفلسطينيَّة على أكثر 15% من موضوعات الكتاب، البالغ 620 صفحة. وجاءت في إطار فصلين، الأول بعنوان «تصريح بلفور»، والثاني «فلسطين وشرق الأردن بين الحربين»، أما أهم المحاور التي عالجها الكتاب، فكانت:
- بداية الحركة الصهيونيَّة وأصولها.
- العلاقة الوجودية بين الصهيونيَّة والاستعمار.
- صدور وعد بلفور، بداية الهجرة اليهودية.
- عهد الانتداب والانتقاضات العربية.
- علاقة أمريكا بالصهيونيَّة.
واعتمد المؤلفان على مادة وثائقية ومصدرية، منها الوثائق التي نشرها جاكوب هورويتز تحت عنوان Diplomacy in the Near and Middle East A Documentary Record، وكذلك مذكرات المفتي أمين الحسيني -كانت وقتها منشورة في شكل حلقات بجريدة أخبار اليوم- ومذكرات الجنرال جلوب باشا ولويد جورج وغيرهم (أنيس وحراز، 1967، ص: 392 وما بعدها).
أما فترة منتصف الثمانينيات والتسعينيات، فإن الأستاذ المتخصص في تاريخ العرب في جامعة القاهرة وقتها كان الدكتور عبد العليم أبو هيكل، وكان كتابه عن تاريخ العرب المعاصر -الذي دُرس في الجامعة وقتها- لا يزيد على 23% من حجم كتاب الدكتور أنيس وحراز، واحتلت القضية الفلسطينيَّة فيه مساحة لا تزيد على 9.3% من حجم الكتاب. (أبو هيكل، 1991، ص: ص 43، 57).
والأمر نفسه في الجامعة الثانية في مصر، عين شمس. فإذا نظرنا على سبيل المثال، إلى تدريس القضية الفلسطينيَّة في قسم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس، فإنها كانت تُدرس في إطار مقرر المشرق العربيّ المعاصر، وكان مؤلف الكتاب المقرر الدكتور صلاح العقاد، وبالنظر إلى محتوى الكتاب الصادر عام 1970، فإن حجم القضية كان قرابة 25% من هذا الكتاب البالغ عدد صفحاته 638 صفحة، ولقد سمح حجم الكتاب والمساحة الممنوحة للقضية في تقديم معالجة شاملة ارتكزت على ثمانية محاور (العقاد، 1970):
- عرض لتطور القضية الفلسطينيَّة من الانتداب إلى حرب 1948.
- إعطاء مساحة للثورات الفلسطينيَّة في ظل الانتداب.
- شرح شامل لملابسات الحرب والمواقف العربية.
- تبني بعض الأطاريح الحديثة عن أكذوبة التفوق العددي للعرب في الحرب.
- مناقشة بعض الأفكار المغلوطة مثل بيع الفلسطينيين أرضهم لليهود.
- إبراز بعض القضايا المعاصرة وقتها: قضية اللاجئين.
- التركيز على أن الصهيونيَّة خطر على كل الدول العربية: إعطاء مثال بقضية تحويل مجرى نهر الأردن.
- التوسع في عرض الأمثلة على الدعم الغربيّ غير المحدود لليهود.
ظل كتاب الدكتور العقاد يُدرس حتى الثمانينيات، بينما شهدت الفترة التي تلته تضاؤل حجم الكتاب الجامعي وتقلص حجم القضية الفلسطينيَّة فيه، بل شهدت بعض الكتب الدراسية الخاصة بتاريخ العرب المعاصر في جامعة عين شمس تغييبًا للقضية الفلسطينيَّة بالكلية، كما في المقرر الذي كان يُدرس بكلية الآداب جامعة عين شمس بداية الثمانينيات، الذي اقتصر مؤلفه على تاريخ المغرب العربيّ المعاصر فقط (طه، 1984). وفي جامعة الإسكندرية، درس الدكتور محمود السروجي كتاب تاريخ العرب الحديث والمعاصر لطلاب قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ورغم صغر حجم الكتاب الذي لم يزد على 180 صفحة، فإن حجم القضية الفلسطينية فيه جاء كبيرًا (24% من حجم الكتاب)، (السروجي، ب ت)، وتبعه الدكتور عمر عبد العزيز في مقرر تاريخ المشرق العربيّ الحديث، (عمر، 1984).
وظل هذا الكتاب المقرر الجامعي في قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية طوال السبعينيات والثمانينيات، ونظرًا إلى وقوفه عند أوائل عشرينيات القرن العشرين، فإن معالجة القضية الفلسطينيَّة جاءت مبتسرة، ومثلت 8% من حجمه البالغ أكثر من 500 صفحة، واحتلت القضية الفصلين الأخيرين، وهما الحركة الصهيونيَّة والعرب، بريطانيا وتصريح بلفور. أما جامعة الأزهر، فإن الكتاب المقرر على طلاب قسم التاريخ في تاريخ العرب، كان كتاب الدكتور محمود صالح المنسي «تاريخ المشرق العربيّ الحديث» وعلى الرغم من ضعف حصة القضية الفلسطينيَّة فيه، فإنها جاءت وثائقية وفيها اختصار وافٍ لكتابات الدكتور المنسي في قضايا تتعلق بالقضية الفلسطينيَّة، وأهمها دراسته عن وعد بلفور (المنسي، 1990).
على كلٍّ، يمكن النظر إلى فترة ما بعد كامب ديفيد، على أن تقزُّم القضية الفلسطينيَّة في الخطاب السياسيّ المصري، أدى إلى ضعف حضورها في المناهج التعليمية الجامعية، ولمَّا كانت جامعات مصر من المقاصد المفضلة للطلاب الفلسطينيين، فإن تحولات ما بعد كامب ديفيد كانت ضمن مجموعة من العوامل الأخرى التي أسهمت في نضج فكرة الجامعة الفلسطينيَّة المفتوحة، حيث وافق الصندوق العربيّ عام 1979 على تحويل دراسة الجدوى التي عهد بها إلى اليونسكو إلى لجنة خبراء معظمهم من الفلسطينيين إلى مشروع إنشاء الجامعة، وإن تأخر التنفيذ لفترة ليست بالقصيرة (جمعية الخريجين في الكويت، 1989، ص: 224).
البحث العلمي يتغلب على التقزيم
يمكن أن نرصد وضع القضية الفلسطينيَّة في الجامعات من خلال زاوية أخرى، وهي الرسائل الأكاديمية التي عالجت القضية وتفاصيلها، فقد تميزت فترة نهاية الستينيات حتى أوائل الثمانينيات، بزيادة كبيرة في حجم الرسائل العلمية التي نوقشت في مواضيع تتعلق بالقضية الفلسطينيَّة، فبحسب كشاف الرسائل العلمية الذي وضعته الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عن الرسائل التي أجيزت بالجامعات المصرية، (الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، 1967، ص: 396). يمكن رصد 18 دراسة:
1. صالح سعود أبو يصير (1967)، جهاد شعب فلسطين (17/ 1948)، كلية اللغة العربية بالأزهر، ماجستير، إشراف الدكتور عبد العزيز الشناوي.
2. حسين صبري الخولي (1967)، سياسة الاستعمار والصهيونيَّة تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، كلية اللغة العربية بالأزهر، دكتوراه، إشراف الدكتور عبد العزيز الشناوي.
3. وليم فهمي (1969)، الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة. رسالة ماجستير. معهد البحوث والدراسات العربية. إشراف: د. صلاح العقاد.
أما فترة السبعينيات، فهناك تطور كمي وكيفي في معالجة القضية الفلسطينيَّة نذكر على سبيل المثال:
4. عبد العزيز محمد عوض (1970)، متصرفية القدس في العهد العثماني 1874-1914، دكتوراه كلية الآداب جامعة عين شمس، إشراف الدكتور أحمد عزت عبد الكريم.
5. عادل غنيم (1970)، الحركة الوطنية الفلسطينيَّة من 1917 حتى 1936، ماجستير كلية الآداب جامعة القاهرة، إشراف الدكتور محمد أنيس.
6. محمد عبد الرؤوف سليم (1970)، تاريخ الحركة الصهيونيَّة الحديثة 1914-1918، ماجستير معهد البحوث والدراسات العربية، إشراف الدكتور أحمد عزت عبد الكريم.
7. محمد كمال يحيى (1973)، الاتحاد السوفييتي وفلسطين حتى قيام إسرائيل، ماجستير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إشراف الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى.
8. إبراهيم رضوان الجندي (1975)، سياسة الانتداب البريطاني الاقتصادي في فلسطين، ماجستير كلية الآداب جامعة الإسكندرية، إشراف الدكتور عمر عبد العزيز عمر.
9. عواطف محمد عبد الرحمن (1975)، اتجاهات الصحافة المصرية إزاء القضية الفلسطينيَّة 1922- 1936، دكتوراه كلية الإعلام جامعة القاهرة، إشراف الدكتور عبد الملك عودة.
10. عادل غنيم (1976)، الحركة الوطنية الفلسطينيَّة من 1936 إلى الحرب العالمية الثانية، دكتوراه كلية الآداب جامعة القاهرة، إشراف الدكتور محمد أنيس.
11. محمد نصر مهنا (1976)، مشكلة فلسطين أمام الرأي العام العالمي 1945-1967، دكتوراه كلية الآداب جامعة عين شمس، إشراف الدكتور جلال يحيى.
12. محمد عبد الرؤوف سليم (1977)، نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها حتى قيام إسرائيل 1922-1948، دكتوراه كلية الآداب جامعة عين شمس، إشراف الدكتور أحمد عزت عبد الكريم.
13. ظفر الإسلام حنان (1978)، تاريخ المقاومة الفلسطينيَّة 1917-1935، ماجستير كليه دار علوم جامعة القاهرة، إشراف الدكتور إبراهيم أحمد العدوي.
14. محمد شاكر مشعل (1978)، أثر الصهيونية العالمية على العلاقات العربية الأمريكيه، ماجستير كلية الآداب جامعة عين شمس، إشراف الدكتور جمال زكريا قاسم.
15. وليد سليم عبد الحي (1979)، مشروعات التسوية السياسية للصراع العربي الإسرائيلي 1967-1978 إشراف إبراهيم صقر.
16. بهجت حسين صبري (1979)، فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى، ماجستير كلية الآداب جامعة عين شمس، إشراف الدكتور أحمد عزت عبد الكريم.
17. محمد كمال يحيى (1979)، الاتحاد السوفييتي والقضية الفلسطينيَّة 1967:1948، دكتوراه كلية الآداب جامعة عين شمس، إشراف الدكتور أحمد عزت عبد الكريم.
18. محمد على حُلة (1982)، الثورة الفلسطينيَّة الكبرى (1936/1939)، دكتوراه كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، إشراف الدكتور محمود صالح المنسي. (مؤنس، 1998، ص: 198، 201)
أما فترة الثمانينيات وما بعدها، فشهدت انخفاضًا كيفيًّا وكميًّا في الرسائل الخاصة بالقضية الفلسطينيَّة، بل جنح بعضها إلى اجترار الدراسات السابقة، وزاد التركيز في علاقة مصر بالقضية ورصد الصحافة المصرية لها، ودور بعض الرؤساء والزعماء المصريين في خدمة القضية، وما شابه ذلك من الدراسات الموجهة والبعيدة عن تطورات القضية الداخلية وتفاعلاتها.
وهكذا يكون مسار كامب ديفيد قد ألقى بظلاله على وضع القضية الفلسطينيَّة في المناهج الجامعية المصرية خصوصًا مع طوفان التطبيع الثقافيّ الذي تورطت فيه مؤسسات بحثية وجامعات، ويظهر أثر ثمار هذا المسار اليوم مع التغييرات الجديدة في الكتب المدرسية، ما قبل الجامعية وإعادة رسم صورة الإسرائيليّ في الذهنية المصرية كشريك في عملية السلام الضرورية لرخاء الأمة المصرية (Winter 2016, PP. 61,70).
في المقابل، ظل التعليم الإسرائيلي، حتى بعد توقيع معاهدة السلام، أمينًا على المفاهيم الأساسية التي وضعتها الصهيونيَّة للعملية التعليمية، فالعرب متخلفون وجبناء ومحتلون لأرض إسرائيل التاريخية (سمعان، 2004، ص: 190).
([1]) Don’t press us too far, or we will decide that we are no longer Arabs.
ترشيحاتنا