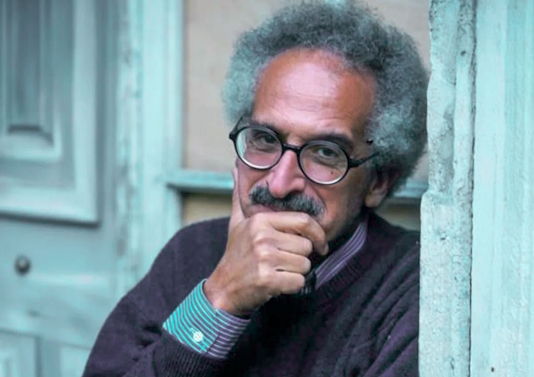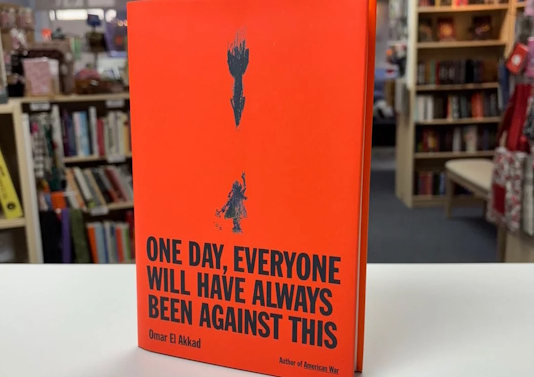دراسات
شريف إمامالقضيَّة الفلسطينيَّة في مَناهج التَّعليم الجامعيّ المِصريّة – الجزء الأول
2025.10.05
مصدر الصورة : آخرون
القضيَّة الفلسطينيَّة في مَناهج التَّعليم الجامعيّ المِصريّة – الجزء الأول
تُمثِّل المناهج التعليمية الداعم الأساسي لإعداد الأجيال القادمة، وتأهيلها لتكون قادرة على العمل المنتج البناء، من أجل إحداث النقلة المطلوبة للمجتمع من التخلف إلى الرفاه الاقتصادي، ومن النظر إلى المصلحة الخاصة إلى مراعاة المصالح الوطنية العامة.
ويُنظر إلى المقرر الدراسي باعتباره حلقة وصل بين فلسفة التربية وأُطرها النظرية والفكرية القائمة على أسس قيمية، ومجتمعية، وثقافية، ونفسية، وبين التعليم باعتباره الجانب التطبيقي لكل ما سبق؛ لذا فإنه من أجل تعزيز الهوية الوطنية للطالب يكون من المفيد أن تشتمل المقررات الدراسية على مجموعة من النصوص المباشرة أو الضمنية التي توضح للطلبة أهمية تَمثُّل واكتساب قيم الهوية (الخطيب، 2020، ص: 158).
ولمَّا كان الوعي العربيّ والإسلاميّ لا يتناقض مع الوعي الوطنيّ «القُطري»، بل هو جزء لا يتجزأ منه. لذا، كانت إسرائيل والصهيونيَّة العدو الرئيس للعرب، واحتلت القدس وقضية فلسطين موقع الصدارة في هذا الوعي العربي، بل إن الصراع ضد الصهيونيَّة، أدى دورًا مهمًّا في إيقاظ الوعي القومي العربيّ والإسلامي، بسبب ما تمثله «إسرائيل» من خطر على شعوب تلك الأقطار، وكانت قضية القدس مركز التضامن القوميّ بينها ومحور الإجماع الوطنى، بل حرصت بعض الأنظمة العربية على أخذ شرعيتها من خلال العمل -ولو ظاهريًّا- ضد إسرائيل (نوفل، 2010، ص: 10).
ومن ثمَّ، فإن طرح مسألة تدريس القضية الفلسطينيَّة في الجامعات العربية عمومًا والمصرية خصوصًا ارتبط بحركة المد القوميّ، الذي اختلطت فيه الرغبة في تأكيد الذات الوطنية القطرية بعد الاستقلال، بالسعي للحفاظ على الاستقلال من خلال الارتباط في دائرة أكبر من التضامن، وهي المحيط العربيّ والإسلامي (ياسين، 1976، ص: 105).
ففي أواخر 1952 عُقِدَ المؤتمر الأول لوزراء المعارف العرب، ووافق المجتمعون على تدريس القضية الفلسطينيَّة في المدارس والمعاهد العليا العربية والنظر في وضع مناهج وكتب موحدة لهذا الغرض تُدرَّس في سائر البلاد العربية (الحصري، 1954، ص: 426). وأعادت اللجنة الثقافية للجامعة العربية عام 1954 تأكيد المعنى ذاته، وخصَّت المعاهد العليا والجامعات بالتشديد على القيام بدورها في تدريس القضية الفلسطينيَّة كمقرر أساسيّ للشباب العربيّ (ياسين، 1976، ص: 105). لكن هذا المقرر لم يُنفذ. فأعاد المؤرخ أكرم زعيتر تأكيده في مقدمة كتابه القضية الفلسطينيَّة قائلًا: «إذا كان العدو قد اغتصب هذه البقعة الغالية المقدسة؛ فإن الواجب القوميّ يحتم علينا أن نُبقي اسم فلسطين على الأفواه ورسمها في الأفئدة، ومن أهم السبل إلى ذلك تدريس القضية الفلسطينية في المدارس الثانوية والعُليا في الأقطار العربية؛ ليقف أبناء الجيل على مبلغ الخطر الذي يهدد أمتهم، ولتتأصل فيهم العقيدة التي تؤهلهم لأن يؤدوا واجبهم الوطني على الوجه الأكمل». (زعيتر، 1955، ص: 5).
وتهدف هذه الورقة (المكونة من 3 أجزاء)، إلى تتبَّع معالجة المناهج في الجامعات المصرية للقضية الفلسطينيَّة، وأثر التقاطعات السياسية في تلك المعالجة، كما تحاول رصد ما أفرزته الدراسات الميدانية عن مدى الوعي لدى الشباب المصريّ الجامعيّ بتلك القضية، وتعطي الدراسة مسحًا للمساقات التي تُطرح فيها القضية الفلسطينيَّة في المناهج الجامعية المصرية، مع وضع أهم الاستنتاجات التي خلَصت إليها الورقة.
مرحلة القومية العربية: تجربة مقرر المجتمع العربي
سلَخت ثورة يوليو عامين منذ وقُوعها بلا سياسة عربية واضحة، فلقد أثقلتها تَركة النظام الملكي، من احتلالٍ رابض على تراب الوطن، ومؤسسات دولة يعتريها الفساد، وبناء اقتصاديّ واجتماعيّ مُشوّه (إمام، 2022، ص: 143). ولم تتبنَ مصر خطابًا قوميًّا واضحًا إلا في أعقاب عدوان 1956، وما إن تووِّج هذا الخطاب بأكبر نجاحاته، توقيع الوحدة المصرية السورية عام 1958، حتى أمست القومية العربية إحدى ركائز النظام السياسيّ المصري (نصر، 1990، ص: 117).
ولمَّا كانت القضية الفلسطينيَّة الجامعة لكل العرب، فقد أوْلى عبد الناصر لها اهتمامًا خاصًّا في إطار مشروعه القومي. وسريعًا جاءت الخطوة الأولى لتدريس القضية الفلسطينيَّة في الجامعات المصرية عام 1958، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة في شأن تنظيم الجامعات، ونص على تدريس مادة المجتمع العربيّ بالسنة الأولى في جميع كليات الجامعات بالجمهورية (الجريدة الرسمية، العدد 32، ص: 21). ونظرًا إلى تأخر صدور اللائحة المشار إليها، لم يبدأ تدريس المادة المستحدثة إلا في العام التالي. وقد شمل مقرر المجتمع العربيّ ضمن عناصره معالجة للقضية الفلسطينيَّة ومراحل تطورها، وإن اختلف حجم المساحة الممنوحة لها من كتاب إلى آخر. فمنذ إقرار تدريس هذا المقرر تباينت الرؤى بشأن الآلية التي سيُدرس بها، أو إن كان سيتضمن تدريسها كتابًا موحدًا تلزم به الجامعات المصرية أم لا، وكان آخر ما انتهت إليه المناقشات أن تُشكَّل في كل جامعة من جامعات الجمهورية العربية المتحدة لجنة تتولى الإشراف على تدريس مادة «المجتمع العربي»، وألا يحصر الطلاب دراسة المادة في كتاب معين (الجرف، 1967، ص: ص 11، 15).
وشهدت أوائل الستينيات موجة من التأليف في موضوع المجتمع العربي؛ نذكر منها على سبيل:
- أحمد سويلم العمري، بحوث في المجتمع العربي (1960).
- سليمان الطماوي، التطور السياسيّ للمجتمع العربيّ (1961).
- محمد كامل ليلة، المجتمع العربيّ والقومية العربية (1962).
- فؤاد العطار، المجتمع العربيّ (1963).
- على فؤاد أحمد، المجتمع العربيّ والقومية العربية (1964).
- طعيمة الجرف، أبحاث في المجتمع العربى: القومية العربية والتطور السياسيّ العربي (1964).
- محمود حلمي، المجتمع العربيّ (1965).
وبالإضافة إلى هذه الجهود الفردية كانت هناك جهود جماعية خرجت عن أقسام التاريخ والعلوم السياسية وكليات الحقوق في الجامعات المصرية، مثل: 1) كتاب المجتمع العربيّ، الذي وضعه مجموعة من أساتذة جامعة القاهرة برئاسة السيد الباز العريني (1960). 2) كتاب المجتمع العربيّ، الذي وضعه حسن سعفان شحاته وآخرون (1960)، ودُرّس في جامعة بيروت العربية بالإسكندرية (1960)، وكذلك الحال كتاب المجتمع العربيّ الذي وضعه أساتذة كلية الآداب جامعة عين شمس.
وقد تراوحت مساحة معالجة القضية الفلسطينيَّة في تلك الدراسات بين عدة ورقات محدودة، لا تتجاوز 0.5% في كتاب أحمد سويلم العمري، وبين مساحة كبيرة وصلت إلى 20% من المقرر كما في كتاب المجتمع العربيّ، الذي دُرس في جامعة بيروت العربية بالإسكندرية، وعكف على وضع هذا الجزء الدكتور حسن صبحي مدرس التاريخ الحديث والمعاصر وقتها، بل وصلت النسبة إلى 30% من المقرر في كتاب المجتمع العربيّ الحديث للدكتور محمد ضياء الريس الأستاذ بكلية دار العلوم.
ومن خلال إجراء دراسة لعشرة كتب كانت تحمل اسم المجتمع العربيّ، نجد أن كتَّابها كانوا ثلاثة أصناف: بعضهم أساتذة في العلوم السياسية، مثل: الدكتور سويلم العمري، والدكتور عبد الملك عودة وغيرهما، وآخرون أساتذة في القانون، كالدكتور طعيمة الجرف والدكتور سليمان الطماوي وغيرهما، وثالثهم أساتذة في أقسام التاريخ، كالدكتور الباز العريني والدكتور حسن صبحي وغيرهما. ولم تكن الأصناف الثلاثة سواء في معالجتهم للقضية في سياق المقرر، فقد عرض الكُتَّاب للقضية من موقع تخصصهم الأكاديمي، ووجدت القضية في كتابات رجال التاريخ فضاءً أرحب ومساحةً أوسع من أساتذة العلوم السياسية، بينما انحصرت النسبة في مؤلفات بعض القانونيين. وينبغي التشديد على أن مادة المجتمع العربيّ كانت تُدرس على طلاب جامعة الأزهر أيضًا، ويُعدّ كتاب الدكتور محمود حلمي من أوائل الكتب الأزهرية التي وضعت لهذا الغرض، وكانت القضية الفلسطينيَّة حاضرة وبقوة فيه (حلمي، 1965، ص: 7).
ويمكن النظر إلى عام 1964 على أنه كان حاسمًا في زيادة مساحة القضية الفلسطينيَّة في مقرر المجتمع العربي، وذلك بعد قرار الدولة المصرية جعل ثورة يوليو 1952 مقررًا مستقلًّا، فخرج من مجال دراسات المجتمع العربيّ كل ما يتصل بهذا الثورة تفصيليًّا (الجرف، 1967، ص: 15). وأُفرغت مساحة أكبر للقضية الفلسطينيَّة، خصوصًا مع ارتفاع وهج القومية العربية في خطاب ناصر، وبدأ يرى أنه إذا كان الاستعمار يشكل خطرًا على حرية الأمة العربية وتقدمها ووحدتها وحتى بقائها؛ فإن إسرائيل هي أشد خطرًا، فإسرائيل عائق جغرافي أمام تحقيق الوحدة العربية (نصر، 1990، ص: 395).
كما سبق هذا التاريخ بعام، تأسيس قسم جديد لتدريس قضية فلسطين في معهد الدراسات العربية؛ وذلك بعد عشر سنوات من تأسيس المعهد (الأهرام الاقتصادي، 15 أكتوبر 1973، ص: 38). ولقد نجح المعهد بعد فترة وجيزة في إجازة عدد من الرسائل الجامعية الخاصة بالقضية الفلسطينيَّة، لعل أهمهما في الفترة المبكرة دراسة وليم فهمي حنا (1969) «الهجرة اليهوديّة الى فلسطين المحتلة».
بالعودة إلى الكتب الجامعيّة الخاصة بمقرر المجتمع العربيّ، فإن معالجة القضيّة الفلسطينيَّة فيها جاءت على صورتين: أَولهما، تحت عنوان مستقل، مثل: فلسطين والمؤامرة الصهيونيَّة الاستعمارية، أو ضمن التحديات التي تواجه العالم العربيّ أو في سياق تتطور العالم العربيّ في القرنين التاسع عشر والعشرين.
وإذا أردنا أن نُقدم صورة وصفية لطريقة عرض القضية الفلسطينيَّة في مقرر المجتمع العربي، فإننا يمكن أن نعطي المثال بثلاثة كتبٍ مُتباينات، من حيث خلفية مؤلفيها الأكاديمية، والكليات التي كانت تُدرس فيها:
الأول، كتاب بحوث في المجتمع العربيّ، الذي كان يُدرس بكلية العلوم السياسية، التي أنشئت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بموجب قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1911 لسنة 1959، على غرار مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وكان أول عام دراسيّ لها هو 59/1960، وشهد تدريس المادة بالقاهرة عام 1960، ومؤلف الكتاب أول رئيس لقسم العلوم السياسية بالكلية وهو الدكتور أحمد سويلم العمري، وجاء عرض القضية في الفصل الخامس من الباب الرابع من الكتاب، تحت عنوان «نشأة إسرائيل»، عرض المؤلف لأربعة عناصر:
- الدين الإسرائيليّ ومقارنته بالصهيونيَّة كأداة سياسية.
- وعد بلفور وأثره في هجرة اليهود إلى فلسطين وإنشاء الوكالة الصهيونيَّة.
- إسرائيل في العالم الغربي.
- مقومات إسرائيل (الإرهاب، الإعانات، التوسع على حساب العرب) (العمري، 1960، ص: 325 وما بعدها).
والثاني كتاب المجتمع العربيّ بجامعة بيروت العربية، فقد وردت القضية ضمن الباب الرابع للكتاب الذي احتوى على خمسة أبواب. بدأ مؤلف الجزء المتعلق بالقضية الفلسطينية -الدكتور حسن صبحي- بما أسماه جذور المؤامرة «المشكلة الصهيونيَّة»، ثم عرض لمعنى الصهيونيَّة وأصولها الفكرية، ورصد بدايات الهجرة اليهودية وموقف العرب والعثمانيين منها وأثر إخفاقات الثورة العربية على العرب، وملابسات صدور وعد بلفور كمكافأة للصهيونية.
وانتقل الكتاب إلى مرحلة جديدة أسماها تنفيذ المؤامرة أثناء فترة الانتداب، مع إعطاء إضاءات على كفاح شعب فلسطين وثورته. وكانت آخر محطات الكتاب حرب فلسطين والدعم الأمريكيّ للصهيونية، واختتم المؤلف عرضه بذكر جولات الصراع العربية الإسرائيلية مع التأكيد على خطورة أزمة اللاجئين. ويحسب لهذا العرض اعتماده على المصادر الأصلية وإعطاء مساحة واسعة لتطور القضية الفلسطينيَّة في التاريخ الحديث والمعاصر (صبحي، 1968، ص: ص 175، 305).
أما آخر الأمثلة، فكتاب «المجتمع العربيّ»، الذي كان يُدرس بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ووضعه الدكتور محمد ضياء الريس، وجاءت معالجته للقضية في أكثر من فصل، حيث احتلت قرابة 30% من الكتاب، وجاءت عناوين تلك الفصول:
- كارثة فلسطين.
- إسرائيل جريمة الاستعمار.
- خرافة الصهيونيَّة.
- العدوان على الدول العربية.
- موقعة حطين.
ويحسب لهذا الكتاب اشتباكه مع بعض تخرصات الصهيونيَّة، مثل: فكرة أرض الميعاد، التي ناقشها من خلال تقديم سردية تاريخية من التاريخ القديم، تثبت هشاشة تلك الفكرة (الريس، 1969، ص: 183، 193).
ثم جرى تطور لافت في تدريس مقرر المجتمع العربيّ، وذلك في مارس 1973، عندما وضع خمسة أساتذة من جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، مقررًا للمادة، جعلوا عنوانه «المجتمع العربيّ والقضية الفلسطينيَّة»، وقام بوضع الجزء الخاص بالقضية الفلسطينيَّة، الدكتور محمد طه بدويّ أستاذ العلوم السياسية بالإسكندرية، واستحوذ عرض القضية على 23% من الكتاب المقرر.
بدأ المؤلف عرضه بالحديث عن إستراتيجية موقع فلسطين، ثم الادعاءات الصهيونيَّة كسند أيديولوجيّ لعمل استعماري، ثم تناول الكتاب الحركة الصهيونيَّة العالمية في القرن التاسع عشر ودور هرتزل، وعرض للارتباط بين الصهيونيَّة والإمبريالية، وأفرد مساحة للحديث عن وعد بلفور والتقنيع (الإقناع بالقوة الجبرية) القانونيّ لإرادة الأقوى، وأعطى مساحة لمرحلة التوجهات الصهيونيَّة نحو أمريكا. وأخيرًا، ذكر المؤلف الوضع الراهن للقضية الفلسطينيَّة (بدوي، 1977، ص: 333، 407).
ويحسب لهذا الكتاب إيراده للنصوص الدالة والمتعلقة بالصراع العربيّ الإسرائيلي، منها: مذكرة هربرت صموئيل إلى حكومته في فبراير 1915 بشأن مصير فلسطين بعد الحرب، وصك الانتداب البريطانيّ، والرد العربيّ على اللجنة الأمريكية البريطانية للتحقيق في مشاكل اليهود عام 1946.
تأصيل المعرفة
وإذا حاولنا أن نعرض لإيجابيات تجربة تدريس القضية الفلسطينيَّة ضمن مقرر المجتمع العربيّ في فترة الستينيات والسبعينيات، فإنها كثيرة، لعل أبرزها أنها وفرت للطلاب الجامعيين في مصر معرفة جيدة بالقضية الفلسطينيَّة، خصوصًا وأن مخرجات المؤتمر الثاني للمجتمع العربيّ، والدراسات الإنسانية الذي عقد بالإسكندرية عام 1961، شددت على أن يتبع في تدريس مادة المجتمع العربيّ المرونة التي تهيئ للطلاب الفرص لكتابة بحوث في هذه المادة تساعد على إبراز شخصيتهم، كما شددت على أنه لا يجب حصر الطلاب أثناء دراسة مادة المجتمع العربيّ في كتب معينة، وإنما يوجهون إلى مراجع مختلفة. ولقد كانت تلك التوصيات كفيلة -إذا أخذت على محمل الجد- في استزادة الطلاب من موضوعات المجتمع العربي، وفي طليعتها القضية الفلسطينيَّة. (الجرف، 1967، ص: 14).
كما يحسب لهذه التجربة أنها كانت مثالًا سارت جامعات سورية وعراقية وليبية على منواله، وكانت جامعة دمشق هي السَّبَّاقة في هذا المضمار، عندما وضع مجموعة من أساتذتها كتابًا للتدريس في عموم الجامعة تحت عنوان «المجتمع العربي»، حيث جاء ذكر القضية في إطار باب التحديات التي تواجه القومية العربية، أما العنوان الخاص بها فكان «الصهيونيَّة ومشكلة فلسطين»، واحتلت القضية نحو سبع صفحات من الكتاب المكون من 238 صفحة؛ بواقع 3% من حجمه، لكن الصفحات السبع أتت على القضايا الجوهرية في الصراع وهى: معنى الصهيونيَّة، وبداية المشروع الصهيوني، ووعد بلفور، وسياسية الانتداب، والمقاومة العربية، والارتباط بين الصهيونيَّة والاستعمار، والمقاطعة العربية الرسمية والشعبية، والدعم الغربيّ لإسرائيل وقضية التعويضات الألمانية، وقضية اللاجئين، واختيار قضية تحويل مجر نهر الأردن كنموذج للتحديات الإسرائيلية المعاصرة. وختم المؤلفون عرضهم للقضية بالقول: «وفي الحقيقة أن الدول العربية لم تألُ جهدًا في الدفاع عن فلسطين المحتلة بمختلف الطرق والوسائل لأن القضية الفلسطينيَّة لم تعد قضية عرب فلسطين وحدهم، بل هي قضية القومية العربية، قضية العرب جميعًا، وهم ليسوا أمام إسرائيل وحدها بل أمام الدول الاستعمارية الكبرى التي تساعدها وتحافظ على بقائها دولة غازية غاصبة محتلة. ومما لا شك فيه أن الخطر الصهيونيّ عظيم حاضرًا ومستقبلًا، لأن هذا الخطر يهدد الوجود العربيّ بكامله إذا لم تتخذ الحكومات العربية من الوسائل ما يكفل رد العدوان وإرجاع الحق العربيّ السليب إلى أهله، وإذا لم يعِ كل عربي، على أيّ أرض عربية أن هذا التحدي الإسرائيلي/الاستعماريّ يهدده بالفناء والهلاك» (مجموعة مؤلفين، 1965، ص: 136).
إن الشروع في تطبيق تلك المادة في بعض الجامعات العربية، خلق حالة من الجدل الصحيّ حول الآلية التي ينبغي أن يكون عليها هذا المقرر، فقدم الدكتور متعب مناف تصورًا يقوم على أن يكون المقرر فرصة لجمع شتات الفكر العربيّ وصبه في قوة موحدة تستطيع أن تتخطى الحدود والقيود الإقليمية وتسمو فوق ما يسمى بالدوافع الوطنية أو المحلية، ويجب أن يشرع في تدريس هذا المقرر خلال سني الدراسة الثانوية ثم يعطى بشكل أكاديميّ لكل الكليات دون اقتصار على الكليات الأدبية والتربوية والقانونية فقط، وأن يقدم إلى الطلاب في السنوات الأول لكي تعمل مادة المجتمع العربيّ على توجيه فكر الناشئة في الجامعات العربية الوجهة السليمة التي تتفق وأماني العرب (مناف، 1966، ص: 7).
مساقات محدودة
أما بالنسبة إلى السلبيات، فإن كثيرين نظروا إلى الجهود التي شهدتها فترة الستينيات بأنها غير كافية، فظل تدريس القضية الفلسطينيَّة ضمن مساقات المقرر الجديد للمجتمع العربي، ولم يفرد لها مادة مستقلة، وهو الأمر الذي حدا بمنظمة التحرير الفلسطينيَّة في مؤتمرها الأول عام 1964 إلى إعادة التأكيد على تدريس قضية فلسطين في جميع المراحل التعليمية للطلاب العرب، ووجوب جعل قضية فلسطين مادة دراسية في الجامعات والمعاهد العالية في البلاد العربية، وأن تدرج ضمن مواد التخصص (دائرة الدراسات السياسية، 1964، ج2، ص: 288).
وبُعيد حرب حزيران 1967 التأم المؤتمر الثالث لوزراء التربية والتعليم العرب في الكويت، وبحث المجتمعون سبل تدريس القضية الفلسطينيَّة في مختلف المراحل الدراسية في البلدان العربية، وقرر المؤتمر أن تدرس القضية في مختلف المراحل بل وإعطاءها مكان الصدارة (الكتاب السنويّ للقضية الفلسطينية، 1971، ص: 35).
وفي الاجتماع الأول من الدورة الرابعة لمجلس اتحاد الجامعات العربية في جامعة الخرطوم، رفع المجتمعون توصياتهم عن دور الجامعات في المعركة المصيرية، وكانت أولى التوصيات: قيام الجامعات العربية بتدريس القضية الفلسطينيَّة والشرق أوسطية مع توطيد العلاقة بين المراكز القائمة، حاليًّا، داخل الجامعات، وخارجها، والمعنية بهذه البحوث (نوفل، 1989، ص: 5).
وأعيد تأكيد المعنى ذاته في المؤتمر الثالث لوزراء التربية والتعليم العرب بالكويت عام 1968 الندوة العلمية، التي نظمها، حيث أوصى المؤتمر بأن تقرر الدول العربية تدريس القضية الفلسطينيَّة في مختلف مراحل الدراسة، وإعطاءها مكان الصدارة بين مواد التربية الاجتماعية والوطنية لتظل حية في النفوس، وأن تواصل الإدارة الثقافية جهودها واتصالاتها لإنجاز وضع كتاب جامع في القضية الفلسطينيَّة (النمر، 1971، ص: 100).
ورغم أن الأمر مجرد توصية، وجاءت بصورة لا تحدد المساقات التي تدرس فيها القضية الفلسطينيَّة، هل ضمن مقررات أو يفرد لها مقرر خاص، فإن العادة جرت في المؤتمرات العربية، أن إصدار القرارات يعتبر أمرًا سهلًا، ولكن المهم هو تنفيذ هذه القرارات. بل إن القاهرة احتضنت المؤتمر الثاني للجامعات العربية، وأعادوا فيه التأكيد على أهمية دور الجامعات في المعركة المصيرية، وضرورة تدريس مادتيّ المجتمع العربيّ والقضية الفلسطينيَّة في كل الجامعات (المؤتمر العام الثاني، 1973، ص: 490). ولم يتم تطبيق أيٍّ من تلك التوصيات.
كما رأى البعض أن تناول ومعالجة موضوع فلسطين في هذا المقرر اقتصر على علاقتها بالاحتلال الصهيوني، ومن ثم فإن هذا المدى الزمنيّ القصير يعجز عن تقديم تصور حقيقيّ للمشروع الصهيونيّ وحقيقة القضية، إذ لا بد من البحث عن الصهيونيَّة ضمن مدى زمني أطول يتجاوز المتغيرات السريعة التي شهدها القرنان التاسع عشر والعشرون. فقد ارتبط ظهور هذا المشروع، بوقائع وأحداث تراكمت عبر مراحل سابقة، وكانت بمثابة ممهدات ضرورية لإخراجه إلى حيز النظر قبل الانتقال به، إلى التنفيذ (حواش، 2018، ص: 66).
أخيرًا، لا يمكن النظر إلى الكم المعرفيّ الذي كان يُدرس في الجامعات المصرية حول القضية الفلسطينيَّة بأنه سمح بخلق معرفة حقيقية بالقضية، فدراسة عماد الدين سلطان (1971) وأنيس الصايغ (1973)، التي أجريت على عينة من الطلاب الجامعيين، اقتصرت في الأولى على المصريين في حين شملت الثانية، بجانب المصريين، طلابًا لبنانيين أيضًا، أفضت إلى إخفاق تلك المقررات الدراسية عن تحقيق المرجو منها (صايغ، 1973، ص: 77). بل لقد عجز مقرر المجتمع العربي بصفة عامة، رغم أنه كان يستهدف توفير فهم أفضل لمشكلات البلاد الاجتماعية والاقتصادية، عن تقديم تحليل موضوعي لهذه المشكلات (عبد الله، 2007، ص: 212).
ترشيحاتنا