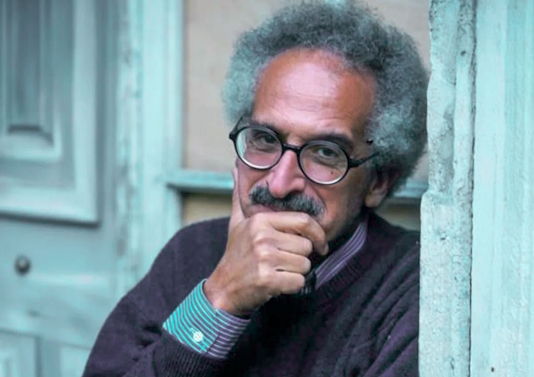أرشيف القضاء
شريف إمامقضية الوصاية على العرش بعد رحيل الملك فاروق - الجزء الثاني
2025.08.23
مصدر الصورة : آخرون
قضية الوصاية على العرش بعد رحيل الملك فاروق - الجزء الثاني
كان من الطبيعي أن تقابل فتوى مجلس الدولة بارتياح من قبل القوى المعادية للوفد كالحزب الوطني والكتلة الوفدية والسعديين ولم يوجد موقف واضح للأحرار الدستوريين، كما أن جماعة الإخوان المسلمين اعتبرت أن ذلك خطوة للقضاء على الدستور فبادرت بالإعلان عن دستور جديد من مقترحها هي يستوحي مبادئه من الشريعة فجاء في بيانهم غداة الفتوى:
"لما كان تصرف الحكام قد أهدر الدستور نصًّا ومعنى، وكان من طبيعة الثورات الناجحة أن تسقط الدساتير التي تحكم الأوضاع السابقة عليها، فإن الدستور المصري يكون قد أصبح لا وجود له من ناحية الواقع لا من ناحية الفقه، مما يقتضي المسارعة إلى عقد جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد على أساس أنه تعبير عن عقيدة الأمة وإرادتها ورغبتها، وسياج لحماية مصالحها، لا على أنه منحة من الملك. وسيترتب على إعادة إصدار الدستور بطبيعة الحال، أن يستمد مبادئه من مبادئ الإسلام الرشيدة في كافة شؤون الحياة. ( [1] )
على كلٍّ لم يعجب هذا الأمر الوفديين وصبوا غضبهم على السنهوري وسليمان حافظ حافظ وفتحي رضوان واعتقدوا أنهم قادة الحركة المضادة الديمقراطية، وأكد إبراهيم فرج أن السنهوري كان يريد أن يصبح الحاكم بأمره في حين علل عبدالفتاح حسن ذلك بكون السنهوري يحكم كونه من السعديين وسليمان حافظ يحكم كونه ينتمي إلى الحزب الوطني، لم ينسوا عداوتهم القديمة للوفد لكن الوفد لم يصرح بذلك وقتها واستمرت حسب بعض الدراسات علاقة الوفد برجال الثورة طوال أغسطس 1952 طبيعية لكن الصحفي أحمد أبوالفتح صرح بموقف الوفد في 7 سبتمبر سنة 1952 في مقالته تحت عنوان: إلى أين. أكد فيها أن الخطأ قد بدأ يوم أن أفتى قسم الرأي بمجلس الدولة فتواه في مجلس الوصاية المؤقتة، وتلاه خطأ آخر يوم أن تمسَّك علي ماهر بهذه الفتوى.
موقف العسكريين
يقول الدكتور عبد العظيم رمضان: "إن الفتوى لم تقنع أحدًا في ذلك حتى في داخل مجلس قيادة الثورة"، وهذا الحكم من قبل الدكتور رمضان يضعه في تناقض مع ما سبق وذكره من تأييد الحزب الوطني والكتلة الوفدية والإخوان لعدم عودة البرلمان الوفدي، أليس هؤلاء أحد داخل المشاهد السياسية ثم نأتي في مسألة مجلس قيادة الثورة الذي قال الدكتور إنه لم تعجبه الفتوى واستند إلى موقف جمال عبد الناصر ومحمد نجيب. فيذكر نجيب في مذكراته: "إنني لم أكن في أعماقي مستريحًا لصحة هذه الفتوى دستوريًّا، وكنت أميل إلى رأي الدكتور وحيد رأفت، ولكني لم أشأ أن أتخذ موقفًا غير ديمقراطي عندما وجدت أغلبية كبيرة أيدت هذا الاتجاه في قسم الرأي مجتمعًا بمجلس الدولة وأن الحكومة أيضًا وافقت عليه، وأغلبية أعضاء مجلس القيادة رحبوا به".
وبذلك أكد نجيب على ترحيب مجلس قيادة الثورة بالفتوى وهو الأمر الذي ينفي ما ادعاه الدكتور رمضان من عدم الاقتناع بها من قبل الثورة، أما موقف نجيب فهو يدعو إلى الدهشة حيث أن الصفحة التالية من مذكراته يؤكد فيها على عدم قناعته بحكم الإعدام الذي صدر على خميس والبقري ثم يؤكد رفضه للوزارة لكونه يرغب في ابتعاد العسكريين عن الحكم ثم أن كل ذلك وغيره يكشف العقلية الدفاعية التي سادت مذكرات نجيب عندما يأتي الحديث عن إخفاقات الثوار أو بعض الأمور المختلفة فيها، ثم إن فتوى مجلس الدولة ليست ملزمة للسطة التنفيذية أن تأخذ بها وهذا حق دستوري للسلطة التنفيذية أن تأخذ بالفتوى أولًا فهي ليست حكمًا قضائيًّا. ومن ثم فإن رفض نجيب الباطني لا يهم كثيرًا في تبرير موقفه ما دام المجلس الثوري أقر الفتوى وهو على رأسه.
موقف جمال عبد الناصر: ما ذكره خالد محيي الدين هو أن عبد الناصر لوَّح بالاستقالة ومن ثم فإن مواقف عبد الناصر في عهد الثورة الأولى تدعو إلى كثير من التكامل حيث كان يميل إلى الديمقراطية الحزبية والحياة النيابية، الأمر الذي جعل عبداللطيف البغدادي يقول: لا أدري هل كان عبد الناصر جادًّا في مواقفه وقتئذ أو أنها كانت مناورة. الأمر الذي جعل السادات يؤكد أن عبد الناصر كان أولهم كفرًا بالديمقراطية نتيجة لما صنعته بنا وبالبلاد ديمقراطية الأحزاب وصراعاتها من أجل السلطة وخضوعها للملك والإنجليز.
لقد كان مما يجاوز النظرة الواقعية أن يتبني الضابط نمطًا دستوريًّا للحكم يجردهم من السيطرة على مكمن القوة أو أن يقيموا نظامًا يعتمد في قوته الدافعة على الحركة الحزبية. لعل ممارسات ناصر فيما بعد 1954 وانفراده بالسلطة تكشف عن عزوفه عن النمط الديمقراطي وضرب عرض الحائط بالدستور الذي أفزرته لجنة الخمسين واستمراره طوال عهده على نمط الإعلان الدستوري.
كما أن الحياة النيابية ظلت معطلة حتى سنة 1957 وعندما عادت جعل من شروط الترشح للعضوية أن يكون المترشح أحد أبناء الاتحاد القومي أو الاتحاد الاشتراكي فيما بعد، فعبد الناصر سعى طوال حكمه إلى دمج السلطات وبخاصة السلطتان التشريعية والتنفيذية، ودمج الوظيفة السياسية والإدارية، أي قيام جهاز الدولة بوظيفة الحزب، والقيادة الفردية التي ترتبط بها الزعامة بالرئاسة، فعبد الناصر كان انتقائيًّا ينتقي من الصيغ المختلفة ما يصوغ به الصيغة الملائمة لموقفه وأهدافه.
الانتقادات التي وجهت إلى فتوي مجلس الدولة:
بعد صدور الفتوى صدر الأمر الملكي بتعديل الأمر الملكي الصادر في 13 إبريل سنة 1922 بوضع نظام التوارث على عرش المملكة المصرية "مادة 10 مكرر: في حالة نزول الملك عن العرش وانتقال ولاية الملك إلى خلف قاصر يجوز لمجلس الوزراء إذا كان مجلس النواب منحلًّا أن يؤلف هيئة وصاية مؤقتة للعرش من ثلاثة يختارهم من بين الطبقات المنصوص عليها في المادة 10. وتتولى هيئة الوصاية المؤقتة بعد حلف اليمين أمام مجلس الوزراء سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة وفقًا لأحكام المواد الثلاث السابقة ولأحكام المادة 51 من الدستور".
أولًا: تعاملت الفتوى بازدواجية مع الدستور حيث عمت المادة 55 والخاصة بحالة الوفاة على حالة التنازل عن العرش والخاصة بأحقية مجلس الوزراء في ممارسات سلطات الملك الدستورية إلى أن يتولاها الخلف أو أوصياء العرش وكان من المنطقي أن تعمم المادة 52، 54 والخاصة بعودة البرلمان المنحل على حالتي الوفاة والتنازل عن العرش.
ثانيًا: ابتدعت الفتوى نظام الوصاية المؤقتة للعرش هروبًا من الوصاية الدائمة، وجعل تعيين هيئة الوصاية المؤقتة من اختصاص مجلس الوزراء، بينما يختار مجلسا البرلمان هيئة الوصاية الدائمة ويثبتانها في الحكم وجعل حلف يمين الأوصياء المؤقتين أمام مجلس الوزراء بينما يؤدي الأوصياء الدائمون تلك اليمين الدستورية أمام مجلسي البرلمان مجتمعين حسب نص المادة 52 من دستور سنة 1923.
ثالثًا: الفتوى قدمت رأيًا في أمر لم يطلب منها إبداء الرأي فيه وهو الانتخابات فموضوعها كان من الأساس هو الوصاية، فقررت إجراء الانتخابات لمجرد التمكن من إجرائها، لكنها عادت ونقضت ذلك بقولها إن الضرورة تقضي أن يكون ذلك بمضي وقت غير قصير.
رابعًا: الفتوى تستند منذ البداية إلى صحيح من منطقي لفظي عام مثل التعارض مع طبائع الأشياء والساقط لا يعود دون نظر إلى أن طبائع الأشياء هنا يحددها الدستور، وأن إهدار إرادة الشعب بحل مجلس النواب وعدم الدعوة إلى انتخاب مجلس جديد هو الذي يخالف طبائع الأشياء وأن المطلب هو إعادة الساقط الذي كان سقوطه إهدارًا لطبائع الأشياء.
خامسًا: الفتوى تعتبر أن أصول الدستور المصري صريحة في أن مجلس النواب المنحل لا يعود إلى العمل، دون أن تعتبر أن هذه الأصول نفسها توجب ألا تظل البلاد بدون مجلس نواب قائم أو بدون استعداد لإقامة مجلس نواب عوض الذي انتهت مدته أو صار حله.
مبررات موقف وحيد رأفت:
الثابت أن وحيد رأفت خالف السنهوري ووقف من هذه الفتوى موقف المعارض ويمكن أن نرد هذا الموقف من جانب وحيد رأفت إلى وضعه الطبقي وموقعه الفكري وانتمائه الحزبي فوحيد رأفت من أبناء الباشوات وكان رجلًا محافظًا، وهو إن كان يحب لبلده التقدم والتطور فإن الطريق الذي يفضله لتحقيق ذلك كان مختلفًا عن طريق السنهوري، أن المؤسسات القديمة في رأيه مؤهلة لأن تقوم بتغير المجتمع دون حاجة إلى العنف أو الثورة، ومن هنا كان موقفه من عودة البرلمان الوفدي المنحل، كذلك مواقف وحيد رأفت الفكرية انعكاس أمين لوضعه الطبقي لقد انتهى وحيد رأفت إلى أن المحاكم في مصر لا تمتلك الرقابة على دستورية القوانين.
في حين أيَّد السنهوري هذه الرقابة وتحمس لها فأخذ يقدم الدليل تلو الدليل في أحكامه عن ضرورة رقابة السلطة القضائية لدستورية القوانين كذلك فإن وحيد رأفت كان يدافع عن النظام الملكي بعد طرد الملك فاروق سنة 1952 لاعتقاده بأن النظام الملكي عمومًا أفضل من النظام الجمهوري ولم يكتفِ عند تأييد هذا النظام بعد ذلك، كذلك فإن وحيد رأفت كان من أبناء حزب الوفد ووقف مدافعًا عن الوفد أثناء عرض قضايا الأحزاب على محكمة القضاء الإداري لكن ما يحسب له أنه لم يكن متعصبًا للوفد حيث عارض موقف الوفديين من قانون مجلس الدولة سنة 1941 وانتقدهم بشده.
موقف السنهوري، مبرراته ودلائله:
فتح كثير ممن لم يعجبهم فتوى مجلس الدولة النار على رئيس المجلس الدكتور عبدالرزاق السنهوري ووكيل المجلس سليمان حافظ ورأى البعض أنه مارس تأثيرًا على الجمعية العمومية لقسم الرأي لاستصدار تلك الفتوى ورأى البعض أن السنهوري كان تزري قوانين في حين عزى البعض موقف السنهوري وحافظ إلى عدم ثقتهم بأن الحكم الدستوري الديمقراطي القائم على تعدد الأحزاب قادر على أن يحقق أحلام الوطن، فضلًا عن كراهيتهم للوفد وزعيمه ليس فقط لأنهم كانوا من الذين خرجوا من عباءته وتحالفوا مع خصومه ولكن كذلك لأنه كان الحزب التقليدي الكبير الذي لا يزال يحتفظ فوق هامته بغار ثورة سنة 1919 ويستغل جماهيريته للترويج للأفكار الليبرالية وللاحتفاظ الدولة المصرية بشكلها الدستوري العلماني وأنه هو القادر على إثارة القلاقل كلما أراد أحد أن ينقلب على الدستور، وفي الأخير فإن البعض يحمل السنهوري وحافظ تهمة تحول مسار الثورة عن المسار الديمقراطي، ويمكن أن يعزى موقف السنهوري إلى عدة عوامل:
أولًا: العلاقة المتوترة بين مجلس الدولة والسنهوري من جهة وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية قبل قيام حركة 23 يوليو وبالتحديد وزارة الوفد الأخيرة من جهة أخرى.
فما إن جاءت حكومة الوفد حتى طالبت السنهوري بالتنحي عن رئاسة مجلس الدولة بدعوى أنه كان ينتمي إلى أحد الأحزاب السياسية، فلما اجتمعت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة وشجبت هذا الطلب خرج أحد وزراء الحكومة الوفدية لينشر في الصحف أحاديث تمس شخص رئيس المجلس، كما ظل معطلًا ما طلبه المجلس من استصدار لائحته الداخلية وتدبير مبنى له وزيادة عدد مستشاريه كما أن برلمان الوفد هو الذي أقر قانون رقم 6 لسنة 1952 الذي جعل لوزير العدل الإشراف على المجلس ومستشاريه الأمر الذي جعل مستشاري المجلس بالكلية يهددون بالامتناع عن العمل والاستقالة الجماعية، وعلينا أن نؤكد أن هذا الموقف الوفدي من المجلس لم يكن وليد وجود السنهوري على رئاسة، ولكن منذ أن كان المشرع حلمًا وفكرة حيث هاجمت مشروع عبدالحميد بدوي سنة 1941 لإنشاء مجلس الدولة واعتبرت صحيفة المصري الوفدية أن ذلك المشروع تسميم للإباء ودولة داخل دولة.
ثانيًا : ميول السنهوري الاشتراكية حيث كان يؤمن بأن المؤسسات القديمة بصورتها التي عليها هي سبب الفساد وقد عبر عن رغبته في إنشاء حزب للعمال والفلاحين أكثر من مرة، وكان السنهوري وحافظ قد رأيا أن الأفضل هو إجراء انتخابات لكنهما عدلا عن تلك الفكرة لكون إجراء انتخابات نزيهة تحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات مما يكفل سلامة العملية الانتخابية، ومن ثم فإن القائلين بأن كان على السنهوري دعوة البرلمان المنحل ليقسم للأوصياء أمامه ثم سيحله تجعله مضطرًّا لأن يحدد الانتخابات في غضون شهرين كما ينص الدستور وهو ما لم تكن البلاد في اعتقاده مستعدة له.
ثالثًا: لم يكن موقف السنهوري من نازع شخصي رغم أن الوفد طارد السنهوري كثيرًا، فقد أحالته حكومة الوفد سنة 1942 إلى المعاش وكان وكيل وزارة المعارف وطاردته سنة 1936 عندما كان في العراق ثم سنة 1943 وهددت العراق بقطع العلاقات إن لم تطرد السنهوري ثم حاربت رئاسته لمجلس الدولة سنة 1950 ومع ذلك فإن الأحكام التي أصدرها السنهوري من قضايا الحقوق والحريات التي تخص بعض كبار الوفديين تشهد لهذا الرجل بأن العدالة تسري فى دمه وعروقه، منها وقف تنفيذ قرار المحاكم العسكرية باعتقال فؤاد سراج الدين بعزبته في بلبيس، كما أنه أوقف قرار الرقيب العام بمنع نشر بيان الوزير الوفدي عبدالفتاح حسن في جريدة المصري تصحيحًا لما ورد في تقرير النائب العام الخاص به، كذلك أفتى قسم الرأي لمجلس الدولة في 30 مارس 1952 عندما دخلت وزارة، أن يشتمل قرار الحل على ميعاد للانتخاب لا يجاوز شهرين، الأمر الذي جعل الملك يفكر مجددًا في الإطاحة بمجلس الدولة.
رابعًا: كذلك عندما تعدت الفتوى مجالها إلى الانتخابات كانت تريد أن تلزم الثوار بالعودة بالبلاد إلى الحكم الذي يقتضيه الدستور، وكان السنهوري وحافظ قد أوضحا لعلي ماهر أن ستة أشهر كفيلة بإجراء انتخابات نزيهة تمثل كل الشعب المصري وهو ما خرج به بيان الثوار في 11 اغسطس سنة 1952.
خامسًا: أن الناظر إلى البرلمان الوفدي الأخير يبد أنه على الرغم من هذا البرلمان قد إلغاء معاهدة سنة 1936 إلا أنه تصدى لكل الجهود الفردية التي حاولت أن تمس ولو مسًّا طفيفًا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القائمة في مجال الزراعة في أي بعد من أبعادها، كذلك يظهر ضعف هذا البرلمان في أداء وظيفته الرقابية سواء من خلال التركيز في أداة السؤال فقط أو من خلال تركيز هذه الأداة في قضايا الخدمات، كذلك ضعف مبادرة البرلمان بالعمل التشريعي كما يظهر من الثقل النسبي الكبير لمشروعات القوانين المقدمة من الوزارة وعدم مساس هذا النشاط التشريعي بصفة أساسية بالقضايا الجوهرية كما أنه برلمان قتل الحريات، فهو الذي أصدر قانون الجمعيات وقانون مجلس الدولة وقانون المشتبه فيهم وقانون حظر نشر الأسرة المالكة ونحوها من القوانين.
سادسًا: كذلك تردي سمعة الوفد في وزارته الأخيرة حيث استفتحها النحاس بتقبيل يد الملك وأعلن الطاعة الكاملة والولاء التام وإنهاء صراع الماضي وهو الأمر الذي جعل الإنجليز يتحدثون عن الفساد السياسي للوفد وتوقع السفير سفينسون أن مصر جديدة ستولد خلال عامين من تولي النحاس لوزارته كما أن النحاس نفسه هدد بحل البرلمان إذا لم يمرر قانونًا يقيد الصحافة لولا نصيحة بعض وزرائه، ومن ثم كانت مهمة الوفد في تلك الأثناء قد شهدت تدنيًا ملحوظًا كان من المعقول أن يعتبرها كثيرون جزءًا من النظام الفاسد وأحد دعائمه.
سابعًا: من الخطأ القول إن الدكتور وحيد رأفت استقال بعد إقرار تلك الفتوى فالثابت على لسان الدكتور رأفت أنه استقال نظرًا إلى إنشاء دائرة خامسة لمحكمة القضاء الإداري، وكان يرغب في أن يعين فيها ولكن ذلك لم يحدث فقدم استقالته في 12 أغسطس سنة 1952 وليس لأن الفتوى لم تعجبه.
ثامنًا: من العبث الحديث على أن السنهوري مارس تأثيرًا على رجال المجلس، ففي هذا اتهام لرجال المجلس وهم من المستشارين الأفذاذ الذين وقفوا أمام جنوح السلطة التنفيذية للاستبداد.
أخيرًا: فإن الدكتور السنهوري شأنه شأن كل مصري حر، كان يري فساد الأوضاع التي تعيشها مصر قبل الثورة وعندما قامت الثورة وناصرت مجلس الدولة ورفعت الظلم الذي وقع عليه في عهد الوفد وألغت قانون 6 لسنة 1952 وبدأت تشرع في تبني مشروعًا إصلاحيًّا ناصرها بكل ما يملك.
وشرع يضغط على رجالها بعد تلك الفتوى في تحديد موعد انتخابات عامة وقد كان ما أراد ثم شرع يطالب بلجنة لوضع الدستور فتم تشكيل لجنة الخمسين التي كان أحد أعمدتها واشترك في المفاوضات مع السودانيين، وعندما اندلعت أزمة مارس كان مع الصف المطالب بعودة الحياة الدستورية وكانت هتافات الجماهير التي انطلقت لتعتدي عليه في 29 مارس سنة 1954: لا أحزاب لا برلمان تسقط الديمقراطية. فقد كان مع صف الديمقراطية بمعناها الحقيقي. ومن ثم فإن الفتوى كانت بوحي من السنهوري ذاته لا خضوعًا لأحد انتهى -هو وزملاؤه– إلى ما انتهى إليه ظنًّا منه بأن ضرورات المستقبل والمصلحة العامة أساسًا، تملي عليه اتخاذ هذا الموقف إزاء عودة مجلس النواب الوفدي المنحل إلى الحياة، ولم يكن هو الذي حول الثورة عن المسار الديمقراطي وإنما هو الذي أراد عدم عودة أهم مكونات مشهد الفساد السياسي الذي قامت الثورة للقضاء عليه وتمهيد الجو لحياة نقيه تقوم على دستور نظيف وبرلمان قوي مستقل.
[1] - الأهرام 2 أغسطس سنة 1952.
ترشيحاتنا